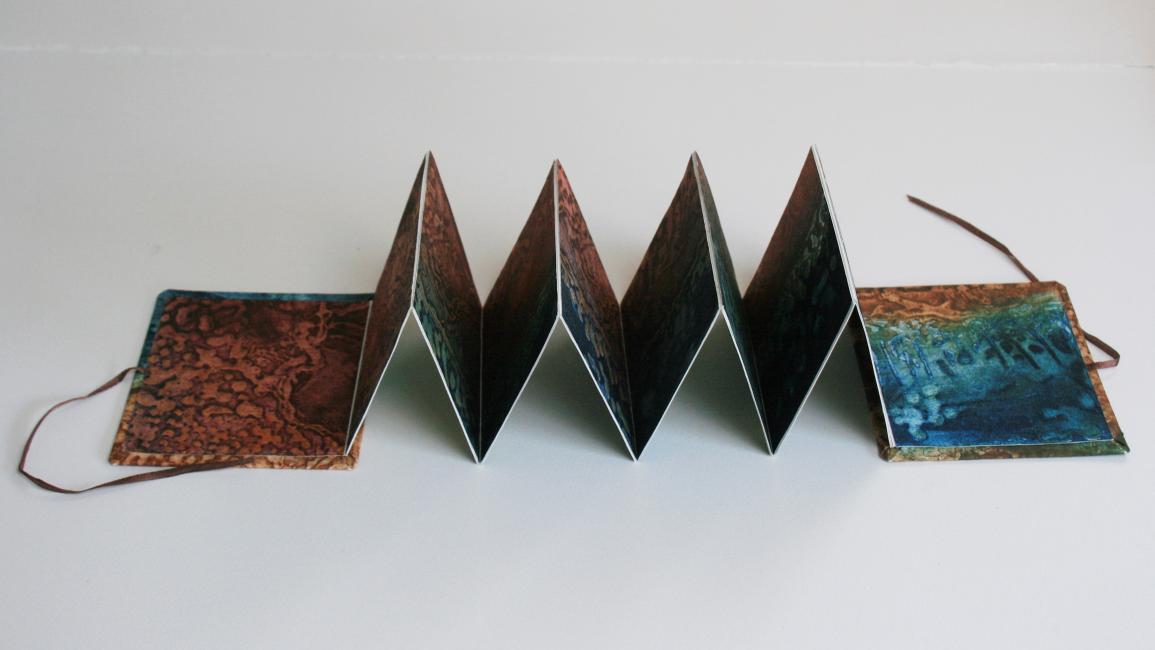محن الانتقال
(بيغ موريس)
كلّما دفعتني الظروف إلى الانتقال من مكان إلى آخر، فكّرتُ أن أبي قد مات في غيابي، وأني لم أبكه كما يجب ولم أدفنه، وأني، لهذا السبب ربما، أبقى أراه في مناماتي حيّا، مصابا بوعكةٍ صحيةٍ صغيرةٍ يكفي قرصا إسبرين أو بنادول لإذهابها عنه. كلّما اضطررت للسفر والانتقال، أحسستُ لسببٍ ما، غامض وغريب، أن ثمة رابطا بين الحدثين، وأني لو لم أسافر، لما ذهب أبي بتلك البساطة، فقط لأن بيتنا فرغ من ساكنيه ساعات، فلم يوجد أحد لإسعافه وإنقاذه. لا أستطيع القول إني تنقّلتُ في حياتي كثيرا، لكنّ كلّ انتقال كان بمثابة هزّةٍ أرضيةٍ بقيتُ من بعدها، سنوات، ألملم ما تخرّب وما وقع فيّ من فوضى. أنتقل إلى المكان الجديد وأبقى جالسة على طرف السَّرير، سنوات، متأهبّة للقيام والمضيّ لا أدري إلى أين، إنما غير مهيّأة للتمدّد والارتخاء. لا أدري كيف يتمكّن آخرون من التأقلم بسرعة، كيف يُقبلون على الرحيل معلّلين النفس أنهم عشية خوض مغامرةٍ، مردّدين أن التغيير أمر إيجابي "وفاتحة خير"، وأن "الحركة بركة"، إلى ما هنالك من صور وعبارات تشجّع على السفر والترحال.
وللتحايل على غربتي، صرت أدخل البيوت الجديدة وكأني سأقيم فيها إلى الأبد، أفرشها وأهيّئها وأمضي في سكناها لأنها قد تكون مأواي الأخير. هنا قد أشيخ وأموت وأستلقي على فراشي آمنة مطمئنّة، قبل أن أغمض جفنيّ وأودّع الحياة. هذي هي الميتة الأنسب كما أراها، أن ننطفئ في منازلنا، محاطين بأشيائنا وذكرياتنا، شاعرين بالألفة والأمان، كأنما قرّرنا بملء إرادتنا ساعة إطفاء الجهاز، أو ميعاد الانتقال إلى عالم آخر، أو لحظة التوقّف عن البثّ. كأنما، أجل، لأنه زعم وادّعاء ولعبة نلعبها لأنها أشبه بمخدّرٍ لذيذٍ يُبعد عنّا الخوف ويخفّف الحزن.
لكنّي، وفيما أنا أصنع الديكور الجنائزي من حولي، أكون مدركةً، في عمقي، أن شيئا من هذا لن يستمرّ، وأن مأساتي ومأساة كثيرين من أمثالي تكمن ربما في أنهم لا يعرفون أين سيموتون. لا أحد يعرف متى سيموت، صحيح، إلا أنّ معظمنا يعرف على الأقل أين. هو يعرف، في حدّ أدنى، الرقعة الجغرافية، المنطقة، البلاد. أما نحن الذين خرجنا ولن نعود قريبا، لا نعرف. ألا نتمكّن من تصوّر مكان موتنا، وإن لم يجر في الواقع مثل ما نظنّ أنه سيكون، يجعل الموت الصعب أصلا أكثر صعوبة علينا، ويسمّم الحياة. مقدرة المرء على تخيّل موته، ممهورا بكل التفاصيل الخاصة بالمكان والديكور، يساعده ولا ريب على تقبّله واستيعابه، خصوصا أنه ينزع بعضا من فتيل صدمة المفاجأة عنه.
أدخلُ البيوت وأستغرق في بناء تفاصيلها، أقنعها وأقنع ذاتي أني صافية النيّة، وقد عقدت قراني عليها طوال العمر، أن بإمكانها أن تركن إليّ وتثق بي، وأني لن أخون أو أهجر أو أختفي من دون سابق إنذار. ولتعزيز الثقة بالبراهين، تراني لا أكتفي بامتلاك الأساسيّ فقط، وإنما أُكثِرُ من عناصر الزينة ومن اقتناء أصص النبات أوزّعها في الزوايا وعلى الشرفات، مصرّحة علانية ومن دون مواربة أنَّ من لا يقتني نباتاً، إنما يقوم بتنبيه منزله باكرا إلى حتمية رحيله. وإذ يحين موعد الرحيل، أشعر بالغصّة وأنا أترك النباتات لمصيرها، كأني بإتياني بها قد حكمتُ عليها بالإعدام لذنب لم تقترفه. أفكّر بمواتها البطيء في غيابي، في عطشها، ثم ذبولها، ثم اصفرارها وتيبّسها، في مكان خاوٍ لا أصوات ولا أطياف فيه. أفكّر بأبي وفي وفاته في غيابي، وفي أحلامي التي لا تني تردّه إليّ حيّا، لا يشكو سوى وجع بسيط في الرأس أنهيه بابتسامة وبقرصي أسبرين.