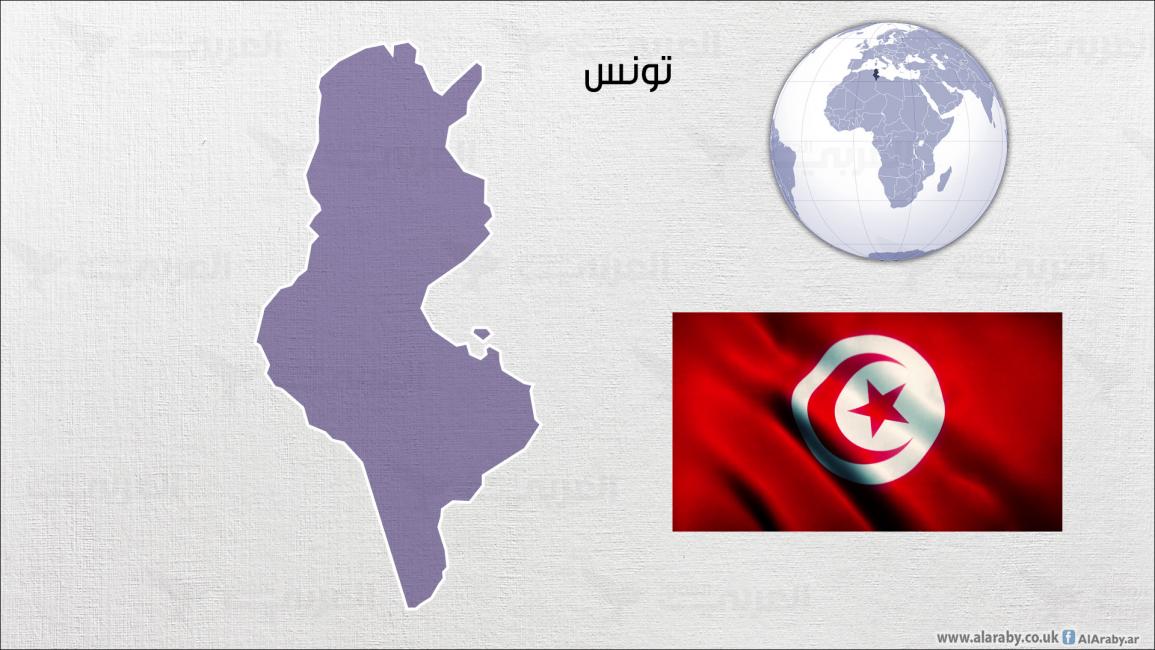عندما يخوض جنرالات تونسيون جدلاً سياسياً
لم يتعوّد التونسيون على الاستماع لقادة جيشهم وهم يتكلمون في مختلف المواقف السياسية والهزّات الاجتماعية الكبرى التي شهدتها البلاد منذ استقلالها. المرّات الوحيدة والنادرة تكلم فيها هؤلاء كانت رصاصا، حين واجه الجيش مجموعاتٍ من التونسيين، مناوئة للنظام، على غرار أحداث قفصة 1981 وأحداث الخبز أيضا سنة 1984. لا أحد حفظ أسماء هؤلاء، ولا شاهدهم، ولا اطلع حتى على مجرّد صورهم. بل إن وزراء الدفاع، وهم مدنيون بالضرورة، ظلوا منذ الاستقلال لا يصرّحون مطلقا، فكأن خرسا أصابهم ولا شفاء منه. كانت تلك أعرافا ومواثيق "نشأ" عليها الجيش التونسي، وربما كان ذلك تحت تأثير تكوين النخب السياسية التي بنت دولة الاستقلال. كانت الثقافة الفرنسية آنذاك قد أطلقت على الجيش الفرنسي اسم "الخرساء العظيمة"، وجرى ذلك في عهد الجمهورية الثالثة، أواسط القرن التاسع عشر، حين تم حرمان منتسبي الجيش من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 1848، وتوسيع قاعدة التحفظ والسر المهنيين، حفاظا على حياد المؤسسة العسكرية. وظل الأمر جاريا حتى مجيء الجنرال ديغول الذي منح حق التصويت لمنتسبي الجيش سنة 1945، أي بعد ما يناهز قرنا.
سعت النخب السياسية التونسية التي أسّست دعائم دولة الاستقلال إلى تجنّب إدراج الجيش في الشأن السياسي، وكان ذلك استثناءً في محيط عربي. كانت الزعامات السياسية آنذاك تتسابق على ولاء الجيوش لها، من أجل تثبيت الحكم أو الانقلاب على الأنظمة. جل مشروعية أنظمة ستينيات القرن الفارط كانت تمرّ عبر مباركة الجيش وولائه لها، بل إن بعض قادة الدول العربية كانوا من منتسبي الجيش من ساميي الضباط ومتوسطيهم. وما زالت غواية الجيش وجاذبيته تراود عديدين من معتنقي التيار القومي. ثمّة حنين إلى بسمارك عربي، ولو على جثة الحرية.
لم يجرؤ رئيس الأركان، رشيد بن عمار، إبّان الثورة التونسية، مطلقاً على إلقاء بيان باسم المؤسسة العسكرية
كان الجيش التونسي استثناء في محيطٍ تعسكرت قياداته وثقافته السياسية، غير أن محاولة الانقلاب التي قادها ضباط الجيش التونسي ذوو التوجهات العروبية سنة 1963 (موال للزعيم الراحل صالح بن يوسف) كانت كافيةً لإبعاد الجيش وبشكل راديكالي عن السياسة. وتورد مذكرات عديدة عن تلك المرحلة أن الرئيس الحبيب بورقيبة رحمه الله كان مجافيا هذه المؤسسة، محاولا قدر الإمكان "تمدينها"، حيث أوكل لها عدة مهام اقتصادية واجتماعية: استصلاح أراض، تكوين مهني للشباب، بناء منشآت عمومية .. إلخ. كان ذلك أحيانا على حساب إمكاناته وقدراته العسكرية، نتيجة ضعف التسلح، على الرغم من التكوين الجيد الذي ما زال يحظى به منتسبو هذه المؤسّسة.
وظلّ الأمر على حاله، وجرى عرفا راسخا خلال أكثر من نحو سبعة عقود إلى أن حدثت الثورة أو اخر سنة 2010. بقطع النظر عن فرضياتٍ عديدة تقدم تفسيرات متعدّدة إلى حد التناقض لموقف الجيش التونسي مما حدث ودوافعه، (.. وحياد أو تعاطف مع المحتجين .. إلخ)، ما لا شك فيه أن علاقة ما بدأت تنسج بين الجيش وفئات واسعة من الشعب. لقد اقترب التونسيون من هذه المؤسسة ورموا على عساكرها ورودا وعلقوا عليها آمالا.
كان قائد الأركان الجيش آنذاك، الجنرال رشيد عمّار، يلقي تصريحاتٍ بين حين وآخر، ولكنه لم يجرؤ مطلقا على إلقاء بيان باسم المؤسسة العسكرية، مكتفيا بالحضور في برامج إعلامية، على الرغم من محدوديتها. بل ذهب الرجل إلى المحتجين في القصبة (حيث مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس) الذين تمسكوا برحيل حكومة محمد الغنوشي آنذاك، ليعبر لهم عن احترامه إرادتهم، وأن الجيش لن يقف ضدهم، ملمحا إلى أن الجيش "وجد السلطة ملقاة على قارعة الطريق، ولكنه لم يلتقطها، بل أعادها إلى المعنيين بها". كانت هذه التصريحات قد رفعت من مكانة الرجل، وتم التمديد له، وهو الذي تجاوز سن التقاعد، غير أن استقالته سنة 2013 ما زالت تطرح أسئلة عديدة.
المواقف الصادرة أخيرا عن قيادات عليا سابقة في الجيش، وهم متقاعدون حاليا، تأتي بعد تصريحات رئيس الجمهورية مرّات عديدة عبر فيها عن ضيقه بالنخب السياسية
تمت دسترة منزلة الجيش التونسي في دستور 2014 بما ورد في الفصل 18 "الجيش الوطني جيش جمهوري، وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظّمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو مُلزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية، وفق ما يضبطه القانون". وعلى الرغم من إعطاء منتسبي هذه المؤسسة حق الانتخاب الذي قد أثار جدلا كبيرا، وعارضه جل من وقّع على الوثيقة التي صدرت قبل أيام قليلة، ومن أبرزهم محمد المؤدب ومختار بن نصر وبوبكر بن كريم وغيرهم، فإن كبار الضباط الذين لا يعرف غالبية التونسيين، وحتى النخب، أسماءهم ولا مساراتهم المهنية، إلا القليل، قد أعادوا الجدل بشأن السياقات والتداعيات والمخاطر. وكان البيان/ العريضة المفتوحة لتوقيع المدنيين رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، فيها تعبير عن انشغالٍ بالغ بما آلت إليه الأوضاع السياسية عموما، ودعوة ملحّة إلى رئاسة الجمهورية إلى تبنّي مبادرة تعيد الوحدة الوطنية وقوة الدولة مع تحميل الرئيس، ضمنيا وأدبيا، بعض المسؤولية، وقد أثارت جدلا غير مسبوق.
لنتذكّر أن تلك العريضة قد وردت، بعد أقل من 72 ساعة من إعلان بيان أصدره أيضا الجنرال كمال العكروت، وهو أميرال البحرية المتقاعد أيضا، والذي اشتغل مستشارا عسكريا لدى الرئيس الأسبق، الباجي قائد السبسي، وتقول مصادر إن الرئيس المنصف المرزوقي قد أنهى مهامه، نظرا إلى شكوك راودته. وسيكون من المهم أيضا أن نستحضر أن المواقف الصادرة أخيرا عن قيادات عليا سابقة في الجيش، وهم متقاعدون حاليا، ولم يتعوّد عليها التونسيون، تأتي أيضا بعد تصريحات رئيس الجمهورية مرّات عديدة في الثكنات أمام قيادات عليا، وحتى أمام ضباط صغار، عبر فيها عن ضيقه بالنخب السياسية، بل ذهب إلى التحرّش بالطبقة السياسية عامة، وحملها في مناسبات عديدة كل كوارث الدنيا جمعاء، وهي تصريحاتٌ غير مسبوقة. من دون أن ننسى الوثيقة المسرّبة أخيرا، والتي تدعو إلى البدء في ترتيبات من أجل انقلاب دستوري، يعدّه الرئيس قيس سعيد، ما اضطرّه لاحقا إلى إجراء حوار مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة، بثته التلفزة التونسية، ينفي فيه هذه المزاعم.
الخطير في ما صدر عن هؤلاء هو إدراج المؤسسة العسكرية، ولو من بعيد، في جدل، فالموقعون الستة على البيان استعملوا صفاتهم العسكرية السابقة
وفي كل الحالات، الأرجح أن هذه المبادرات ستعد خطيرة، لا بالمعنى الأمني أو العسكري، فهؤلاء لا وزن لهم، بل دخلوا سرداب النسيان بالمعنى الثقافي الذي نشأت عليه المؤسسة العسكرية التونسية، فما أن يُحال أحدهم على التقاعد، حتى تنتهي حياته "العسكرية"، ويبدأ حياة مدنية جديدة، لها نواميسها ومعاييرها. كبار القادة في الجيش التونسي لا وزن لهم خارج ما تمنحهم لهم رتبهم، وهم يباشرون مهامهم. ولا أثر لهم بالمعنى الأيديولوجي أو السياسي أو الشللي، أو حتى الاختصاصي، على خلاف جيوش عربية عديدة، حيث لا يتم الاكتفاء بالتراتبية العسكرية لتعزيز مواقعهم ومواقفهم، بل يتم حشد موارد أخرى، على غرار الولاءات والقرابة الدموية والمصاهرة مع القيادات السياسية، وأحيانا التحالف مع لوبيات المصالح الاقتصادية، وحتى الولاءات الإقليمية والدولية.
الخطير في ما صدر عن هؤلاء هو إدراج المؤسسة العسكرية، ولو من بعيد، في جدل، فالموقعون الستة على البيان استعملوا صفاتهم العسكرية السابقة. أما الأخطر فهو ما بدا أن كبار العسكريين القدامى قد توزّعوا على مخيمين سياسيين متنافرين، فإذا كان بيان الأميرال العكروت مناهضةً صريحةً للتحالف الحاكم ومحاسبة عسيرة له، وتحميل الفاعلين فيه المسؤولية، في ما يشبه الوعيد المنسوج في مخمل شعر أبي القاسم الشابي، فإن عريضة السداسي العسكري قد بدت ضمنية، منتصرة للتحالف الحكومي، مستاءة من أداء رئيس الجمهورية، ولو كانت صياغة هذا الموقف بريش النعام لطفا ومجاملة.
البيان رقم واحد، سواء كان حلما لبعضهم أو كابوسا لآخرين، لن يُتلى، ولكن ربما بدأنا خطواتٍ خاطئةً في تسييس تدريجي لمؤسسةٍ طالما تباهينا بحيادها.