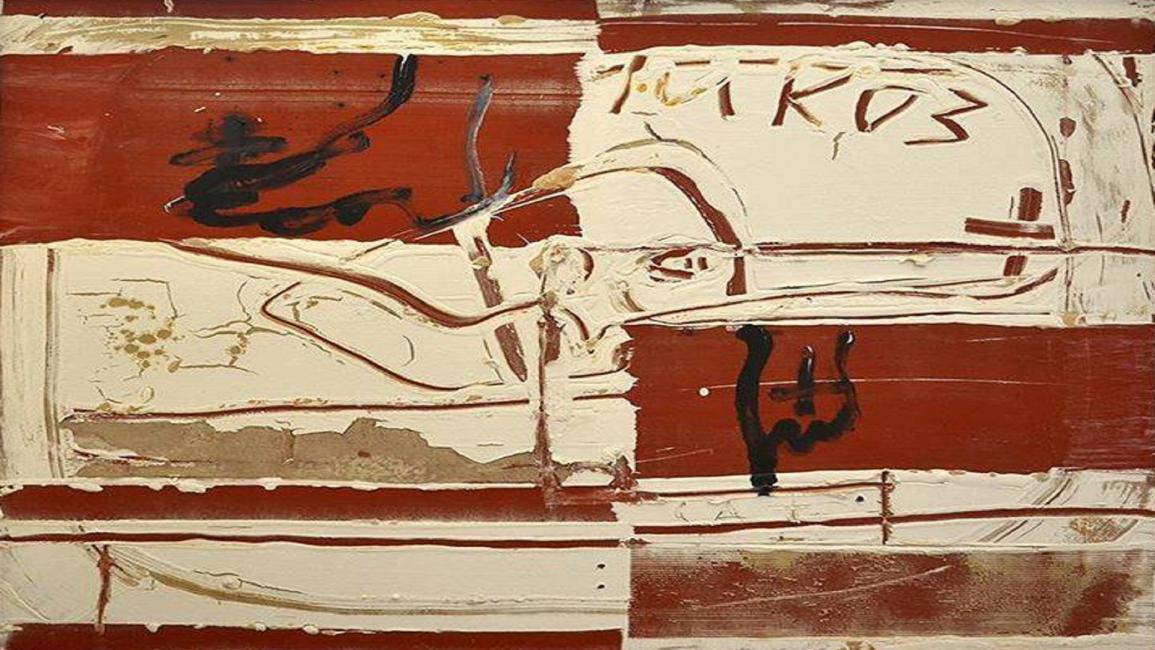الحبّ في "زمن الزلزال"
(أنطوني تابييس)
في الوقت الأثمن والأغلى، الذي كان يمكن أن يُنقذ أرواحاً كثيرة بنشلها من تحت الأنقاض، كانت السياسة البازار الوحيد الذي يعمل بأقصى طاقاته، مستغلاً الكارثة وضارباً عرض الحائط بأرواح الضحايا، والمشرّدين الذين دفعهم الزلزال إلى العراء، كي يفرض شروط التفاوض مستقبلًا والاعتراف والبقاء في الحكم من طرف، أو يحظى بفرصٍ أوفر في انتخابات مستقبلية، والبقاء في الحكم أيضاً، من طرفٍ آخر، بينما مع كلّ دقيقة تمرّ، كانت روحٌ تصعد إلى السماء، ربما كان بالإمكان إنقاذها وإرجاع الحياة إليها.
لم تُفتح المعابر في الشمال السوري إلّا في اليوم الرابع، لتدخل شاحناتٌ كانت مدرجةً في البرنامج الإغاثي المتفق عليه قبل الزلزال، لا علاقة لها باحتياجات الكارثة، لكن للحق يُقال إنّها فُتحت أمام جثامين الضحايا من أجل العبور إلى قبر، صار الوطن كلّه لا يساوي أكثر منه.
في الشمال السوري المنكوب، حيث يُنفق السوريون أعمارهم بين نزوحٍ ونزوح، وبين دمار ودمار، اختفت كل الهيئات السياسية التي جثمت على صدور السوريين المنكوبين هناك، وصادرت قرارهم، ومثّلت المعارضة السورية أسوأ تمثيل في المنابر الدولية، إلى أن آلت قضية الشعب السوري إلى الإهمال والنسيان.
في المناطق التي يديرها النظام، لم ينزل "الزعيم القائد" إلى أرض الكارثة إلّا في اليوم الخامس، يوزّع، وزوجته، ابتساماتهما "الهانئة" على المنكوبين، تعدُهم بأن "سورية الله حاميها"، مع أن الله لم يحمِها على مدى اثنتي عشرة سنة، فالله ليس مسؤولًا عن غيّ الإنسان، بعد أن منحه العقل والضمير ليعمل ويختار.
مع كلّ يوم في المقتلة السورية، كانت القيم تتراجع، والتعاطف الإنساني يخبو أمام نيران الثأرية والتشفّي
في الرابع عشر من فبراير/ شباط، يكون قد مضى على الزلزال ثمانية أيّام، ويكون الأمل قد انتهى في احتمال العثور على بقايا حياة تحت الأنقاض، هذا ما يقول المنطق والعلم والتجربة، حتى لو كان التاريخ يسجّل بعض الاستثناءات المثيرة للدهشة والعجب.
في مثل هذا اليوم، في عيد الحب، قبل 12 عاماً، كانت سورية تتزيّا بالأحمر، وكانت قطاعات كثيرة في الاقتصاد تزدهر، وتتحرّك الأسواق وتتحقّق المرابح. لم يكن هذا المظهر تعبيراً عن حبّ حقيقي، أو فهم دقيق وتمثّل لمعنى الحب، ولم يكن ملمحاً عن حياة هانئة يعيش فيها السوريون بوئام وسعادة وكفاية معيشية، بلا هموم أو معاناة. بالطبع لا، لم تكن تلك الحياة التي تبدو مستقرّة، والتي يردّد عنها بعض السوريين اليوم مقولة "كنّا عايشين"، لم تكن غير حياة ركود، والركود لا يعني الاستقرار، بل يعني الاستنقاع، يعني احتباس المياه في حيّزٍ مغلق، فتتحوّل إلى مياهٍ آسنة، لا ينمو فيها غير الطحالب، ولا يُسمع منها غير نقيق الضفادع.
مما كان قبل 12 عاماً، لم يكن حياة كما يليق بالإنسان والمجتعات الإنسانية، ما كان من مظاهر احتفالية بعيد الحب، لم يكن تقديرًا للحبّ وتسبيحًا باسمه، كان قشرة من القشور المتراكمة على السطح الموّار بكل التناقضات، فعندما انزلقت انتفاضة الشعب المقهور إلى الحرب، وصار العنف هو الحكم على الأرض، وصار الموت ينهمر من السماء، وينبثق من الأرض، تعرّى الواقع، وبان النسيج المهلهل للمجتمع السوري، ومع كلّ يوم في المقتلة السورية، كانت القيم تتراجع، والتعاطف الإنساني يخبو أمام نيران الثأرية والتشفّي، تحت ضغط غريزة البقاء، عندما تبقى وحدها نشطة في وجه الموت. ولكن، في لحظة الحقيقة، عندما ضربتهم الطبيعة هذه الضربة الموجعة، كسّرت في ما كسّرت طبقات الجير التي راكمتها العقود الماضية وما تلاها من بث السموم، على ضمائر الناس، ليظهر جليًّا، أمام أعين من كانوا غافلين، أو لاهين بسبب ضيق عيشهم، أو تاركين، من دون أن يدروا، عناكب الرداءة والفساد والتضليل أن تعشّش في صدورهم، أن جوهر الإنسان القادر على صناعة الحياة هو الحبّ.
ما فرّقته الحرب أعاد جمعَه الزلزال، ورأى السوريون الأصلاء بعيونهم وقلوبهم أنّهم متروكون للقدر
عاد السوريون أمام هول الكارثة إلى طبيعتهم الإنسانية. وفي الواقع، إن جهود الإنقاذ، وجهود مساعدة الناجين والمتضرّرين، قامت بها، في غالبيتها، سواعدُ الناس العاديين وقلوبهم، الشعب الجائع في غالبيته، البردان، اليائس، المشلول، قسَمَ لقمته بينه وبين المتضرّرين، نزع بطّانيته عن جسده، وهرع ليغطي بها ناجيًا يرتجف من البرد ومن الذهول أمام ركام، قد تكون جثامين ذويه أو أبنائه مطمورة تحته، ولو استطاع هذا السوري لسلخ جزءاً من جلده ليغطّي أخاه السوري المنكوب، كلّهم في النكبة سواء، جاء الزلزال ليوزّع الموت بطريقة أخرى، لم يكن ينقص السوريين تنويعاً به.
ما فرّقته الحرب أعاد جمعَه الزلزال، ورأى السوريون الأصلاء بعيونهم وقلوبهم أنّهم متروكون للقدر، وأن قيادتهم "الحكيمة" لم تقدّم لهم قبل اليوم غير مزيدٍ من أسباب الموت، وأنّ "الزعيم" أو "القائد" لم يقارب فاجعتهم إلّا بعد مرور خمسة أيام على الأرواح التي تئنّ تحت الركام، وفوق الركام ممّن يزيلونه لينتشلوا جثامين أحبّائهم، ويأملون من قلب دموعهم أن يصلوا إلى من لديه رمقٌ من حياة، ولم تكن جروح السوريين وفاجعتهم أرحم في مناطق المعارضة، فتُركوا وحيدين إلّا من رحمة بعضهم تجاه بعض وعناصر الدفاع المدني، أمّا زعاماتهم... فغابت، ومنهم من لم يُسمع صوته وكأنه لم يكن.
ازدادت رقابة الأجهزة الأمنية على ألسنة الناس وضمائرهم، من ينتقد الفساد وسرقة المساعدات، ينتهِ إلى سراديب التحقيق والتعذيب. أمّا من يدير الفساد ويبتلع الوطن وما فيه وما يأتي إليه، فهذا تعجز عنه الأجهزة الأمنية، هذا سلوكٌ يُمارس في الداخل، في مناطق النظام وفي المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة الموالية لتركيا. ويبقى هناك هتّافون، يمشون على جثث الضحايا، ويصرُخون: بالروح بالدم... هؤلاء لا يخلو الأمر منهم، كما جاء في كتاب "فرسان الحرّية" للسوري منذر بدر حلّوم: "تجد في جعبة كلّ منّا الكثير من الأمثلة عمّن هتفوا بحياة جلّادهم ويهتفون، عمّن رأوا في استبداده رحمة ومن يرون، عمّن رجوا فيه الخلاص ويرجون، عمّن رفّعوه عن الشرور ومن يُرفّعون، عمّن فصلوه عن منظومة الشرّ ومن يفصِلون، عمّن وجدوا له في ضعفهم عذرًا ومن يجدون، عمّن انتظروا مِن حابسِ الغيم غيثًا ومن ينتظرون، قل إنهم ضحايا، من يعلم منهم ومن لا يعلمون، فبين انفصال الطاغية عن الناس واتصاله بهم، تنثني الركب وتنحني الظهور ويغشى على الأبصار فيُصنع الراكعون. وفي أرحام الراكعين يرتسم الطغاة ومن بطونهم يولدون، وعلى رؤوسهم المطأطأة تنبني العروش".
ضمائر السوريين وعيونهم مفتوحة على الواقع، وتلتقط الحقائق المغيّبة، تتعرّى أمامهم كما تُنبش الضحايا من تحت الركام
السوريون مفجوعون اليوم، ومن قلب الفاجعة ينهض الحبّ ويحرّك السواعد، حتى لو كانوا ذاهلين أمام هول الكارثة، فإن ضمائرهم وعيونهم مفتوحة على الواقع، وتلتقط الحقائق المغيّبة، تتعرّى أمامهم كما تُنبش الضحايا من تحت الركام، قرأوا الوجوه في حمأة الوجع، الابتسامة التي تأتي في غير توقيتها مثل خنجرٍ ينغرز في القلب، في قلب الكرامة، لذلك انتشرت مقولة نُسبت للكاتب الروسي تولستوي، لا أعرف دقّة نسبها إليه: عندما تقف على مآسي الآخرين وانكسارهم، إيّاك أن تبتسم، تأدّب في حضرة الجرح، كن إنساناً، أو متْ وأنت تحاول.
فكيف إذا كان هؤلاء الآخرون شعباً بكامله ينزف جرحه الجديد، مضافاً إلى جروح ما زالت مفتوحة، وإذا كانت الابتسامة يقدّمها في لحظة الألم القصوى رئيس دولة، فقد قدّمت الكارثةُ البرهانَ الأخيرَ على أنّها لم تعد دولة، ولا وطناً، ولا أرضاً صالحة للعيش... علّ هذه الكارثة التي أحدثتها الطبيعة تصير القشّة التي تُنجي الغريق، وليست القشة التي تقصم ظهر البعير... علّ الحب الذي أوقد الحياة في نفوس السوريين، وجعلهم قلباً واحداً في مواجهة الكارثة، يصبح حبّاً مستداماً، يصنع المصير، علّهم يستعيدون حقّهم في صنع مصيرهم ويدفعون باتجاه حلّ سياسي، لا بدّ للعالم أن يسعى به، فكلّ أزمةٍ جديدةٍ في سورية صارت تشكّل عبئاً على العالم، بل صارت سورية بحد ذاتها عبئاً عليه.