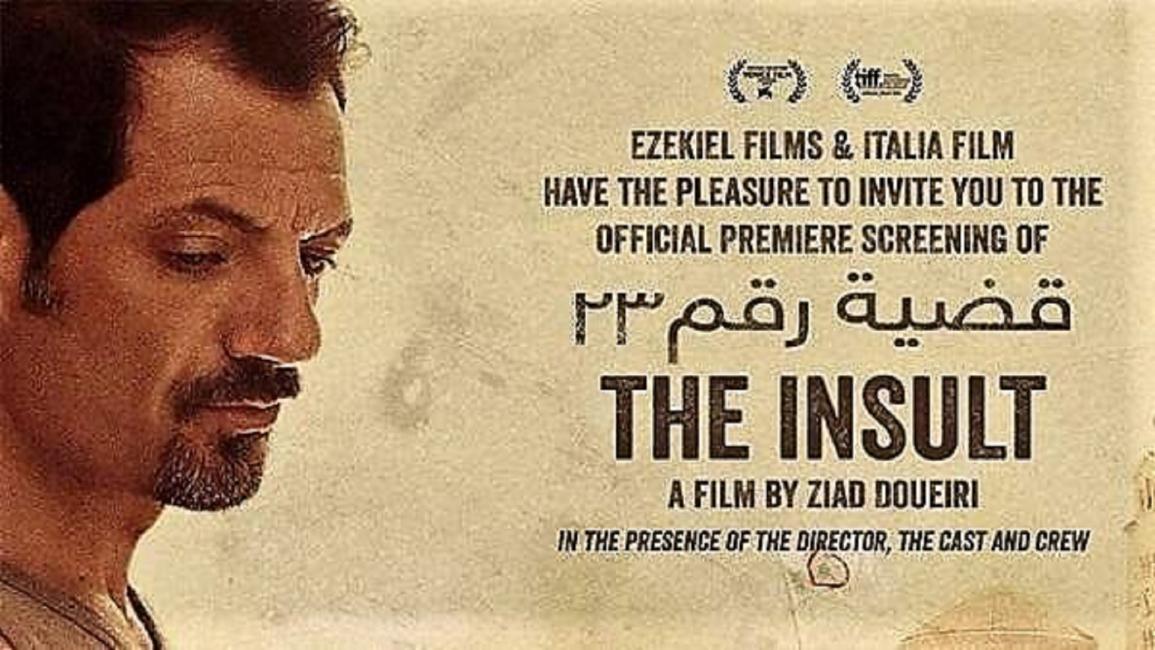12 نوفمبر 2024
ماذا عن "القضية 23"؟
عن "القضية 23" التي تحوّلت إلى قضية، وصار صعبا أن يدلي المرء برأيه فيها على قاعدة فنية.
يحضرني هنا موقف المخرج إيليا كازان الذي تراجع أمام ضغوط المكارثية عليه، فوشى بزملاء له، لكي تبقى أبواب صناعة الأفلام مفتوحة أمامه. وإن كنّا في لبنان اليوم نحيا مكارثية من نوع جديد، فلا تصحّ للأسف مقارنة زياد دويري بالعملاق إيليا كازان، ولا يرقى فيلم "القضية 23"، على ما فيه من إيجابيات، إلى مستوى تحفةٍ فنيةٍ تفرض نفسها بالقوة، على الرغم من شطارة مخرجه، وربما حتى "انتهازية" متذبذبة ومؤكدة.
نحن أمام شخصيتين رئيسيتين، ستعرفان تحوّلا في نهاية الفيلم، إثر تعرّضهما لأزمة. الأزمة هي شتيمة يوجّهها ياسر، اللاجئ الفلسطيني إلى طوني اللبناني القوّاتي، بسبب مزراب مخالِف. يطالب الثاني الأول بالاعتذار، ويتطوّر الأمر بشكل تصعيدي، لينتهي إلى مواجهة في المحكمة. طوني يملك مرآبا لتصليح السيارات، وياسر هو المشرف (مهنته مهندس في الأصل) على ورشة ترميم في حيّ السيوفي، في منطقة الأشرفية. السيناريو، وإن كُتب تبعا لوصفة تعتمدها غالبا السينما الأميركية لإنتاج كوميديا اجتماعية ناجحة، أراد لنفسه عرض رسالة سياسية واضحة: لقد أخطأت الحركة الوطنية، بتحالفها مع الفلسطينيين، في جرّ البلاد إلى حرب أهلية.
كان الأفضل لدويري أن يتوقف هنا، مُجريا بذلك عملية مراجعةٍ محمودةٍ وإعادة محاسبة للذات وللآخر، وهما شرطا كل مصالحة حقيقية، وجلّ ما يحتاج إليه اللبنانيون جميعا في مختلف طوائفهم، وما بدأته القيادات الفلسطينية إثر انتهاء الحرب، حين اعتذرت من الشعب اللبناني. بيد أن دويري ذهب في اتجاه معاكس، منتقلا إيديولوجياً من موقع إلى آخر، قائلا: لم يخطئ أهل اليسار فحسب، بل كان اليمين، وعلى رأسه حزب القوات اللبنانية، هو المحقّ. لذا نراه مثلا يُظهر سمير جعجع (رفعت طربيه) في موضعين، في ما يُشبه توجيه التحية إليه، معلّقا في أكثر من مقابلة ولقاء بأنه الوحيد الذي قدّم اعتذارا، وتخلى عن نهجه الحربيّ.
هذا هو باختصار المضمون السياسي الذي أساء، برأيي، إلى الفيلم على المستوى الفنّي، وقد حوّله، على الرغم مما فيه من إيجابيات، إلى ما يشبه أفلام البروباغندا السياسية، التي تروّج رسالة أيديولوجية معيّنة، مهملةً التركيز على الجوانب الإنسانية والفنية الأساسية لنجاح أي عمل إبداعي. والمفارقة أن أكثر ما يعاني الفيلم منه هو سوء رسم شخصية طوني القوّاتي الرئيسية، فعلى الرغم من ميل المخرج عاطفيا إليها، وعلى الرغم من موهبة عادل كرم ومقدرته المعروفة على تلوين الشخصيات، بدت للأسف فقيرة جدا، أقرب إلى التسطيح والاختزال، ما أبقاها شخصية ورقية، باهتة الملامح، لم يصل إلينا من نبضها شيء. فباستثناء عدائيتها "الكاريكاتورية" حيال الفلسطيني، لا "يعيش" طوني تحت أعيننا بماضيه المأسوي المثقل، وبطبقات تعقيداته وكرهه وخوفه، بل يسير أفقيا، من دون أن يُبنى عاموديا. وقد يكون السبب (كما صرّح دويري بنفسه)، اهتمامه بكتابة هذا الدور، هو القصيّ كلّيا عن هذا العالم، فيما اهتمّت شريكته، جويل توما، بكتابة دور الفلسطيني (كامل باشا) الذي بدا، على عكس الأوّل، أفضل أداء وإقناعا (إلى جانب ريتا حايك، ديامان بو عبود، جوليا قصّار، إلخ) لأنه أفضل تركيبا وأكثر حياة.
يضع طوني تسجيلا لخطب بشير الجميل في مرآبه، وتحديدا التي سبقت انتخابه رئيسا للجمهورية، حيث "يُبدع" في التعبير عن كراهية الفلسطينيين "الغرباء"، وإلقاء تبعات الحرب كلها عليهم، هكذا من دون مناسبة. ثم نكتشف لدى مثوله في المحكمة أنه ليس حزبيا ولم يشارك في الحرب. وحين يجتمع، هو وياسر، برئيس الجمهورية الذي يدعوهما إلى قصره بهدف المصالحة، نراه يجيب الرئيس بكل حدة وقلة احترام، ويقاطعه في أكثر من مرة مستاءً، ليقرّر من بعدها مباشرة، إثر مغادرتهما، أن يصلح سيارة ياسر المتعطلة في باحة القصر الجمهوري!
منذ هذه اللحظة، يفقد الفيلم ما تضمنه من عناصر تشويق وإيقاع رشيق (ساعته الأولى)، ليدخل في ساعته الثانية، في إطالاتٍ ومفاجآتٍ متلاحقة، تكشف لنا أخيرا سبب كراهية طوني وانسحاب ياسر: مجزرة الدامور الفظيعة التي نجا منها طوني صغيرا، حين حمله والده وهرب به، ومجزرة أيلول الأسود في الأردن التي نجا منها ياسر. .. والعبرة؟ ليست المعاناة حكرا على أحد. هكذا ينتهي الفيلم "سعيدا" بتبرئة ياسر، وبتعاطفٍ ما بين الخصمين اللدودين.
يحضرني هنا موقف المخرج إيليا كازان الذي تراجع أمام ضغوط المكارثية عليه، فوشى بزملاء له، لكي تبقى أبواب صناعة الأفلام مفتوحة أمامه. وإن كنّا في لبنان اليوم نحيا مكارثية من نوع جديد، فلا تصحّ للأسف مقارنة زياد دويري بالعملاق إيليا كازان، ولا يرقى فيلم "القضية 23"، على ما فيه من إيجابيات، إلى مستوى تحفةٍ فنيةٍ تفرض نفسها بالقوة، على الرغم من شطارة مخرجه، وربما حتى "انتهازية" متذبذبة ومؤكدة.
نحن أمام شخصيتين رئيسيتين، ستعرفان تحوّلا في نهاية الفيلم، إثر تعرّضهما لأزمة. الأزمة هي شتيمة يوجّهها ياسر، اللاجئ الفلسطيني إلى طوني اللبناني القوّاتي، بسبب مزراب مخالِف. يطالب الثاني الأول بالاعتذار، ويتطوّر الأمر بشكل تصعيدي، لينتهي إلى مواجهة في المحكمة. طوني يملك مرآبا لتصليح السيارات، وياسر هو المشرف (مهنته مهندس في الأصل) على ورشة ترميم في حيّ السيوفي، في منطقة الأشرفية. السيناريو، وإن كُتب تبعا لوصفة تعتمدها غالبا السينما الأميركية لإنتاج كوميديا اجتماعية ناجحة، أراد لنفسه عرض رسالة سياسية واضحة: لقد أخطأت الحركة الوطنية، بتحالفها مع الفلسطينيين، في جرّ البلاد إلى حرب أهلية.
كان الأفضل لدويري أن يتوقف هنا، مُجريا بذلك عملية مراجعةٍ محمودةٍ وإعادة محاسبة للذات وللآخر، وهما شرطا كل مصالحة حقيقية، وجلّ ما يحتاج إليه اللبنانيون جميعا في مختلف طوائفهم، وما بدأته القيادات الفلسطينية إثر انتهاء الحرب، حين اعتذرت من الشعب اللبناني. بيد أن دويري ذهب في اتجاه معاكس، منتقلا إيديولوجياً من موقع إلى آخر، قائلا: لم يخطئ أهل اليسار فحسب، بل كان اليمين، وعلى رأسه حزب القوات اللبنانية، هو المحقّ. لذا نراه مثلا يُظهر سمير جعجع (رفعت طربيه) في موضعين، في ما يُشبه توجيه التحية إليه، معلّقا في أكثر من مقابلة ولقاء بأنه الوحيد الذي قدّم اعتذارا، وتخلى عن نهجه الحربيّ.
هذا هو باختصار المضمون السياسي الذي أساء، برأيي، إلى الفيلم على المستوى الفنّي، وقد حوّله، على الرغم مما فيه من إيجابيات، إلى ما يشبه أفلام البروباغندا السياسية، التي تروّج رسالة أيديولوجية معيّنة، مهملةً التركيز على الجوانب الإنسانية والفنية الأساسية لنجاح أي عمل إبداعي. والمفارقة أن أكثر ما يعاني الفيلم منه هو سوء رسم شخصية طوني القوّاتي الرئيسية، فعلى الرغم من ميل المخرج عاطفيا إليها، وعلى الرغم من موهبة عادل كرم ومقدرته المعروفة على تلوين الشخصيات، بدت للأسف فقيرة جدا، أقرب إلى التسطيح والاختزال، ما أبقاها شخصية ورقية، باهتة الملامح، لم يصل إلينا من نبضها شيء. فباستثناء عدائيتها "الكاريكاتورية" حيال الفلسطيني، لا "يعيش" طوني تحت أعيننا بماضيه المأسوي المثقل، وبطبقات تعقيداته وكرهه وخوفه، بل يسير أفقيا، من دون أن يُبنى عاموديا. وقد يكون السبب (كما صرّح دويري بنفسه)، اهتمامه بكتابة هذا الدور، هو القصيّ كلّيا عن هذا العالم، فيما اهتمّت شريكته، جويل توما، بكتابة دور الفلسطيني (كامل باشا) الذي بدا، على عكس الأوّل، أفضل أداء وإقناعا (إلى جانب ريتا حايك، ديامان بو عبود، جوليا قصّار، إلخ) لأنه أفضل تركيبا وأكثر حياة.
يضع طوني تسجيلا لخطب بشير الجميل في مرآبه، وتحديدا التي سبقت انتخابه رئيسا للجمهورية، حيث "يُبدع" في التعبير عن كراهية الفلسطينيين "الغرباء"، وإلقاء تبعات الحرب كلها عليهم، هكذا من دون مناسبة. ثم نكتشف لدى مثوله في المحكمة أنه ليس حزبيا ولم يشارك في الحرب. وحين يجتمع، هو وياسر، برئيس الجمهورية الذي يدعوهما إلى قصره بهدف المصالحة، نراه يجيب الرئيس بكل حدة وقلة احترام، ويقاطعه في أكثر من مرة مستاءً، ليقرّر من بعدها مباشرة، إثر مغادرتهما، أن يصلح سيارة ياسر المتعطلة في باحة القصر الجمهوري!
منذ هذه اللحظة، يفقد الفيلم ما تضمنه من عناصر تشويق وإيقاع رشيق (ساعته الأولى)، ليدخل في ساعته الثانية، في إطالاتٍ ومفاجآتٍ متلاحقة، تكشف لنا أخيرا سبب كراهية طوني وانسحاب ياسر: مجزرة الدامور الفظيعة التي نجا منها طوني صغيرا، حين حمله والده وهرب به، ومجزرة أيلول الأسود في الأردن التي نجا منها ياسر. .. والعبرة؟ ليست المعاناة حكرا على أحد. هكذا ينتهي الفيلم "سعيدا" بتبرئة ياسر، وبتعاطفٍ ما بين الخصمين اللدودين.