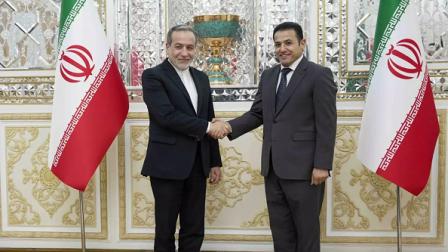يشكّل المهجّرون في الداخل الفلسطيني قرابة ثلث المجتمع الذي أدت إليه النكبة قبل 75 سنة، وهم من تم تهجيرهم وسلب أراضيهم وبيوتهم في العام 1948، ولجأوا إلى بلدات وقرى قريبة ومدن محاذية لمناطقهم الأصلية. وقد تم تجميعهم في حي واحد في كل مدينة، تحول إلى ما يشبه سجناً، أطلقت عليه إسرائيل اسم "الغيتو". ففي حيفا مثلاً تم تجميعهم في حي وادي النسناس، وفي يافا جُمعوا في حي العجمي.
يبعد مهجّرو الداخل الفلسطيني رمية حجر عن أراضيهم ومنازلهم، وتحولوا إلى لاجئين في وطنهم. ألم مرير وإحباط يصعب وصفه أن ترى بيتك وأرضك بعينيك، لكنك لا تستطيع العودة إليهما.
وعن فترة الحكم العسكري لتثبيت واقع التهجير بين عامي 1948 و1966، تقول هبة يزبك، الدكتورة في العلوم الاجتماعية والتي تدرّس في "الجامعة المفتوحة" وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي إن "جذور قضية المهجّرين تعود إلى وقوع النكبة. بحيث هجّرت القوات الصهيونية نحو 750 ألف فلسطيني، ليتبقى منهم 156 ألفاً داخل الحدود التي تحوّلت إلى دولة إسرائيل، ضمنهم شريحة المهجّرين الداخليين، والتي قُدّر عددها بما بين 25 و40 ألف شخص، نحو ثلثهم فقط من المدن".
هبة يزبك: أحد الأهداف المركزية للحكم العسكري الإسرائيلي تمثل في منع المهجّرين من العودة لبيوتهم وقراهم ومدنهم
وتضيف يزبك، وهي نائبة سابقة في الكنيست، لـ"العربي الجديد": "سكن المهجّرون في أعقاب التهجير مباشرة في القرى والمدن المجاورة لمناطقهم الأصلية، وقد قامت إسرائيل فور إقامتها بالإعلان رسمياً عن حكم عسكري في أكتوبر/تشرين الأول 1948 حتى 1966. وهكذا وجد المهجّرون أنفسهم تحت نظام حكم عسكري، يستمد أنظمته من قانون الطوارئ الذي تبنته إسرائيل من الاستعمار البريطاني".
وتلفت يزبك إلى أن أنظمة الطوارئ عملت على فرض الرقابة وتقييد التنقّل، والسيطرة على الصحافة ووسائل النقل، ومنع حيازة السلاح وغيرها، وفي الوقت ذاته تمت إقامة المحاكم العسكرية. وبهذا فعّلت الدولة المقامة حديثاً الأنظمة العسكرية، كجهاز قضائي وسياسي، ما أتاح لها عملية بناء الدولة اليهودية ما بعد النكبة، بحيث ارتفع عدد اليهود من نحو 700 ألف شخص في العام 1948 إلى 2.4 مليون شخص في العام 1967، أي بعد سنة من انتهاء الحكم العسكري.
الهدف الرئيس للحكم العسكري
وتوضح أن أحد الأهداف المركزية للحكم العسكري تمثل في السيطرة على المهجّرين ومنعهم من العودة إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم، وذلك من خلال سياسة عامة تجلت بهدم البيوت في غالبية القرى المهجّرة، والإعلان عن القرى المهجّرة بوصفها مناطق عسكرية مغلقة لمنع أهلها من دخولها، وإسكان المستوطنين في بيوت المهجّرين واللاجئين، وإقامة البلدات اليهودية على أنقاض القرى المهجّرة، ومصادرة الأراضي من خلال قوانين الطوارئ وقانون "الغائب الحاضر" الذي سُنّ في 1950، وسنّ قانون سمي "التسلل" لمنع العودة إلى القرى المهجّرة، وسجن الرجال والشباب.
وتوضح أن المحاولات المتكررة للمهجّرين للعودة إلى بيوتهم تم منعها من خلال نظام الحكم العسكري، وتطبيق قوانينه بحقهم. وتقول يزبك: "يمكن اعتبار فترة الحكم العسكري مفصلية وجوهرية في تثبيت التهجير، وفرض تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية على المهجّرين، الذين انقطعوا عن التعليم، وسط سوق عمل محدود مرتبط باحتياجات البناء للدولة الاستيطانية الحديثة".
وتشير إلى أن المهجّرين رأوا في فترة الحكم العسكري مرحلة انتقالية هامة، إذ إنها ثبّتت وضعهم كمهجّرين فعلياً، وفي الوقت ذاته سلبتهم المكانة "الرسمية" كمهجّرين، وذلك من خلال القرارات الحكومية التي عملت على إذابة وطمس قضية المهجّرين، بحيث لا يتم الاعتراف بكونهم هُجّروا داخل وطنهم.
سقوط وغياب المدينة الفلسطينية
ويتناول المؤرخ جوني منصور موضوع تركيز الاحتلال الإسرائيلي على هدم المدن الفلسطينية. ويقول: "لم تكن حرب 1948 عابرة في التاريخ الفلسطيني، إذ إنها أدت إلى كارثة على الشعب الفلسطيني، كما على فلسطين الجغرافية".
ويوضح أنه من بين أبرز هذه الكوارث إلحاق الضرر الأكبر بالمدينة الفلسطينية، فمن بين المخططات التي وضعتها قيادة الحركة الصهيونية تدمير حضور المدينة الفلسطينية عن طريق توجيه الضربات الأولى في تلك الحرب نحو مجموعة من المدن قبل انتهاء الانتداب البريطاني رسمياً، ما حال دون قيام العرب عموماً، والفلسطينيين خصوصاً، في الدفاع عنها بقوة متوازية مع تلك التي امتلكتها المنظمات العسكرية الصهيونية.
ويشير إلى أن سقوط حيفا ويافا والقدس الغربية، بالإضافة إلى مدن أخرى، شكّل ضربة قاصمة للفلسطينيين، وبالتالي دمرت الحياة المدينية الفلسطينية التي تميزت بنموها وازدهارها، ابتداء من نهايات الفترة العثمانية وصولاً إلى فترة الانتداب البريطاني.
ويؤكد منصور، لـ"العربي الجديد"، أن تغييب المدينة الفلسطينية في الفكر الصهيوني تغييب للحضارة والموروث المادي الذي شكّلته هذه المدينة. وبالتالي غاب الكثير من المشاهد الحياتية التي ميزت الشعب الفلسطيني، بما أنتجه من مسارح ونوادٍ ثقافية ورياضية وحركات كشفية وصناعات حرفية، إلى استقبال وفود من ممثلي المسارح والأفلام السينمائية، والحوارات السياسية والنقاشات الفكرية التي عبّر عنها أبناء فلسطين المثقفون والنخب السياسية على صفحات الصحف التي صدرت في يافا وحيفا والقدس.
ويشير إلى أن تشكيل وبلورة المدينة الفلسطينية لم يكونا نتاجاً مباشراً لحضور الانتداب البريطاني، كما يعتقد البعض، بل هما نتاج تراكمي لجهد وتضحية الشعب الفلسطيني متآزراً مع العرب المحيطين بفلسطين.
جوني منصور: تغييب المدينة الفلسطينية في الفكر الصهيوني تغييب للحضارة والموروث المادي الذي شكّلته هذه المدينة
ويعتبر أنه لم يخطر في بال الفلسطينيين أن مخططاً إجرامياً وإرهابياً كان ينتظرهم على أرض وطنهم بدعم وتعزيز من الاحتلال البريطاني الذي اتخذ شكل انتداب، والمسميات هنا لا تعني شيئاً أمام المخطط الرهيب لإبادة فلسطين، بشعبها وأرضها، لصالح إقامة المشروع الصهيوني المتماثل بالتمام مع المشروع الكولونيالي الغربي، الذي قادته بريطانيا في حينه.
ويقول: "كانت المدينة الفلسطينية الضحية الأولى لهذا المشروع، بعلم مسبق لدى قيادات الكولونيالية بأن الأداة الطيعة التي يمكنها تنفيذ عملية تغييب المدينة تكون عبر توظيف الرؤية الصهيونية على أرض الواقع في فلسطين".
ويضيف منصور: "غياب المدينة الفلسطينية في حرب 1948 هو فقدان حضور المدينة كفعل حضاري تطوري طبيعي للشعب الفلسطيني الذي كان يعمل ويسعى من أجل بناء وتشكيل كيانه السياسي بدولة مستقلة تعبّر عن تطلعاته نحو تثبيت حضوره الفعلي على أرض فلسطين، موضحاً أن المدينة عنصر أساسي في مشروع إقامة دولة أو كيان سياسي فلسطيني مستقل".
من النكبة إلى العودة
في المقابل، يشدد الباحث في جمعية "ذاكرات" عمر الغباري على أن الشعب الفلسطيني نجح، بعد 75 سنة من النكبة، في تحدي منظومة الاستعمار وسياساتها بما يتعلق بمحو الهوية الفلسطينية وإخفاء النكبة من مشهد النضال الفلسطيني، ومن خطاب المساندين للحق الفلسطيني في العالم.
ويضيف، لـ"العربي الجديد": "تبقى النكبة ومُركباتها، من التطهير العرقيّ واللجوء وتدمير المدن والقرى الفلسطينية وسلب أملاك اللاجئين والنّاجين والتهويد، مركز الحدث ولبّ القضية وجوهر الهوية، رغم تمنّيات الصهيونية بأن يموت من الفلسطينيين كبارهم فينسى صغارهم".
ويشير إلى أن "أحد الجوانب الهامة في النضال الفلسطيني التي تحتاج إلى تطوير وتفكير وعمل هو موضوع العودة، وأقول العودة وليس حق العودة، إذ لا جدال في أن الحقّ راسخ ولا تنازل عنه، كما أنه مضمون في القوانين الدولية والقرارات الأممية".
ويتساءل: "لكن هل يكفي التمسك بالحق من دون العمل على تطبيقه؟ لماذا لا نطرح كفلسطينيين، لأنفسنا وللعالم، برنامجاً سياسياً، عن العودة الفعلية؟ ما معنى العودة؟ وكيف نراها تطبّق على أرض الواقع؟".
ويلفت إلى أنه "من خلال عملنا الميداني بموضوع النكبة وتوثيق شهادات المهجّرين والمهجّرات، وتنظيم جولات في البلدات المهجّرة وتعليم الجمهور عن النكبة، وزيادة الوعي إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب والوطن الفلسطينيين، حضر دائماً السؤال: ماذا بعد المعرفة والتوثيق؟ في مرحلة معينة، قبل عدة سنوات، طوّرنا مشاهدتنا لمواقع البلدات المهجّرة من حيّز منكوب إلى حيّز يجب أن يهيّأ للعودة، ووسعنا رقعة المعرفة من دراسة أحداث الماضي إلى تخطيط وتصوّر المستقبل".
ويتابع: "بادرنا في جمعية ذاكرات مع مجموعات ومؤسسات وباحثين آخرين، لتشكيل مجموعات عمل وحوار وبحث، من الأجيال الفلسطينية الشابة، وناشطين وناشطات من جنسيات مختلفة، داعمين للعودة، تمحور عملها على تصور العودة وطرح أفكار وتساؤلات عن الجوانب العملية للعودة الفعلية".
ويقول: "طفت فوق طاولة البحث أسئلة لم تُطرح من قبل: كيف سيعود اللاجئون واللاجئات، وإلى أين سيعودون؟ ما هو مصير المستعمرات الإسرائيلية المبنية فوق البلدات الفلسطينية؟ وأي نمط حياة تريد الأجيال الفلسطينية العائدة؟ وكيف سيتم تقسيم الأراضي؟ وما هو مصير مخيمات اللجوء؟ وما الذي يجب عمله تمهيداً للمرحلة الجديدة؟ وأسئلة كثيرة هامة أخرى. إن هذا النوع من التفكير عبارة عن فرصة نادرة ومفصلية في مسيرة النضال من أجل العودة، يجدر تبنيها".
ويضيف: "اعتماداً على التوثيق، واستناداً إلى الحق بالعودة، وعطفاً على الإصرار على المطالبة بالاعتراف الإسرائيلي عن مسؤوليته عن النكبة وتقديمه للمحاسبة، علينا برأيي، طرح برنامج عملي، أو على الأقل بدء النقاش حوله، لتطبيق فعلي للعودة".