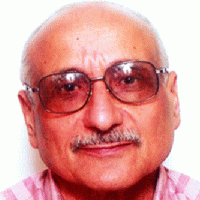قال صلاح عمر العلي كلمته ومشى
يرى العضو الأسبق في قيادة حزب البعث في العراق، الراحل قبل أيام، صلاح عمر العلي، أن البعثيين لم يكونوا ناضجين بما يكفي لإدارة دولة، وأن انقلاب 17 تموز (1968) الذي كان أحد صانعيه أريدَ منه أن يكون مختلفا تماما عن تجربة البعثيين الدموية في عام 1963. ولذلك أطلق عليه صانعوه في بياناتهم الأولى تسمية "الثورة البيضاء" التي سرعان ما انقلبت إلى "ثورة دموية حمراء" أوقعت في حبالها ضحايا كثيرين، وبعضهم بعثيون!
ألقى العلي بمسؤولية ما حدث على صدّام حسين الذي كان يتصرّف "بوحي من مشروعه الخاص متجاهلا مشروع الحزب، ومتفرّداً بالسلطة"، وفق ما قاله على شاشة "الجزيرة" في برنامج "شاهد على العصر"، مضيفاً أنه اكتشف ذلك بعد فوات الأوان، ولذلك تخلّى عن موقعه الحزبي، وهاجر إلى مصر ثم إلى لبنان، لكنه عاد إلى بلاده بعد ضغوط عديدة. ... يتذكر أن صديقه مرتضى سعيد عبد الباقي الذي كان في حينه وزيراً للخارجية أبلغه أن عليه القبول بمنصب سفير، وإذا رفض فانه بذلك يغامر ببقائه حيّاً، وفهم العلي أن مصدر هذا "التهديد" صدّام نفسُه. ولذلك اضطرّ للقبول بما عُرض عليه، حيث عُيّن سفيراً في أكثر من دولة، وممثلاً للعراق في الأمم المتحدة.
يقول العلي إنه تعلّم من عمله الدبلوماسي الكثير، لكنه لم يكن يعتبر نفسه ممثلاً لنظامٍ يعارض سياساته وممارساته العملية، وإنما هو "موظّف"، شأنه شأن أي موظف إداري آخر، ينفّذ ما تقرّره الحكومة التي يعمل في ظلها، ولا يشارك في تقرير سياساتها، لكن وجهة نظره هذه كانت مثار انتقاد عديدين معنيين اعتبروا دور السفير لا يقلّ عن دور وزير الخارجية الذي يعبر عن سياسات حكومته ويروّجها.
يروي صلاح عمر العلي واقعة قد تكون التي مهّدت لقطيعته النهائية مع النظام، ففي قمّة دول عدم الانحياز في هافانا في سبتمبر/ أيلول 1979 التقى الرئيس صدّام حسين بوزير خارجية إيران، إبراهيم يزدي، وكان ثالثهما صلاح عمر العلي الذي سمع من الاثنين كلاما إيجابياً، ورغبة في تفادي قيام حرب بين البلدين الجاريْن، حيث كانت العلاقة قد وصلت إلى منحىً خطيرٍ يهدّد بنشوب حرب، وتعهد الاثنان بتبادل الوفود وصولا إلى هذه الغاية. وعندما خرج يزدي من الاجتماع، تطلّع صدّام إلى صلاح يسأله رأيه في ما سمعه، عبّر صلاح عن سروره بالنتيجة، لكن صدّام صمت برهة، ثم قال له بنبرةٍ فيها شيءٌ من الحدّة: "أنت خربان (!)، خرّبتك الدبلوماسية". لم ينتظر صدّام ردّاً من صلاح، إنما أردفه بعبارة أراد أن يكون فيها أكثر وضوحا: "إيران تعصف بها الخلافات، ويعم فيها الخراب، وهذه فرصتنا في أن نستعيد كل ما أخذته منّا".
لم يكن صلاح العلي يعتبر نفسه ممثلاً لنظامٍ يعارض سياساته وممارساته العملية، وإنما هو "موظّف"، شأنه شأن أي موظف إداري آخر
أدرك صلاح بعد الاجتماع أن الكارثة قادمة، وليس ثمّة كوّة مفتوحة على طريق السلام، وهو لا يستطيع ان يكون "شاهد زور" على ما ستوقِعه الحرب من مآس، وما تلحق بأبناء البلدين الجارين من آلام، ولذلك قدّم، بعد شهورٍ من نشوب الحرب، استقالته من عمله، وطلب اللجوء في دولة أوروبية، وتحوّل إلى ناشط في صفوف المعارضة.
عاد الرجل الى بلاده بعد الاحتلال الأميركي، وفي ظنّه أن بإمكانه أن يستكمل دوره الوطني في خدمة شعبه، وبالطبع لم يكن راضيا عن سقوط النظام على أيدي الأميركيين، وكان يتمنّى لو حدث ذلك على أيدي الوطنيين العراقيين. شكّل حزباً، ورفع راية "الوفاق الديمقراطي" في مواجهة النزعات الطائفية والعنصرية التي تصاعدت بعد الاحتلال، وأصدر صحيفة كي تعبر عن توجهاته، لكن ذلك لم يستمر طويلا، إذ أدرك أن الساحة لم تعُد كما تصوّرها، فعاد خائباً الى منفاه، ليبقى في المجال القلق، مجال التخيّل والحلم، وكان يأمل أن يتجسّد هذا الحلم الذي أعطاه الكثير من عمره في دولةٍ عاقلةٍ، عادلة، وفاضلة، إلا أن هذا الحلم لم يتحقّق، وقد لا يتحقق في القريب، وهذا ما دعاه إلى أن ينصح الناشطين الشباب بالتعلم من تجارب سابقيهم، ونبذ العنف الذي لم يعد فاعلا، واعتماد المقاومة السلمية، والنهج الديمقراطي.
كان صلاح عمر العلي الذي رحل في الأسبوع الماضي واحدا من جيل استثنائي، واجه الكثير من التحدّيات لكنه ظلّ صامداً، وعند خط النهاية لم يربح أحد. الموت وحده هو الذي ربح، أما صلاح فيكفيه أنه قال كلمته، ومشى.