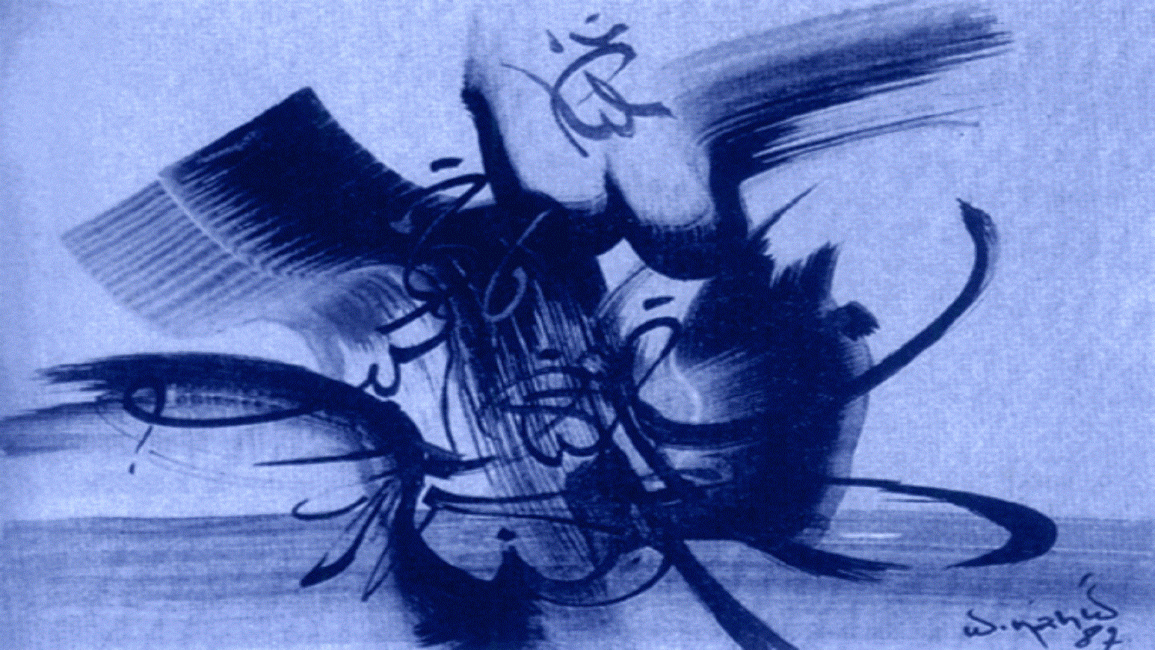المَجْد لمياس والموت لمشروع ليلى
(وجيه نحلة)
طارَ عقل اللبنانيين بعدما فازت فرقة ميّاس، الراقصة، بالمرتبة الأولى في مسابقة أميركية (أميركان غات تالنتْس). فانهالت التهاني، وكان إجماعاً "وطنياً"، على اختلاف الأطراف. من رئيس الجمهورية، الذي منح الفرقة وسام الاستحقاق اللبناني المذهَّب "تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية"، إلى رياض سلامة الذي سنّ أسنانه على المليون دولار الذي ربحته الفرقة، إلى قيادة الجيش، وحتى وزير الثقافة، المحسوب على "الثنائي الشيعي"، الذي لم يقصّر الشهر الماضي (أغسطس/ آب) في تبرئة هادي مطر، الشاب اللبناني الذي طعنَ الروائي سلمان رشدي، بدفاعه عن الخميني في فتواه القاضية بهدر دم رشدي .. هذا الوزير قال شعراً في الفرقة الرابحة.
ومن خارج هذه الحلقة الضيقة، كانت مواقع التواصل تحتفل أيضاً، وكتّاب وصحافيون، وبعضهم مرموق، يعلن أن نجاح الفرقة الراقصة هو "انتصار للنمط اللبناني في العيش والتفاعل، وارتقاء في قدرة المجتمع اللبناني على التحديث من مدخله الفني (...) انتصار ثقافي لبناني عربي".. إلخ. فيما رئيس اتّحاد بلديّات قضاء جبيل، المحسوب على العونيين، اتخذ قراراً بتسمية أحد شوارع بلدة قرطبا باسم ميّاس نديم شرفان، مصمّم رقصات الفرقة ورئيسها. وقِسْ على تلك الفرحة فرحات.. وشعارات من نوع "شكراً على الفرح والأمل"، أو "انتصرنا هنا أيضاً". علماً أن أداء فرقة "ميّاس" في هذه المسابقة يطرح مشكلاتٍ عديدة: أولاها هويتها الفنية. ثلاثون فتاة لبنانية، يتقدّمن باسم بلادهن الشرقية، رقصاً لا يمتّ إلى الرقص الشرقي الذي نعرفه إلا في بضع لحظات، كأنها مسروقة، حيث تهزّ إحداهن خصرها. أما الباقي، فشيءٌ يشبه البرْمجة، مثل حركات اليدين، المسروقتين من الهند والصين. براعة في تنظيم الحركة، نعم، ولكنها مهارات تقنية، تلتحم بلعبة الضوء، فيكون عرضها بصَرياً. وهو عرضٌ لا يوحي إلا بالانضباط، والتدريب المستمر. فيما هندام الراقصات يدخل مباشرة في دائرة الاستشراق، يذكِّر باللوحات التي رسمها أوروبيون عن نساء الشرق في الزمن السالف، وقد تخيّلوها، لأنهم غير قادرين على الدخول إلى قصور الحريم. باختصار، بدَتْ الفرقة وكأنها تقدّم عرضاً عن سلاسِل تكبّل النساء، عن حجاب للوجه، من دون العينيين المكحّلتَين، وكشف للبطن، وحركة شديدة الانضباط، كما كان هو حال الجاريات السلْطانيات، أو الصورة التي كُرّست عن نساء الشرق.
وإذا أردتَ الذهاب إلى أبعد من ذلك، فإن أداء الفرقة والإعجاب الذي لقيه "نجاحها" في برنامج أميركي يطرحان كل إشكالية الرقص الشرقي: أين نرقص؟ كيف نرقص؟ بأية روحية نرقص؟ وهل الرقص الشرقي، في تجربته المتعثّرة اليوم، هو دعوة إلى تكبيل حرية الجسد وضبطه وإخضاعه؟ هل تكون تلك القواعد الصارمة هي المقياس؟ هل الرقص الشرقي "مهنة"، أم تراث، أم فرْفشة؟ ومن تكون بطلته؟ أو بطله؟ فهل هو مقتصرٌ على النساء؟ والرجال الرجال، مستثنون؟ فَضْلة خير في نهاية السهرات؟
تحاكي قصص وأغاني مشروع ليلى صراع المنظومة والمال والسلطة والنفوذ والأمن، وسياستها التي تعتاش على قهر المواطنين الضعفاء
في المقْلب الآخر، ثمّة فرقة فنية أقدم من "ميّاس" اسمها مشروع ليلى. أصدرت أربعة ألبومات، ضمّت تسع أغانٍ. ومنها "رقصة ليلى" التي فازت بالمرتبة الأولى في مسابقة نظّمتها إذاعة راديو لبنان. وكل واحدةٍ من أغاني "مشروع ليلى" قصة، يؤلفها لحنٌ وكلمات. وتحاكي هذه القصص صراع المنظومة والمال والسلطة والنفوذ والأمن، وسياستها التي تعتاش على قهر المواطنين الضعفاء. كل أغنية هي عن معيوشٍ واجهناه كلنا في يومياتنا، عن أجسادنا المكبّلة، وذلك كلّه بلغة ساخرة، ولحن بطيء سريع، وإعلان عن هوية جنسية مغايرة (أغنية "للوطن" على أحد المسارح البيروتية رافقتها راقصة شرقية تتفاعل مع لحنها، وأحدثت حماسةً عالية بالرغبة في الرقص بين الجمهور.. رقصة تنقض كلياً ادّعاءات "ميّاس" بشرقيتها).
وقد تعرّض أعضاء فرقة مشروع ليلى، في هذه الأثناء، لشتى أنواع الاستفزازات. من تهديد بالقتل، افتراضي أو واقعي، إلى حملات الشيْطنة والسخرية والتسخيف، وكذلك في بلدَين عربيَين، الأردن الذي منعها ومصر أيضاً، بعد حفلة فيها انتهت بمأساة: فتاة مصرية، من الجمهور، اسمها سارة حجازي، رفعت علم قوس قزح، فأُدخلت السجن، وعُذّبت وأُهينت، ورُحلّت إلى كندا حيث انتحرت حزناً وكَمَداً.
انهيار "مشروع ليلى" من انهيار لبنان التعدّد والانفتاح، وتعليق الأوسمة على صدر "ميّاس" تأجيل لهذا الانهيار
عشية انهيار لبنان كانت للفرقة حفلة في مدينة جبيل اللبنانية. وبتحريض ضمني من جبران باسيل، ومعه "القوات اللبنانية" المنافسة له، التي لم تستطع إلا مجاراته، نُظِّمت حملة شعواء ضد الفرقة، وتهديدات بالقتل والحرق، وقفت خلفها عَلَناً الكنيسة المارونية، المتمثلة بمطرانية جبيل المارونية والمركز الكاثوليكي للإعلام، والاثنان طالبا بوقف الحفلة. الأولى، المطرانية، قالت إن أغاني الفرقة "تمسّ بغالبيتها القيم الدينية (...) وتتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي"، فيما الثاني، المركز، قال إن أغاني مشروع ليلى "تشكّل إساءةً وخطراً على عادات المجتمع". والاثنان لا ينتبهان إلى أن كنيستهما حمَتْ الأب منصور لبكي، الذي اتّهمه الفاتيكان بجرائم جنسية ارتكبها تجاه تلامذته البنات.
حملة الكنيسة نجحت، وأُوقف عرض مشروع ليلى. ولم تبقَ "شخصية"، فنية، إعلامية، سياسية، إلا وشدّت على يد الكنيسة، أو سكتَت عنها، أو كرّرت التهم الموجهة إلى الفرقة.
وها هو الآن حامد سنّو، رئيس فرقة "مشروع ليلى"، وبالتزامن مع "انتصارات" فريق ميّاس، يعلن في مقابلة مع إذاعة "سردة" اللبنانية عن حلّ فرقته، وذهاب كل فرد منها إلى سبيله لكسب عيشه. والأسباب التي يعدّدها تدخل في صميم ما كابدته فرقته، وانتهى بها الأمر إلى انهيارها وإفلاس أعضائها. هي الجائحة وانفجار مرفأ بيروت، وما يسمّيه سنّو "الأزمات التي أُثيرت حول الفرقة"، أي حملات التحريض على القتل الفني والجسدي، العلنية والخفية. بل شعوره بالذنب على انتحار المصرية سارة حجازي. وبذلك، يترافق مصيرُه الخاص مع مصير البلاد، ويكون الأصدق في التعبير عن نفسه.
وهذه الميزة الأخيرة، الصدق بالتعبير، هي التي تجعل فرقة مشروع ليلى منفردةً في فنها، أو لنقل واحداً من عناصر هذا الفن. أما بقية هذه العناصر فهي خليط من الموهبة الحقيقية والتجارب المعيوشة والقناعات واللغة، وربما الاختلاف في الهوية الجنسية. فالمثليون، كما يظهر تباعاً، هم أكثر الأفراد إبداعاً. لا لشيء أكثر من أنهم مهمّشون، "غير محترمين"، موضوعون على رفّ الشيطان.
في السياسة كما في الفن نستورد صورتنا عن أنفسنا، كما نستورد "المشاريع والحلول"، فنقتل الإبداع ونحيي العروض الاستهلاكية
نحن هنا أمام حالة خاصة، أو ربما منتشرة: فرقة فنية مستقلة ذات نبْرة عالية وكلمات وهندام وحرية ورقص كله يعبّر عن ذاته، لم تَنَلْ حظها من الغرب، لا نعرف السبب، ربما لأنها لا تعرف من أين تؤكل الكَتِف. هذه الفرقة تُجْلد ثم تُرْجم، فتموت. تقابلها فرقة أخرى، بلا تاريخ، بلا إنتاج سابق سوى مسابقات للهواة، رقصها منذورٌ للمسابقات الدولية، معدومة الشخصية الفنية، تفوز بالمسابقة وتكرَّس، فتهلّل لها المنظومة الحاكمة، وتُشرك رعيتها باحتفالاتها، وتعتبر فوزها لحظة "إجماع وطني".
لماذا كل هذا الترحيب "الوطني" بفرقة ميّاس؟ لأن الفوز جاء من أميركا، من العدو الأبدي. وهذا تقليد لبناني عريق، بأننا نعتزّ دائماً بالصورة الإيجابية التي يرسلها الغرب عنا. الغرب، أو إسرائيل، إذ لا نتوقف عن الاعتزاز بـ"اعتراف العدو" بكذا وكيت من ذكائنا، من قدراتنا.. إلخ. ونحن غائصون في الوحل. فيما فريق مشروع ليلى "محلي"، لا يهمّ القدر الذي لقيه وسط الشباب اللبناني والعربي، ولا وقوع شهيدة له.
تماماً كما في السياسة، ننتظر الوحي من الخارج، ننتظر القرار التقييم، التوجه. شعب ومنظومة لا يعرفون تقرير مصيرهم، سوف ينتظرون الإشارة من الخارج. في السياسة كما في الفن نستورد صورتنا عن أنفسنا، كما نستورد "المشاريع والحلول"، فنقتل الإبداع ونحيي العروض الاستهلاكية، التي تلاقي إعجاباً في هذا الخارج.
انهيار "مشروع ليلى" من انهيار لبنان التعدّد والانفتاح، وتعليق الأوسمة على صدر "ميّاس" تأجيل لهذا الانهيار.