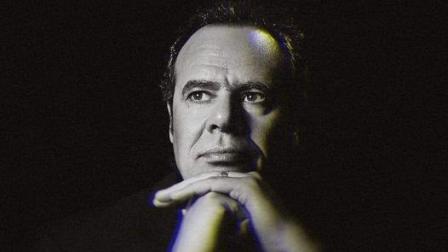ليست المرة الأولى التي تُدهش فيها المخرجة والمؤلّفة الأميركية، ليزا جوي، بابتداعها متناً سينمائياً أو تلفزيونياً، يُوازي ـ في تشكّلاته البصرية ـ بين الغوص في عوالم الفانتازيا، والانتماء ـ في الوقت نفسه ـ إلى واقعٍ منكوب.
يبدو ذلك جليّاً في فيلمها الجديد، "ذكريات" (ترجمة حرفية لـ Reminiscence، التي تعني أيضاً تذكّر، وذكرى ماضية)، المعتمد على خلطاتٍ بصرية ذات خيالٍ علمي. عمل سينمائي يحثّ على التفكير في كيف يُمكن للذاكرة أنْ تغدو وطناً، أو حاضراً مهزوماً ومُنتحراً على أعتاب واقعٍ مُرتبك. وإذا شكّل الخيال العلمي لديها مادّة دسمة وسنداً جمالياً، تستند إليهما للتخييل، ولاجتراح صورة سينمائية تُغرق فيها مدينة ميامي بمياه البحر، فذلك لا يتجاوز حدود الفضاء السينمائي وأكسسواراته. وبالتالي، يصعب اعتبار الفيلم خيالاً علمياً، كما قدّمته صالات العرض الأميركية قبل أسابيع.
منذ بدايته، تبرز قوّة سيناريو "ريمينيسنس" في اختراق النموذج الهوليوودي، شكلاً وموضوعاً وقالباً. رغبة ليزا جوي في التجديد قويّة وواضحة المعالم والرؤى، تبدأ منذ كتابة النصّ وتوليفه وتفتيت قصصه الصغيرة، وجعلها تتقاطع وتتلاحم في ما بينها، عبر سيرة الحكي. ذلك أنّ خرق نموذج الحركة عاملٌ أساسي في تجديد النصّ؛ فجوي لا تُراهن على الأجساد والأشياء الماديّة الظاهرة، بل تسعى ـ بصرياً ـ إلى القبض على الأثر الفنّي.
هذا الأخير يكشف عنه، بين حينٍ وآخر، أداء الممثلين والنصّ وطريقة التعامل مع الصورة، فنياً وجمالياً. لذا، تُضمر جوي أكثر ممّا تُظهر. فالنص سلس وواضح، لكنّ تخييله وتحويله إلى صورة أمرٌ بالغ الأهمية، ويتحكّم في صناعة جماليات الفيلم من عدمه.
السيناريو مُجرّد مُحرّكٍ للشخصيات، وقالبٍ يُوجِّه خطّ السرد. صُورُه توقٌ إلى اللانهائي، وقبضٌ على فيزيونوميّة الكائن وهشاشته، لحظة خراب النفس، وفداحة الحرب. لكنْ، بقدر ما يُرمِّم النصّ ومَشاهده مسألة الفهم والوضوح في ذهن المُشاهد، تترك جوي مساحة مشرّعة للتأويل، بحكم لحظاتٍ سينمائية غامضة، مع أنّها تُبرّرها بصرياً، بشكلٍ سريع، خاصّة حين تنتقل من حكايةٍ إلى أخرى، ومن نسقٍ جماليّ إلى آخر.
في الأول، يبدأ "ريمينيسنس" بشكلٍ سلسٍ وهادئ: نِكْ بانّيستر (هيو جاكمان)، جندي سابق يعمل مديراً لمُختبرٍ سرّي. رفقة مُساعدته، إميلي "واتّس" ساندرس (تانديواي نيوتن)، يُساعد الناس على تذكّر صُوَرهم ومشاعرهم وأحلامهم، وعلى استرجاع أشياء ضائعة ومُنفلتة، للقبض على المنسيّ من حياتهم اليوميّة، وعيشها مُجدّداً. ذات يوم، يلتقي بانّيستر امرأة جميلة تُدعى ماي (ريبيكا فيرغسن)، يدفعه بهاء سحرها وصورتها إلى منحها فرصة التذكّر، بحثاً عن مفاتيحها الضائعة منذ أيام، قبيل لحظاتٍ على إغلاق المختبر. الوقوع في جمال المرأة ليس كليشيه بصريّاً مألوفاً في أفلامٍ رومانسية عدّة، بل طريقة تجعل ليزا جوي تنسج وشائج جماليّة خفيّة بين الطرفين، وتوهم المُشاهِد بالبُنى الجماليّة المُستبطنة في الفيلم.
في فترة استعادة المفاتيح الضائعة، يُغرم نِكْ بماي، فيتحوّل الفيلم من صورة سينمائية، تعيش على خراب حربٍ وأهوال، إلى مُنجزٍ سينمائيّ رومانسيّ، قادرٍ على تأجيج عنصري السرد ولذة الحكاية. مع أنّ الحب دعوة إلى استكمال الفيلم، وشرط فنّي في تجميل بنية النصّ، ظلّ فقدان ماي عند ليزا جوي خلاصاً جماليّاً يستند إليه "ريمينيسنس". فكلّما يتقدّم البحث عنها، تكشف الصُوَر قصصاً وأسراراً، ويتفتّح الفيلم، وتتّخذ الحكاية أفقاً خطّياً.
تتفنّن ليزا جوي في صنع فيلمٍ مُلغز، مليء بمفاجآت جماليّة. مع هذا، يجب التمييز بين جوي المُؤلِّفة وجوي المُخرجة. لأنّ ذلك يُمثِّل عنصراً فنياً مهمّاً، لاستيعاب خصوصية الاشتغال بين النصّ والصورة، وفهم طبيعة الانتقال، وكيف أجادت العملين معاً. في المرحلة الأولى، يكتسح النصُّ الفيلمَ، وينصاع المُمثّل إلى طبيعة السيناريو، فالصورة تعمل على محاكاة النصّ بحِرفية وميكانيكية، يُتوَّج معها بالحكي. في الثانية، تتحكّم الصورة بالسيناريو، وتعمل ـ عبر الحركة والعنف والتشويق البوليسيّ ـ على تخييل النصّ، وجعله تابعاً لها على مُستوى النّسق.
على هذا الأساس، لا يبدو الانتقال بين العملين وظيفة إجرائية، أو مسألة تقنية لدى ليزا جوي، بل ضرورة فكرية تمنح فيلمها مُتنفّساً جمالياً، تتأرجح اشتغالاته بين تماسك السيناريو وقوّته، وبين الصورة وقدرتها على التخييل والابتكار.
رغم أنّه يُقدَّم كفيلم خيال علمي، يختلف "ريمينيسنس" كلّياً عن هذا النوع، لأنّ مُنطلقاته الفنية واقعية، تتمحور حول قصة حبّ بين رجل وامرأة. انشغال جوي بتأثيث الفضاء بصرياً، بإغراق شوارع ميامي وأزقّتها بمياه البحر، جعل المُشاهد يُصنِّفه في إطار الخيال العلمي، مع أنّ تفاصيله البصريّة والنصّية مبنية على أفقٍ واقعي، باستثناء فضائه، إذْ تجري الأحداث والوقائع في قالبٍ فانتازي.