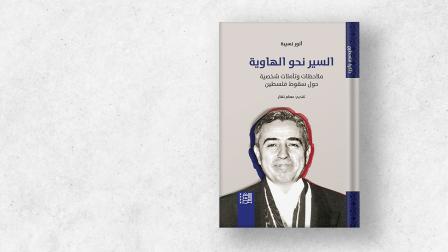تمرّ اليوم الذكرى السابعة عشرة لرحيل المفكّر الفلسطيني هشام الشرابي (1927 ـ 13 كانون الثاني/ يناير 2005)، صاحب "النقد الحضاري للمجتمع العربي" و"مقدّمات لدراسة المجتمع العربي". مناسبة يستعيده فيها الشاعر والمترجم والناشر التونسي خالد النجار.
أتذكّر، في ضوء تلك الظهيرة الخريفية في حديقة "جامعة جورج تاون"، أنّنا كنّا أمام البناية التي تضمّ مكتبة الجامعة، وكان حليم بركات يقف غير بعيد. تطلّع هشام شرابي إلى العالم من حوله: سماء أكتوبر الزرقاء وأشجار حديقة الجامعة والضوء الذي يغمر حجارة جدران جورج تاون القديمة، ثم التفت إلينا.
قال مبتسماً: كان نيتشه يحبّ هذه الشمس الغامرة.
بدا هشام مُشرق الوجه، كلّه غبطة بنعمة الوجود، وهو يستعيد قراءاته للفيلسوف الألماني الذي قرأه مبكّراً.
في تلك اللحظات، وأنا أصغي إلى هشام، عادت إلى وعيي صورة نيتشه وهو في غابة Èze-sur-mer، في قرية إيز الجبليّة على مشارف مدينة نيس الفرنسية؛ الغابة التي أخذني إليها صديقي المكتبي الفرنسي برنار، قال هنا "درب نيتشه"، ثم أردف: "كان كثيراً ما يتسلّى مع الأطفال، يأتي هنا ليستعيد حيويّته، وهنا أيضاً كتب القسم الثالث من "هكذا تكلّم زرادشت"، ومن هنا كتب لصديقه الموسيقي بيتر غاتس معبّراً عن رغبته في مواصلة النُّزول نحو الجنوب: في السنة القادمة قد أمضي إلى تونس".
سألتُ هشام: "ماذا تقرأ هذه الأيام؟"، فأنا تُثيرني قراءات الآخرين؛ أفيد من خياراتهم، إذ لم تعد الصحافة الأدبية تعرض اليوم الكتاب الجدير بالقراءة، وإنّما هي خاضعة في خياراتها للإيديولوجيا والتسويق أو الصداقات أو أيّة تأثيرات أُخرى لا علاقة لها بالقيمة الحقيقية للنصّ.
قال: أقرأ الآن رواية وليم فوكنر، "ضوء في أغسطس".
ثم عاد للحديث عن نيتشه.
كان هشام ينظر إلى الشاشة مفجوعاً بما جرى للشابّ الأسود
بدا لي هشام مزيجَ أزمنة ومناخات روحية متباينة؛ بدأ في العشرين من عمره رومانسياً مثالياً عندما ذهب إلى ميخائيل نعيمة في عزلته الصوفية في الشخروب، والتقى أنطون سعادة، وقرأ فريديريش نيتشه الذي جلبه جبران للنصّ العربي، الذي وقع تحت تأثيره عشرين سنةً، وكتب "النبي" متأثّراً بـ"هكذا تكلم زرادشت".
وتعودني تلك الشمس الصفراء المتوهّجة قبل الغروب في حديقة بيته في ماريلاند، يعودني حوض الأسماك، وهي حفرة وسط الحديقة سوّتها زوجته، غاييل، لتأتي العصافير تشرب منها ويلمع فيها قمر الصيف وتتغطّى بالسرخس في الشتاء... أتذكّر أنه أخذني إلى مكتبه الذي يقع في قبو البيت. ثمّة صورة لجدّه، حاكم عكّا، باللباس الرسمي العثماني: النياشين والشرابات والأزرار الذهبية. لم يعلّق على الصورة، كما هو حال هشام في امتناعه عن وضع ذاته، أناه، في المقدّمة. ثم التحقنا بغاييل في المطبخ الذي يُفضي إلى الحديقة. جلسنا إلى الطاولة التي تتوسّط المطبخ، بدأ الليل يلفّ العالم. جلس هشام قريباً من الباب الزجاجي الذي يفتح على الحديقة. كان ينقل بصره من الحديقة إلى شاشة التلفزيون...
كانت غاييل تعدّ شيئاً للعشاء وتقول مازحةً: هشام لا يساعد كثيراً في أعمال المطبخ. وهشام يتطلّع إليها مبتسماً ولا يقول شيئاً. ثمّ، فجأةً، ظهر برنامج الكاميرا الخفية الذي كان في أساس الرقابة التي بدأ المواطنون الأميركيّون يقومون بها في مواجهة تجاوزات الشرطة التي ظلّت تمارس أخطاءها، بل إجرامها، بلا رقيب. ظهر على الشاشة شابٌّ أسود يقف مرعوباً أمام واجهة أحد المحال، قُبالة ثلاثة من رجال الشرطة الفدرالية الذين يصرخون فيه أنْ يظلّ مكانه. ثم نرى أحد هؤلاء الرجال يتقدّم نحو الشاب الأسود، يكلّمه بعنف ثم يمسكه من رأسه ويبدأ يرطم بقوّة جمجمة الشاب الأسود على الواجهة الزجاجية، ويشتدّ صراخ الشاب، وينكسر الزجاج. وينتهي الشريط ويظهر المذيع معلّقاً على الحادثة...
كان هشام ينظر إلى الشاشة مفجوعاً هو أيضاً، متعاطفاً بعمق مع الشابّ الأسود. ثم، وفي نهاية البرنامج، التفت إليّ قائلاً: هناك الآن متابعة قضائية لهذه الحادثة. واستطرد: أحد الجيران وثّق الحادثة من شرفة بيته. هذه الكاميرا الخفيّة هي بداية المراقبة المدنية والمحاسَبة.
وتذكّرت كيف تحوّلت هذه الكاميرا الخفية في التلفزيون التونسي، على أيام بورقيبة وبن علي، إلى مسخرة، إلى برنامج هزلي هابط، إلى سلاح في يد السلطة لهدم صورة النخب السياسية والثقافية وتسفيهها، وصولاً إلى شلّ دورها النقدي. فكانوا يأتون بالمثقّف ــ رسّاماً أو سينمائياً أو كاتباً ــ ويضعونه في ورطة، ويقدّمونه للمجتمع في شكل كاريكاتير، بل كراكوز؛ باختصار: يهدمون صورته. هو نوع من الإعدام المعنويّ يُنجزه موظّفو الإذاعة والتلفزيون ممّن لا علاقة لهم بالثقافة، كشأن مَن يشتغل في المؤسّسات الرسمية...
قبل العشاء أخذني هشام، إذاً، إلى مكتبه، نزلنا إلى القبو حيث المكتبة وطاولة العمل. أتذكّر قاعةً مستطيلة وجدراناً مكسوّة بالكتب، وفوق منضدة العمل صورة، بورتريه صغير بالأسود والأبيض لجدّه.
* شاعر ومترجم وناشر تونسي