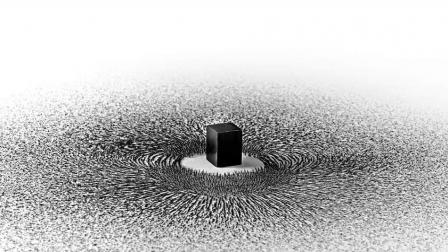لا يطرح البشر على أنفسهم سؤال المصير، أو الهوية البشرية، إلّا في الأوقات التي تهدّدهم فيها الطبيعة. بينما تراهم في زمن الحروب، يمجّدون القوّة، والسلاح، والمقاومة، والنضال، والثورة. ذلك أنّ الناس هُم أنفسهم من يتسبّب بكلّ ذلك، فالحرب، ليست مصادفة، بعكس الزلازل، ولهذا فإن لدى كثير من البشر القدرة على كتابة ما يمجّدها.
ولأن تهديد الطبيعة يخلو من الهدف، أو الغاية، إذ إنّ حركة الزلازل، والبراكين، والهزّات الأرضية، والتسونامي، وأمواج البحر، وفيضانات الأنهار، لا تشتغل على مقياس الأخلاق، أو الأفكار المتصارعة، أو الأيديولوجيات، أو رغبات التوسّع، أو أطماع الاستعمار، أو برامج الأحزاب، وإنما وفق قواعدها الخاصة، الخالصة، التي يسعى بنو الإنسان، بجهدٍ حثيث، لفَهم، أو معرفة، حركتها، ومحاولة درء الأخطار واحتمالات الدمار التي تتسبّب بها.
ينقسم الناس في المقابل إلى جهتين: الأولى هي التي تتجسّد في الأدب بـ"الشيخ والبحر" مثلاً لهمنغواي، أو "آن له أن ينصاع" للروائي السوري فارس زرزور، والثانية يمثّلها الإنسان العادي الذي يجد نفسه مكشوفاً عارياً أمام طبيعة عنيفة، فيعتريه ذلك الشعور بالضآلة، بالعجز، وانعدام القدرة على فعل أي شيء يمنع أعمال التدمير التي تحدث بسبب أي كارثة من كوارثها، يتبع ذلك نوع من "الحكمة" التي تدعو البشر جميعاً إلى نسيان الصراعات، والحروب، وأعمال التدمير والتخريب.
لا يملك أن يفعل شيئاً سوى انتظار أملٍ ما لا يعرف ما هو
في قصة عبد السلام العجيلي "النهر سلطان" (من مجموعة "الخائن") يقدّم الكاتب لنا وجَهي المواجهة، إذ يعيش مبروك وهو الشخصية الوحيدة في القصة، في واحدة من القرى التي تُجاور نهر الفرات بجانب مدينة الرقّة، في ذلك الزمن الذي كانت فيه مياه فيضان الربيع تغمر الأراضي الزراعية، وتقتل الناس، والمواشي؛ ولهذا أطلقوا عليه "النهر سلطان". شعور بالضعف وعدم القدرة على فعل أيّ شيء تجاه الطبيعة التي كان يمثّلها ذلك النهر في فيضانه الرهيب، يجعلهم يحاولون تعزية أنفسهم عبر الاعتراف بقوّته، ومَنحه تلك الصفة التي تماثله مع السلطة التي يمثّلها هذا الاسم.
لا تُماري القصة في هذا الشأن وهي التي تقدّم لنا عناصر هذا التفسير. غير أن مبروك هذا يخسر ابنه الوحيد رمضان في أحد فيضانات النهر، ولا يملك أن يفعل شيئاً سوى انتظار أملٍ ما لا يعرف ما هو. أين الأمل؟ إنه بحسب قصة العجيلي كامنٌ في قدرة الإنسان، بعِلمه وإمكانياته، في الحدّ من قوة عناصر الطبيعة التدميرية. وبفضل المصادفة يشتغل مبروك العجوز، وعمره واحد وثمانون عاماً، حارساً لمعسكر المهندسين الذي يضعون المخطّطات لبناء سد يمنع النهر من الفيضان، وسوف يموت راضياً، وقد بات يعلم أن السد سيكون سوراً طويلاً عريضاً ترتطم وراءه أمواج الفرات. لن يعود النهر سلطاناً بعد ذلك، بل خادم مُطيع، كما تقول القصة، عبد للإنسان يحبسه أو يطلقه.
تغلب على موقفنا من الطبيعة عاطفتان: الخوف أو الحب، أمّا الخوف فإنه ناجم عن لحظات العجز تُجاه قواها العاتية المدمّرة، وأمّا الحب فهو تعبير عميق عن لحظاتنا الأُولى هنا، وهي أننا كنا، وسوف نبقى، أبناءها.
* روائي من سورية