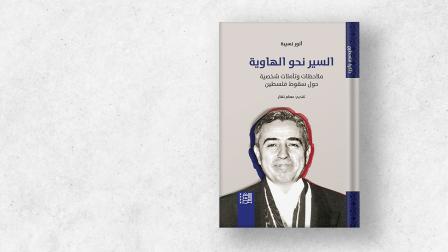كان يصطحبني معه عند ذهابه للتعزية، فنحن هنا في هذه القرية نملك تقويماً خاصّاً بنا، نملك أياماً للحزن، وأياماً للفرح. ورغم قلّة الأخيرة، إلّا أننا لا نملك حرية الفرح أو الحزن بمفردنا؛ نحزن معاً ونفرح معاً. كلّ ذلك يجري عبر تقويم سنوي للقرية، وفي أيّام الحزن الطوال كنا نذهب لتلك التعازي، والتي لم تكن مشاعة ولا سرّية؛ كان أمراً بين أمرين، ففي الفترة التي كان يقودنا حاكم ديكتاتور - حسب وصف والدي له - كان يُحظَر أن تُشاع التعازي، لكنه أيضاً لم يكن ينوي أن يمنعها للأبد. لذا اقترح أن تكون بطريقة مواربة، حيث يعتلي القارئ منبراً في بيت معروف، يقطن في الضفّة الأخرى من النهر، بينما يتكدّس المعزّون في الظلام على الضفّة المقابلة بين الحشائش وأشجار الصفصاف. ومع علم رجال الشرطة بتخفّينا بين الحشائش تلك؛ إلّا أن هناك ما يشبه العقد الاجتماعي الخفيّ بين الطرفين، حكومة الدكتاتور ونحن الذين لم نتمرّد بعد.
كنت أذهب مع أبي هناك وأسمع تلك التعازي وأرى الناس يبكون في آخر ذلك المونولوغ، إلّا أنني لم أكن أستطيع البكاء، وأبرّر ذلك بصغر سني وبحداثة منابع الدمع في مقلتيّ. ولم يكن يُشكّل ذلك لي حرجاً، لأننا حينما ننتهي من التعزية ونكون قد خطونا عدّة خطوات باتجاه الشارع المضاء، تكون آثار البكاء قد اختفت عند كلّ الناس. وحين يسألني والدي عما إذا كنت قد بكيت أو لا، أجيب بـ"نعم"، طمعاً بالآيس كريم الذي سيكافئني به. لكنّ ما حدث بعد ذلك كان مفرحاً لأبي وللناس لكنّه مضر بي، فقد سقط الديكتاتور وصاروا يسحلون تمثاله في الشوارع، ويتبوّلون فوق صوره الجدارية، وذلك ما أتاح للناس أن تجري التعازي تحت الأضواء الكاشفة، داخل قاعات مضاءة ومبرّدة، وهذا ما أدخلني في اختبار عصيب. ففي لحظات المونولوغ الحزين يُخبّئ الناس رؤوسهم بين رُكبهم ويصيرون ينوحون نوحاً عميقاً، وأظنُّ أنك كلّما بكيت أكثر ملكت مكاناً اجتماعياً أكثر أهمّية، فحينما كانوا ينتهون من حفل البكاء هذا، كثيراً ما افتخروا بآثار البكاء التي تظهر على وجوههم.
ظلّت محنتي أنني لا يمكنني البكاء على أيّ شيء حزين، ولا أعتقد أن الموضوع مرتبط كثيراً بفهمي للمونولوغ أو بعدم اكتراثي بجريمة قد حدثت قبل ألف عام من الآن، رغم أننا ـ والحمد لله ـ امتلكنا مجازر حقيقية وأكثر وقعاً للإهانة والمرارة من تلك التي حدثت قبل أن يكون جدي السابع عشر قد وُلد.
اقتلع الجندي الأميركي نافذة المدرسة وتركنا نسرق أثاثها
كنتُ أحاول أن أدعك عينيّ بأن أدخل فيها متعمّداً بقايا عطر أو تراب، أيَّ شيء يحفّزها على البكاء، إلّا أنها لا تُبدي أيّ استجابة تُذكر.
وحينها عرفتُ أنني لا أبكي، وحتى اللحظة يمكنني أن أحصي الكثير من المواقف التي كان يتوجب عليّ بها البكاء، إلّا أنني وقفت بارد الدمع واليدين أطالع المواقف الحزينة وهي تمرّ؛ لم أبكِ قتل أخي أو ترك حبيبتي لي، ولم أستطع مواساة صديقي عندما فقد عائلته بالكامل؛ لم أحزن على خسارات منتخب الكُرة الوطني، ولم تنزل دموع الفرح في لحظات القبض على الدكتاتور المختبئ في الحفرة، ولا عندما انتصر شيخنا بمناظرة مع فرقة دينية أخرى مضادّة.
لكنّني أذكر أنني قد بكيت مرّة واحدة في حياتي، مرّة غير مفهومة وليست مقبولة التفسير عندي أو عندكم. ورغم أنّني لم أكن أملك وعياً سياسياً بما يحدث ـ وأظنّني لليوم لم أحظَ به ـ لكنّني أذكرها، تلك اللحظة، جيداً؛ يوم حدث عطب في صدري وتقرّحت معدتي ثم فجأة انسكب الدمع حارّاً على وجهي. أذكرها تلك اللحظة التي يسمّونها لحظات الديمقراطية، حين ربط الجندي الأميركي الحبل بنافذة إدارة المدرسة ومن طرفه الثاني أوثقهُ برأس الدبابة، ثم راح يسير بعيداً عن المدرسة حتى اقتلع النافذة من مكانها، وتركنا نسرق أثاثها.
نعم، أذكرُ تلك اللحظات، بثّوا مقاطع منها في التلفاز، وأذكر أنهم قالوا إننا حديثو العهد مع الديمقراطية.
* كاتب من العراق
** القصة من سلسلة قصصية بعنوان "لو أنني منعتُ الديمقراطية من أن تركب على ظهر الدبابة" تصدر العام القادم