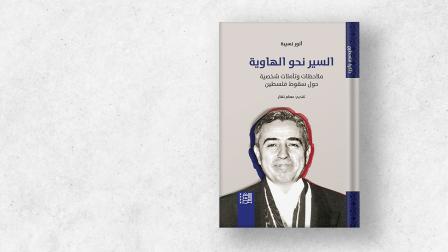كان الشاعر الإنكليزي ت. س. إليوت يضيق بـ القارئ المتعجّل الذي لا يتأنّى في قراءة قصائده واستقصاء دلالاتها، حتّى أنّه صرّح ذات مرّة: "إنّني أتعب أكثر من عام حتّى أكمل قصيدتي، ولا أقبل بحال من الأحوال أن يقرأها القارئ وهو في الترام أو القطار... لقد خصّصت عاماً من عمري لإبداعها، فليخصّص ساعتين لفهمها".
يشير إليوت، بوضوح، إلى أنّ قصيدته لا تستسلم، ككلّ القصائد الحديثة، إلى قارئها بيسر، فهي تستدعي منه فسحةً من الوقت من أجل "فهمها" واستيعاب دلالاتها ومعانيها.
ومثلما أوضح الشاعر الإنكليزي في الكثير من مقالاته النقدية، فإنّ غموض القصيدة الحديثة يرتدّ إلى سببين يؤولان إلى سبب واحد: خروج هذه القصيدة عن كلّ ما استتبّ من أعراف لغوية وتقاليد شعرية، مؤسّسةً بذلك طريقتها المخصوصة في سياسة اللفظ وإجراء الكلام.
لكنّ غموض القصيدة الحديثة لا يتأتّى من طرائق القول فحسب، وإنّما أيضاً من مقول القول. فالقصيدة الحديثة قصيدة "مثقفة" ما فتئت تسترفد أسئلتها من حقول معرفيّة شتّى. وهذا يعني أنّ الشعر الحديث لم يعد يكتفي باستلهام الشعر في صياغة خطابه، كما كانت الحال في الشعر التقليدي، وإنّما أصبح يستلهم المعرفة الإنسانية، مطلق المعرفة الإنسانيّة. بعبارة أخرى، إنّ الشعر الحديث ليس نتاج عفو البديهة بقدر ما هو نتاج كدّ الرويّة.
فكيف للقراءة المتسرّعة، بعد كلّ هذا، أن تحيط بدلالات القصيدة الحديثة وتستكشف آفاقها التعبيرية والرمزية؟ نصّ إليوت يؤكّد أنّ الشاعر الحديث لا يرى في الشعر انسياباً تلقائيّاً للمشاعر أو فيض إلهام لا يخضع لحكم الإرادة، وإنّما يراه جهداً ومكابدة ومواجهة لمعضلة الكلمات. في هذا السياق، يدعو إليوت إلى أن تتحوّل القراءة، من جهتها، إلى فاعليّة إبداع وإنتاج تفضي إلى فتح النصّ على ممكنات دلالية جديدة.
بسببٍ من كلّ هذا، أدان إليوت "قراءة الترام أو القطار"، وهي القراءة المتعجّلة التي لا يمكن أن تحيط بالقصيدة الحديثة وتكشف عن غامض صورها ورموزها، داعياً إلى ضرب آخر من القراءة يمكن أن نسمّيها "القراءة المتأمّلة"، وهي القراءة التي تستغرق، كما أشار، وقتاً طويلاً من النظر والتدبّر.
لم نفتأ نستحضر تصريح إليوت مع كل مهرجان شعري عربي، يتعاقب فيه الشعراء على المنبر"ينشدون" قصائدهم. والسؤال الذي يلحّ في كلّ مرّة: ألا تكون طرائق تلقّي القصائد في المهرجانات (التي كان يصفها الناقد إحسان عباس بالأسواق العكاظية) شبيهة بطرائق تلقّي القصائد في القطار والترام؟
من المعروف أنّ الشاعر يقدّم قصائده في المهرجانات مشافهةً إلى متقبّل يتلقّفها عن طريق "جارحة السمع"، فهل يمكن لهذه التقاليد الشفوية أن تتيح للمتلقّي "استيعاب" القصيدة والإحاطة بمعانيها في ظرف وجيز؟ وهل "يمكن للسماع الواحد" أن يكشف عن أسرارها وخفاياها؟ وقبل كلّ هذا هل يمكن للقصيدة الحديثة أن تخضع للتقاليد الشفويّة وتستجيب لمراسم الإنشاد؟
لعل من الطريف أن نلاحظ أنّ شعراء المهرجانات بدل أن يستدركوا على هذه التقاليد أو يتحفّظوا عليها جنحوا إلى تغيير قصائدهم بما يتلاءم وطقوس المشافهة. هكذا وجدنا هؤلاء الشعراء يعمدون، كلّما اعتلوا المنابر، إلى قراءة نمط مخصوص من القصائد تستجيب لطقوس الإنشاد وتقاليد المشافهة، ومن أهمّ هذه التقاليد وتلك الطقوس إيثار الوضوح وإقامة الوزن وعقد القوافي واستخدام التكرار. فكلّما تعدّدت هذه العناصر كان طريق القصيدة إلى المتلقّي آمناً واستغراقها للأسماع كاملاً.
وبسبب هذا ارتدّت قصيدة المهرجانات إلى ما كان الشعر العربي الحديث قد ثار عليه وادّعى تجاوزه، ونعني بذلك التقاليد الشفاهيّة؛ فالحداثة الشعرية قامت على تغيير نمط تلقّي القصيدة الشعرية من خلال تغيير أسلوب كتابتها وطرائق تصريف القول فيها، أي أنّ الحداثة الشعرية عمدت إلى تجاوز شفوية هذه القصيدة من خلال تجاوز عناصرها الإيقاعية التقليدية من بحور وقواف وتكرار، إضافة إلى تجاوز عدد من صورها البلاغية وزخارفها البديعية التي ارتبطت بالتقاليد الشفوية القديمة، مستبدلةً أداة التلقّي المألوفة بأخرى جديدة، فبعد جارحة السمع بات المتلقّي يستقبل القصيدة الحديثة عن طريق جارحة النظر، فالقصيدة الحديثة قصيدة بصريّة تحتاج إلى تأمُّل ومعاودة وطول نظر، ولا يمكن بأيّة حال "استيعابها" من سماع واحد أو سماعين اثنين.
ولعلّ من المفيد أن نعرّج على موقف نزار قباني من تقاليد المشافهة في الشعر العربي، فإذا كان الإجماع معقوداً بين شعراء الحداثة على رفض هذه التقاليد، فإنّ قباني كان من الشعراء القلائل الذين دافعوا عنها بحماسة واعتبروها أصلاً مكيناً من أصول الشعر العربي لا يجوز إهمالها أو التخلّي عنها؛ فهو يقول: "الشعر في الأساس صوت، وهو في شعرنا العربي، خاصّة، مخزون في حنجرة الشاعر وأُذن المتلقّي. فالصوت إذنْ قدر القصيدة وخيمتها". ظلّ قباني متشبثاً بالقصيدة/ الصوت والقصيدة/ الإنشاد، فيما دافع مجمل شعراء الحداثة العربية عن القصيدة/ النص والقصيدة/ القراءة.
ومهما يكن من أمر، فإنّ شعراء المهرجانات ساروا على نهج نزار قباني حتّى وإن ادّعوا عكس ذلك. وقد لا نعدو الصواب إذا قلنا إن هذه المهرجانات كانت سبباً مباشراً في بعث القصيدة العمودية من رمادها، فالقصيدة العمودية هي قصيدة المهرجانات والمنابر دون منازع، لأنها من القصائد التي تعوّل على انتظام الأصوات وانسجامها في بناء أبياتها وصياغة لغتها. فوحدة وزنها وانتظام قافيتها وتكرّر رويّها من شأنها، مجتمعة، أن تُميل نحوها القلوب وتصرف إليها الوجوه وتستدعي إصغاء الأسماع إليها على حدّ تعبير ابن قتيبة.
بعبارة أخرى، نقول إنّ المهرجانات فرضت قانونها الخاص على الشعراء، والمتمثّل في الاستجابة إلى أفق انتظار المتقبّل والخضوع لشرائطه المجحفة، حتّى تحظى القصيدة بحسن القبول. وهذا القانون يناقض، في أصل جوهره، قانون الكتابة الشعرية القائم على العدول عن هذا الأفق من أجل تأسيس أفق انتظار جديد.
حتّى قصيدة النثر التي تعدّ عدولاً كاملاً عن قوانين القصيدة التقليدية إيقاعاً وصورة حملت، هي الأخرى، في الكثير من نماذجها آثار المهرجانات وانعكاساتها السلبية، فبات بعضها ذا طبيعة "منبرية"، وتمحّل بعضها طرائق في الإلقاء منغّمة ليمنحها الإيقاع والنظام.
كلّ هذا يؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ الشفاهية قد عادت لتفرض قوانينها على جانب من المدوّنة الشعرية الحديثة، محتفيةً بأدبية المنطوق على حساب أدبية المكتوب، وبالقصيدة المسموعة على حساب القصيدة البصرية.
* شاعر من تونس