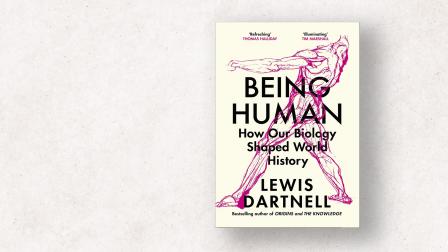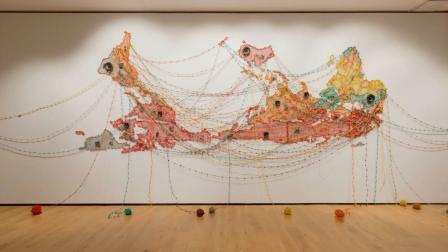منذ اختياره بدايةً الاشتغال على السرديات دون غيرها، ثم انحيازه إلى مرجعية سيميائية، بدا أن عبد اللطيف محفوظ يسعى إلى اجتراح مسار متمهّل يجمع بين نحت المفاهيم واستيعابها، وحسن تطبيقها على نصوص روائية عربية، مع مساءلة داخلية دائمة للتجديد، وقد أثمر هذا المشروع اهتماماً مباشراً بقضايا نقدية محدّدة، كوظيفة الوصف وهو الاهتمام الذي حمله كتابه الأول "وظيفة الوصف في الرواية"، ثم البناء والدلالة وهو ما ضمّنه كتابه "البناء والدلالة في الرواية"، وبعدهما انصرف إلى "آليات إنتاج النص"، ثم "سيمائيات التظهير".
هذا المشروع يقدّم مداخل عديدة لمناقشته والاهتمام به، يحضر فيها متن الاشتغال، بنفس القدر يحضر فيها القارئ ومسارات النقد العربي. وفي لقائنا بـ محفوظ كانت الحاجة ملحّة للاطمئنان على واقع النقد العربي والمغربي ومساراته، الذي يبدو وكأنه يعيد -رغم حركيته- أسئلة العقود الماضية كإشكال توحيد المصطلح النقدي، وإشكال الترجمة، وترديد نظريات غربية دون سياقات مناسبة.
يرى محفوظ أن "النقد العربي حقّق طفرة نوعية، وراكم دراسات حاولت تمَثُّل خلفيات المناهج الغربية النظرية، إلى جانب دراسات تطبيقية حاولت جعل تلك النظريات خلفيات لمقارباتها. بيد أن هذه الدراسات ظلّت محكومة بالتبعية المطلقة للأصل الغربي؛ لذلك، كلما حاول بعضهم ممارسة نوع من التميز، عبر الإضافة أو التحوير، سقط في التوفيقية. ولأن التصرف محكوم بوجود أصل، فإن هذه الدراسات تحاكم، ليس انطلاقاً من تميزها، أو جهة الاجتهاد فيها، بل من جهة تمثّلها الدقيق للأصل، وشكل وفائها له".
يضيف: "من الواضح أن الاستناد إلى هذا المعيار، يجعل المحاولات الجادّة الواعية بحقيقة فعلها، خاضعة للحكم نفسه الذي نصدره على الأعمال التلفيقية، المؤسَّسة على قراءة مراجع تفسيرية للنظريات. إن هذا الوضع الذي تغيب عنه الأصالة، بالضرورة، يجعل النقد في أزمة دائمة، سواء على مستوى تمثل النظريات، أو على مستوى تمثل المفاهيم والمصطلحات. وهو الذي يقود إلى القول "إن سجالات البداية ما زالت حاضرة، وهذا موضوعي، لأن التوصيف النظري، وهو يترجم، يصبح محاصراً في اللغة الهدف بسياق ثقافي خاص بهذه اللغة؛ أما المفهوم، مهما كان الدليل- الهدف الذي يترجم إليه، فإنه يظل، في الحقيقة، مجرد تأويل ممكن للدليل المصدر. لذلك يُنْتَقَدُ، ومن خلاله يُنْتَقَدُ التوصيف النظري برمته".
يتابع "بناء على هذا، أظن أن على النقد العربي أن يحاول تناسي ما رسخته الكتابات الأولى، التي ساعدها السبق الزمني على تكريس ترجمات غير دقيقة، وعلى تبسيط التوصيفات النظرية، وأن يحاول الاستفادة من هذا التراكم، ومن غياب اجتهادات غربية لافتة لإعادة فهم أهم النظريات، وإعادة ترجمة أهم المفاهيم. ويمكن للنقد العربي -بعد هذه المرحلة- أن يجد سبلاً لبناء أنموذجات نظرية ملائمة لطبيعة ثقافته ونصوصه وأهداف مجتمعاته".
كتابات النقاد الذين تصنّفهم الصحافة عادة بالكبار، غالباً ما تنحاز إلى نصوص معروفة لأسماء مكرّسة، وهي كتابات توجِّه القارئ الذي يبحث عن طرق مختصرة للنصوص الجيدة، لكن هذه الاختيارات تُهمل نصوصاً كثيرة جيدة لكتّاب جُدد.
"اسمح لي، بالتعقيب على مفهومي الناقد الكبير والكتاب النقدي" يقول محفوظ، ثم يشرح "أولاً الناقد الكبير ليس هو الذي يكون سبّاقاً لاستعارة النقد الغربي وترجمته بتصرّف، أو الذي يقترض تحليلات مدهشة غربية، ويبحث لها عن نصوص مشابهة في العربية، سواء أكانت أدبية أم ثقافية، (والتاريخ سيكشف كل هؤلاء)، وليس هو الذي يصدر كل سنتين كتاباً انطلاقاً من مراجع مختلفة عن مراجع الكتب السابقة. الناقد الكبير هو الذي يحمل مشروعاً نقدياً مؤسساً انطلاقاً من وعي فلسفي بالظاهرة الأدبية، ويستطيع كشف البنى العميقة للنصوص، التي لا يستطيع غيره الوقوع عليها. أما الكِتاب النقدي فليس هو الكتاب التجميعي لدراسات قُدّمت في مناسبات علمية، ووُضعت لها مقدمة تبرر اجتماعها بين دفتي كتاب؛ بل هو الذي يصبح علامة في مسار النقد، ويقترح استبدالاً مؤسساً، ويدعمه بتحليل منتج موسوم بالعمق والجدة، يستعصي على التفنيد بالمعنى الإبيستيمي".
أما انحياز النقاد، عامة، إلى نصوص معروفة، فبحسب صاحب "سيمائيات التظهير": "يعود إلى أسباب، بعضها ذاتي، وبعضها موضوعي. من بين الأسباب الموضوعية صعوبة المتابعة نظراً لكثرة النصوص، والرغبة في تحقيق التواصل مع القارئ، لأن النصوص المكرّسة والمعروفة يفترض أنها حاضرة في ذهن القراء، والظن بأن النص المتفق على أنه جيد يسعف النقد. لكن من المؤكد أن النقاد، تحت إكراهات ليس مجال تفصيلها هنا، لا يقومون بواجبهم في البحث والتنقيب الذي يعد مرحلة أساساً".
المشروع النقدي لـ محفوظ، اختار منذ بدايته الاشتغال بآليات تداولية سيميائية، وقّدم هذا المشروع النص الروائي كما هو الحال في "البناء والدلالة في الرواية؛ مقاربة من منظور سيميائية السرد" و"آليات إنتاج النص الروائي؛ نحو تصور سيميائي" على أجناس أخرى. مما دفعنا للاستيضاح حول أمر هذا الاختيار.
يقول الناقد المغربي: "لم أكن، وأنا طالب، أهتم بالرواية، كنت مثل الأغلبية أتوهم أن الإبداع الحقيقي هو الشعر، وأنجزت بحث التخرج حول ديوان "عينان بسِعة الحلم"، لكنني، حين التحقت بالدراسات العليا، نصحني أستاذي محمد برادة بأن أهتم بالرواية، واقترح علي البحث في الوصف، وكانت تلك البداية. وقد وجدت نفسي في الدراسات السردية الشكلية والموضوعاتية. بيد أن ذلك لا يعني أنني مختص في نقد الرواية، بل أعدّ نفسي باحثاً في قضايا تحليل الخطابات، انطلاقاً من مرجعية ثابتة هي السيميائيات. فلدي دراسات متعددة حول أغلب الأجناس الأدبية والثقافية، وكلها تنطلق من الخلفية النظرية نفسها. وحين ستصدر لي سلسلة من الكتب التي تجمعت بدءاً من بداية الألفية الثالثة، ستبدو التجربة متكاملة تضم كتباً تغرف من الخلفية النظرية نفسها، وتتناول معالجاتها الإجرائية عدداً من النصوص المنتمية لحقول خطابية مختلفة، بما في ذلك البصرية والشعبية".
هناك خاصية مهمة يلاحظها المتتبّع لهذا لمسار النقدي، وهي المزاوجة بين المعرفة النظرية والتطبيقية، كل كتابات محفوظ، تحمل تقريباً نفس المنحى النظري ثم التطبيقي. يشرح هذا الأمر: "منذ البداية اقتنعت أن تحليل النصوص يقتضي الاستناد إلى نظرية يقتنع بها الباحث ويتمثلها، ثم يتمثل المقاربة التي تصدر عنها، وبعد ذلك إما أن ينحاز إليها، عن قناعة، أو يحاول اقتراح استبدال مؤسس عليها يترجم تصوراته الجمالية والمعرفية والإيديولوجية. كما اقتنعت بأن الاكتفاء بصوغ التوصيف النظري فقط ليس كافياً، لأنه فعل مجرد، وقد يتضمن نوعاً من الهروب من تجريب قوة وصوابية المقترح. لذلك أعمل دائماً على أن أكون أول من يحاول تطبيق ما أقترحه. وكما تعلم، فأغلب النقاد يقدمون توصيفات نظرية أقوى بكثير من تحليلاتهم التي تبدو، أحياناً، في غير حاجة إلى كل تلك التوصيفات؛ لذلك أعتبر اهتمامي بالتحليل نقطة قوة في تجربتي المتواضعة.