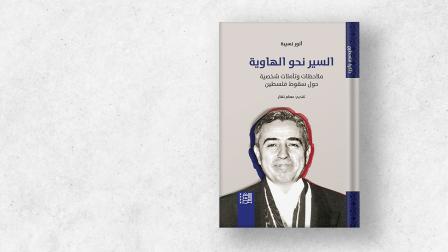زياد الرحباني (Getty)
يشكّل الإعلان عن بدء العرض السينمائي لمسرحية "بالنسبة لبكرا شو؟" (1978) في صالات سينمائية لبنانية عديدة، محطة أساسية تدفع إلى التأمل في أكثر من مسار حياتي ـ مهني لزياد الرحباني أولاً، ولنتاجاته المسرحية والغنائية ثانياً، ولمواقفه السياسية اللاحقة، المنحازة إلى طغاة متشابهين في أعمالهم الدموية، من ستالين إلى بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني ـ الإيراني، ثالثاً. فاليساري "المكافح" ـ فنياً ـ ضد سطوة الرأسمال المتوحش، يتحول إلى رديف "ثقافي" لسلطان قائم على ديكتاتورية القمع الدموي والتسلّط العنفي. والمسرحي "الفطريّ" ـ المتوغل في أعماق الصراع الطبقي وأهوال الحرب الأهلية اللبنانية، والمتمرد على سلطة الأب، والمنقّب الدقيق في هنات الاجتماع والسياسة والاقتصاد والثقافة في لبنان من منطلق يساري ثوري متمرد ـ لا يتردد في إيجاد تبريرات مختلفة (وغير مقنعة لكثيرين يختلفون معه في الرأي السياسي) لمن يمارس شتى أنواع القتل والخراب. أما الملحن وكاتب الأغاني والحوارات المسرحية الخاصة بأعماله ـ المثابر في اجتهاد يذهب في ابتكار أنماط موسيقية وكلمات شعبية تصيب حساسية المتلقي، وتضعه في مواجهة ذاته عبر صفاء الأغنية الرحبانية وموسيقاها ـ لا يأبه بأحد لا يوافقه في مساراته المختلفة، لارتكازه على مدى شعبي لحضوره الطاغي في النفوس والعقول والانفعالات، مفضّلاً الطاغية على الناس "الغلابة" والصادقين والشفافين، بحجج واهية يتغاضى عنها كثيرون لـ"شدة" حضوره هذا في الوجدان والانفعال والذات.
ذاكرة حرب وإبداع
أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990)، يتماهى لبنانيون كثيرون في المناطق كلّها ـ الغارقة في الدم والتدمير والتهجير والعزلات الطائفية ـ بزياد الرحباني، مسرحياً وغنائياً وموسيقياً. اقترابه من العامل والفلاح والفقير والطالب والفرد عامل مساعد على انتشار أعماله لدى شريحة كبيرة من المواطنين الساكنين في "الجغرافيات" اللبنانية المتنازعة في ما بينها، وداخل حيّزها المكاني أيضاً. تمرده الباكر على الأهل والعائلة (ابن عاصي وفيروز، وابن شقيق منصور، الثلاثيّ الرحبانيّ)، وانفضاضه عن المنطقة المولود فيها بسبب التزام سياسي ثقافي يساري مناهض للمنطقة تلك، وتقديمه أول مسرحية له بعنوان "سهرية" (1973) قبل عامين من اندلاع الحرب الأهلية، مرتكزات جوهرية لبناء علاقة متينة بينه وبين أكثر من جيل، يغلب عليه الطابع الشبابي.
"بالنسبة لبكرا شو؟"، تندرج في السياق هذا، وأشرطة الـ"كاسيت"، المتضمّنة أغنيات مختلفة في شؤون الحياة اليومية، بمفردات شعبية بسيطة تحتمل عمقاً ثقافياً وإنسانياً وفكرياً مهمّاً، درب وحيد لكثيرين إلى الرحباني الابن، تماماً كأشرطة الـ"كاسيت" الأخرى لمسرحياته المنشغلة بهموم الناس ومآزق عيشهم وأحلامهم الموؤودة وأوهام خلاصهم المعلّق. أما الذين يُشاهدون مسرحياته أثناء عروضها، إبّان الحرب نفسها، لا يزالون يحملون في ذواتهم أجمل ذكريات عن مراحل مختلفة من أزمنة ماضية، يؤمنون أنها منتهية.
تتفرّد "سهرية" عن سائر الأعمال المسرحية اللاحقة بها، ليس فقط بكونها أول عمل مسرحي لزياد الرحباني، بل أيضاً وأساساً بابتعادها عن كل خطاب سياسي ـ إيديولوجي يلتزمه الرحباني الإبن، ويجد في مسرحياته اللاحقة بها صدى واسعاً: "نزل السرور" (1974)، تروي وقائع من يوميات أناس مهمشين يريدون إما ملاذاً أو خلاصاً، فإذا بهم يجدون أنفسهم في قلب ثورة معطلة، وخيبة مؤلمة، وخراب مديد. "بالنسبة لبكرا شو؟"، تدخل في "جوانية" الخراب النفسي ـ الروحي في ذوات أناس عاديين، ضمن سرد مبطّن لمقتطفات من صراع طبقي، وسلطة رأسمالية، وتحول كبير لبيروت إلى "ملهى ليلي" لمتع يريدها عرب وأجانب. "فيلم أميركي طويل" (1980)، يبين خراباً وأهوالاً ومصائب تُفرزها الحرب اللبنانية، مدمرة الناس جميعهم، نفسياً واجتماعياً وإنسانياً. أما "شي فاشل" (1983)، فانتقاد حاد لأعمال الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، ولمعنى التراث والقرية اللبنانيين، ولتركيبة لبنانية اجتماعية وثقافية يعتاد الأخوان نفسيهما ترويجها في مسرحياتهما وأغانيهما وأفعالهما.
صراع طبقي ورداءة تقنية
بعيداً عن هذا كله، يدفع العرض البصري لمسرحية "بالنسبة لبكرا شو؟" إلى استعادة مضمون إنساني لصراع دائم بين جانبين متناقضين، ولسرد سلس ومبسّط لأهوال الصدام اليومي بمشقات العيش وهمومه، ولقولٍ مشبع بحساسية الالتزام الفكريّ بقضايا الناس العاديين، الذين يجد لهم في ملهى ليلي مساحة للانكشاف العفوي والبسيط، الذي يعبّر عن قسوة الحياة وتمزّقات العيش وخرابهما. العرض نفسه يدفع أيضاً إلى تبيان البقعة الثقافية التي ينطلق منها زياد الرحباني سابقاً، قبل أن ينخرط في معسكر الطغيان، ويجعل ذاته مدافعاً شرساً عن البطش والقمع.
فـ"بالنسبة لبكرا شو؟" تبقى إحدى أجمل مسرحياته وأكثرها تعبيراً صادقاً عن الوحش الرأسمالي المتسلط على البسطاء الطامحين إلى حد أدنى مقبول من عيش هادئ وطبيعي، وعن رذالة الفقر وقسوته، وعن جوانب إنسانية لمهمشين يسعون إلى هناء مفقود، وسلام داخلي مؤجل.
زكريا (زياد الرحباني) يعمل نادلاً في مقهى وسط شارع الحمرا البيروتي. زوجته ثريا (نبيلة زيتوني) تساعده في العمل، ولا تتردّد عن "مرافقة" أجانب من أجل "حفنة من المال". الملهى نموذج للمدينة، والعاملون فيه انعكاسات بشرية لحالات وأشخاص، والعلاقات القائمة فيه امتداد لأحوال البلد ومساراته. يريد زكريا تحسين عيشه، فيصطدم بوحش المال وأصحابه. الحياة الليلية متعبة، والعمل في فندق جديد سيشيّد في إحدى الدول الخليجية يمكن أن يكون نوعاً من خلاص (مالي على الأقل) له ولعائلته، لكنه يرفض السفر كلّياً. المحيطون به ليسوا أفضل حالاً، وبعضهم لا يتردد عن الكذب والخديعة والاحتيال من أجل كسبٍ ماليّ ما. يسهرون ويشربون ويجلسون معاً، ويستمعون إلى أغانٍ ينشدها رامز (الراحل جوزف صقر)، ابن خالته، بصوته البديع المنسحب على الحب المعطل، والبساطة الإنسانية العميقة بكشفها انفعالاً وحيوية وخوفاً وقلقاً.
هذا كله حسن. لكن العرض البصري ليس سينمائياً، لأن التصوير (شقيقته الراحلة ليال)، المعتمد حينها، يبقى منتوجاً عادياً لهواة لا يملكون إمكانيات تقنية تتيح لهم التقاط العمل وروحه ونبضه ومساراته وأعماقه الدرامية والجمالية في آن واحد. ذلك أن المشاهدة البصرية هذه معقودة على مقاطع مسرحية مصورة على مراحل مختلفة، "بهدف مساعدة المخرج والممثلين خلال التمارين"، إذْ لم يكن مقرراً عرضها أبداً، كما يردد مسؤولون في شركة الإنتاج السينمائي للمسرحية. يُضيف هؤلاء أن الرحباني الإبن يلمح أمامهم، قبل سنين مديدة، "إلى اعتماده تصوير مسرحياته لمراقبة الأداء، كونه يشارك في التمثيل، وبغياب مخرج يتولّى مراقبة العرض، وتدوين الملاحظات". غير أن المصوَّر غير كافٍ أبداً لتحويل المسرحية إلى شريط يُراد له أن يكون سينمائياً، في حين أنه بالكاد يمكن اعتباره بمثابة شريط "فيديو منزلي" رديء الصنعة.
لذا، يتساءل البعض عن سبب قيام شركتي الإنتاج اللبنانيتين بمغامرةٍ كهذه: أهي رغبةٌ في تحقيق أرباح مالية طائلة، بالاعتماد على السمعة الطيبة والحسنة للمسرحية، وعلى حضورها الطاغي في الوجدان والذاكرة، وعلى قدرتها ـ بسبب هذين الحضور والسُمعة معاً ـ على جذب مشاهدين كثيرين؟ أم أنها مجرد "عمل ثقافي" لتحصين بعض التراث الفني ـ الثقافي اللبناني من الاندثار؟
يتساءل البعض أيضاً، عشية بدء العروض التجارية للشريط المصور: هل يتغلّب النص المسرحي الأصلي على الهنات التقنية الفادحة في العملية الفنية المتكاملة للترميم، فينتصر العمل القديم على حداثة التكنولوجيا، وتجذب "بالنسبة لبكرا شو؟" أناساً كثيرين يتملّكهم فضول الاطّلاع والمشاهدة، وحنين زمن ماضٍ وجميل؟
اقرأ أيضًا : عن سينما عربية جديدة نصنعها مخرجات شابات
(كاتب لبناني)