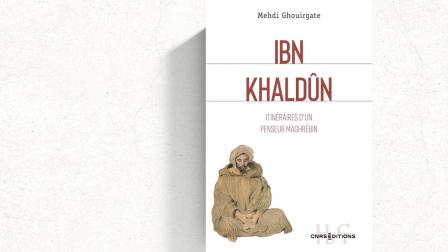ربما كان الشاعر، عمر أبو ريشة، قد استمد الصورة، أو الاستعارة، في بيت الشعر الشهير: "تقضي الرجولة أن نمدّ جسومنا/ جسراً فقل لرجالنا أن يعبروا"، من عالم النمل. وربما أراد أن يقدّم هذه الأمثولة ليتعلّم منها الأفراد بين البشر معنى التضحية. وقد فتنت أجيال من الفتيان والشبّان العرب بهذا البيت، ويمكن أن يكون عدد منهم قد نفذوا عمليات تضحية آملين أن يكونوا قد حققوا مقتضيات الفداء الرجولية.
وطوال عدة عقود من القرن العشرين سادت نغمة التضحية والفداء في الأدب والحياة العربيين. كان المأمول من ذلك كله أن تكون التضحيات مجدية في تحقيق أحد أمرين: إما التحرر من الاستعمار، أو التحرر من القهر والاستغلال. والظاهر أن التضحيات راحت سدى حتى الآن.
ففي كل مناسبة يتمكن فيها الناس من الكلام عن الراحلين من بينهم، ترى أنهم يشيرون إلى الـ "سُدى" الذي منيت به أمنياتهم. ثمة أشكال لا حصر لها من التضحيات التي قدمها الآلاف من الأفراد العرب، دون أن يحظى أولئك الذين ظلوا أحياء من بعدهم بأي مكسب. وبدل ذلك راح كل جيل يسمي الجيل الذي سبقه: "جيل الخسارات"، وثمة من يسميه: "جيل الحسرات". حين يستبطن في التسمية الخسارة والرحمة معاً.
والمريع أن تتمكن القوى المسيطرة في السلطة من نشر قيم التضحية في أدبياتها أيضاً، والهدف عندها هو الدفاع عن مصالحها التي تضعها في صورة قيم عامة: الوطن والأمة والقومية. فيما يدعو قادة الأحزاب "الثورية" الفقراء للتضحية من أجل الخبز والحرية. ولكن كلتا الدعوتين، لا ترى في الحياة القيمة الكبرى التي يجب العيش - لا الموت - من أجلها. والمشكلة هي في أولئك الذين يمجدون التضحية، دون أن يكونوا مستعدين هم أنفسهم لدفع الثمن. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الضحية غريبة وبلا هوية وبعيدة عن التعاطف الوجداني.
يقتصر مديح الضحية بوصفها البديل، أو كبش الفداء. وقد ذبحت على الدوام من أجل أن يبقى آخرون. ولهذا يمكن أن ترى تماثيل الجنود وقد كتب تحتها "الجندي المجهول"، بينما تُمَجد أسماء القادة. لا يمكن لأحد أن يفحص ما الذي قد يفكر فيه أولئك الذين ماتوا أو ضحوا بأنفسهم من أجل أن يبقى الآخرون أحياء، أو تتحقق مطالبهم. وخاصة حين تختفي أسماؤهم، أو لا تحفظ في الذاكرة، أو الكتب.
وفيما لا تزال تنتعش هذه القيم في بلداننا الفقيرة المعذبة المحرومة من أبسط متطلبات العيش. فإن فنون الأدب قلما تلاحظ أنها لا تغذّي الحياة بهذه الدعوة، بقدر ما تخدم الحروب، وتشبع نهم صنّاعها.
ولا نتحدث هنا عن أولئك الذين يدعون للتضحية بوعود مستلّة من عالم الآخرة، بل عن وعود الأدب والفن. ما الذي يقدّمه بيت الشعر من وعود غير الوصف بالرجولة؟ وما معنى أن يكون الإنسان فحلاً بعد موته؟ غير أن السؤال الأهم هو: لِمَ لمْ يجد الأدباء لغة أخرى غير لغة الموت لحثّ الناس على البحث عن الحياة الحرة الكريمة؟