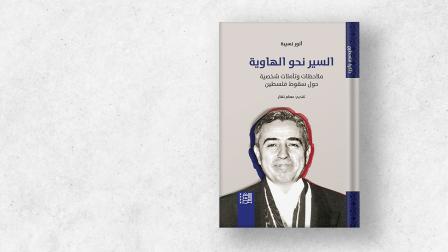مرّت مصر بأطوار مختلفة ومتعددة من الدعاة الذين ظهروا في سمائها، بل صاروا نجوماً. وقد تكون هذه النجومية التي تمتع بها بعض الدعاة نتيجة لسنوات من الكبت السياسي والقمع الفكري، منذ أن حوصر فيه المثقف المصري وصار مضيّقاً عليه حين يريد مطارحة الجمهور أفكاره، فيما انفتح الفضاء الإعلامي للشيخ والداعية ليخرج من المنبر في المسجد، إلى الساحات، والمنتديات، والاجتماعات العائلية.
وتطوّر الدرس الديني القديم من شكل حلقات تقام في الجوامع إلى ندوات يتم عقدها في فيلات الأغنياء وقصورهم، بل نُظّم بعض من هذه الندوات في أندية رياضية مشهورة. حتى وصلت مصر إلى مشهد "دجاجة عمرو خالد الوطنية" الذي أذيع مؤخراً، وتبعه الكثير من الجدل.
في العام 1970 فتح التلفزيون مجاله الإعلامي وقنواته للبرامج الدينية، فظهرت الإعلامية كاريمان حمزة، أول مذيعة في "ماسبيرو" ترتدي الحجاب، وتقدّم البرامج الدينية، وقدّمت من برنامجها "سيرة ومسيرة" وغيرها من البرامج، العديد من علماء الدين.
وفي العام 1971 ظهر للمرة الأولى الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي، مع الإعلامي أحمد فراج، في برنامجه "نور على نور" وكان ذلك إيذاناً بفتح المجال تماماً، وتحوّل الخطبة الإسلامية التي تلقى كل جمعة من أعلى المنبر، أو الدرس الديني الذي يقام في المساجد، إلى ظهور علني، بما يمنح الدعاة الإسلاميين حق الأداء العلني لأفكارهم، وتعدّى دور الدولة السماح لهم بالحضور الإعلامي بل بدأ الترويج لمتابعتهم والتشجيع عليها في سبيل مزاحمة ومنافسة أي أفكار يرغب بوق السلطة في إزاحتها من عقول المشاهد.
تسبّب اغتيال السادات في مراجعات، بدأت تظهر علاقة تلق حذرة مع الرسائل المبطنة للدعاة، وبدأ إمعان النظر في ما يمارسه كثير منهم من "تورية"، فالحديث عن الظلم والظلمة، حتى لو من خلال أمثلة وحكايات قديمة في عهد الأنبياء، ربما يلقي بظلاله على العصر، ولم يكن نادراً أن يُسقط الداعية هذه القصص على الظروف السياسية الجارية.
هكذا، بدأت الدولة المصرية تتعامل بحذر أشد مع الدعاة في أعقاب 1982، ليبدأ حصار الخطاب الديني، خاصة بعد أحداث الإرهاب في أسيوط، وحصار مديرية الأمن، فكان احتواء الدعاة غير المدجّنين واجباً، وأبرزهم عبد الحميد كشك، وبدأ التفطّن إلى أكثر من "مفرخة" للدعاة الذين لا تتحكم فيهم السلطة مثل "مسجد العزيز بالله"، ومن هناك تتالت أجيال من الدعاة الجدد منهم محمود المصري، ومحمد حسان، ومحمد حسين يعقوب.
سرعان ما اشتهر هؤلاء بفضل التكنولوجيا، فبعد أن كانت أصواتهم تدوّي في عربات تاكسي القاهرة، أو البيوت على غرار صوت الشيخ كشك بفضل شرائط الكاسيت، ظهرت القنوات الدينية نهاية التسعينيات، ومطلع الألفية الثالثة، فأصبح لهؤلاء الدعاة انتشار أكبر من انتشار الشعراوي الذي كان يظهر كل جمعة عقب الصلاة في التلفزيون المصري حتى رحيله عام 1998. لقد ساهمت القنوات الدينية في صنع نجومية الدعاة، ومكّنتهم من انتشارٍ تجاوز مصر.
تقاطع هذا الحضور مع ظهور الأفكار النيوليبرالية في دوائر الحكم المصرية، وخواء الساحة من داعية رسمي بحجم الشعراوي. وجد النظام صعوبة في توفير دعاة يتبنّون طروحاته، رجال مخلصين بوسعهم تبرير توجهاته، ومنها على المستوى الاقتصادي التخلص من المسؤولية السياسية تجاه مواطنيه، أو الرغبة في بيع الملكية العامة وكان ذلك يتم في الغالب عبر صفقات فاسدة، فزادت أعباء المصريين، وارتفعت البطالة، وبات من المطلوب أن يفتح الإعلام الباب من جديد للدعاة، وأفرز هذا التوافق خطاباً مغايراً لخطاب الدعوة الذي ظهر في القرن العشرين، أصبح أكثر امتلاء بالأساطير، ولا مانع أن يتخلّل المواعظ الدينية استناداً إلى مقولات التنمية البشرية. وعلى المستوى الشكلي، ظهرت وجوه جديدة حليقة، لا تشبه وجوه الشيوخ حسان والمصري ويعقوب، وتختلف في أسلوبها الكلامي عن الشعراوي.
بات الشباب يبحث عن دعاته، وبات النظام يبحث كذلك عن دعاته، لملء الفراغات في المجالين، الثقافي، والسياسي. وضمن هذا المناخ لمع نجم عمرو خالد، إذ انطلق من أحد مساجد محافظة الجيزة، وكذلك اشتهر بتقديم لقاءات في أحد أكبر أنديتها بحي الدقي، المعروف بنادي الصيد. ظهر "الشاب الوسيم"، ذو الشارب الخفيف، يحدّث الناس بالرضا بالمقسوم، والصبر على الشدائد والملمات، وتحمل المحن.
ظهر فكان أشبه بمغناطيس يجذب الشباب إليه، وفي غياب أي شكل من أشكال الحوار في المجتمع المصري، وأشكال المناظرات الدينية، نجح عمرو خالد في "أسطرة" الحكي الديني، وخلط بينه، وبين دعوات بناء وتكوين الشخصية، التي تلقفها المراهقون بلهفة، فمنح لمتابعيه دوافع أكثر لمشاهدته، والاهتمام بما يقوله، وعلى منواله سار مصطفى حسني وآخرون.
أصبح برنامج عمرو خالد التلفزيوني الأشهر "صنّاع الحياة" الذي كان يقدّمه على قناة "اقرأ"، عام 2003، عنواناً لمرحلة، فهو لا يتطرّق إلى المسائل السياسية وبالتالي لا يأتي مطلقاً عن مسؤولية الدولة تجاه بنيها، وشبابها، وضرورة أن توفر لهم فرص عمل، أو تفتح أمامهم المجال للنجاح والتجربة.
خطاب أتى على هوى النظام تماماً، فقد كانت الدولة منسحبة فعلاً من هذه الأدوار، فلا ضير من ترك المجال واسعاً لعمرو خالد وأمثاله كي يلقن الشباب دروساً ومواعظ عن التحمّل وضرورة الصبر، والاعتماد على ذواتهم، بدلاً من مساءلة الدولة عن أسباب غياب فرص عمل لهم، فكان الداعية الشاب يحاور الشباب بمقولات من قبيل: حدد هدفك، كيف تكون إيجابياً، الإتقان وغيرها، وهي موضوعات لم تكن متصلة بالدين في وقت سابق، ثم لم يلبث أن تطوّرت فكرة "صنّاع الحياة" لتصبح جمعية خيرية تنموية، انضوى تحتها شباب كثيرون، معظمهم ممن أغلقت الدولة أبوابها في وجوههم، وبات نشاط الجمعية مساهماً في عملية غرز مخالب النيوليبرالية بفك الوثاق بين الدولة ومواطنيها، فصارت مساعدة الشباب أو رعاية الفقراء مسؤولية جمعيات مثل جمعية عمرو خالد، وهي توجّهات أدت في النهاية إلى المشهد الراهن الذي يعيشه المصريون، فجمعية "رسالة" مثلاً تقول في إحدى إعلاناتها هذه الأيام: "رسالة بتؤوي المسنين، رسالة بيدّوا دروس تقوية، بيبنوا أسقف تستر الغلابة، وبيجهزوا العرايس المحتاجين، وبيمحوا الأمية، وبيكسوا ملايين المصريين، وبيعملوا عمليات زراعة قوقعة، وقوافل طبية تعالج الناس".
فإذا كانت الجمعيات الخيرية تفعل كل هذا، فأين الدولة، ومؤسساتها؟ هكذا نجح الدعاة في "محو" دور الدولة من عقول فئات من الشباب، وتنفيذ أفكار هدم العقد الاجتماعي بين المواطن وحكومته، وغرز ما ترغب فيه السلطة في رؤوس شبابها من أفكار، لينتهي المشهد الاجتماعي المصري بعد عقود إلى "فراخ" عمرو خالد الوطنية.