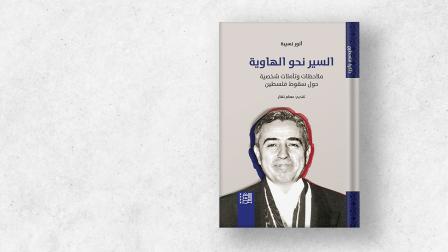ليس نادراً أن نسمع في المغرب عن مبنى تاريخي ينهار دون أن تحرّك السلطات المعنية ساكناً. وفي مرات أخرى، تورد الصحف خبراً عن معلم تاريخي ناله الإهمال، وتحوّل إلى بناية تنتظر من ينقذها، أو نسمع عن نقوش صخرية تاريخية تعود إلى آلاف السنين، ترعى الماشية بجانبها دون أن ينتبه لها أحد.
مع كل هذا الإهمال، تشعر أن البنايات و"القصبات" التاريخية لا تزال قائمة فقط لأنها لا تزال قادرة على ذلك، ولأن عوامل الطبيعة لم تنل منها بعد. وقد ينتابك شعور، بأن لا أحد معني بهذا التراث، الذي يعود إلى حضارات كثيرة مرّت على المغرب الذي طالما وضع برامج لجذب السيّاح، ولو أنه جرى الالتفات إلى كثير من المباني التي نعنيها لساهمت هي الأخرى في ذلك.
كثيراً ما قيل إن موقع المغرب الجغرافي، مثّل نعمة ونقمة لشعبه في آن. نعمة أن يكون بين قارّتين: أفريقيا وأوروبا، ومطلاً على واجهتين بحريّتين: المحيط الأطلسي والبحر الابيض المتوسط؛ ونقمة لأن الموقع نفسه، جعله محطَ أطماعٍ خارجية على الدوام، وهدفاً للغزاة منذ آلاف السنين.
هكذا، كان المغرب لقرون طويلة متحفاً حياً يخزّن الآثار من عهد الفينيقيين إلى غيرهم من الغزاة الآتين من الشرق والشمال. متحفاً يجمع آثاراً أمازيغية ورومانية وعربية وأندلسية.
ترْكُ الآثار عرضة للإهمال، أو الاهتمام الخجول بها، هو طمس لكل هذا التاريخ. لكن، ألا ينمّ هذا الوضع عن موقف سلبي غير معلن تجاه التراث؟
يعيد بعضهم مقولة أن سنّة الحضارات الغالبة أنها تطمس من سبقها، فيما يشبه تبريراً لما يحدث في الحاضر من إهمال. ربما لعب الصراع على الحكم في المغرب دوراً كبيراً في إهمال المعمار التراثي، فهذا الصراع كان ينتقل بشكل غير مباشر، صوب المخلفات الرمزية للدولة المنهزمة، سواء في شكل معمارٍ أو مآثر، إذ يهتم المنتصر فقط، بما يراه مناسباً ويترك الباقي لرحمة الطبيعة.
لكننا في العصر الحديث، بتنا على مسافة كافية من هذه الصراعات كي نتعامل معها بأريحية. إن التراكم العمراني الطبيعي الذي عرفته مدن مثل مراكش وفاس يشبه وثائق حية: جامع القرويين، وسور المدينة القديمة، المدرسة البوعنانية في فاس. وفي مراكش مآثر أخرى مثل مسجد الكتبية، وقصر البديع، والمنارة وغيرها.
لم تكن هذه المدن/ العواصم تبحث عن تخليد تواجدها عمرانياً، إلاّ انطلاقاً من حتميات وضرورات تحتكم في الغالب، إلى وجهة نظر ضيّقة إما "دينية" أو أمنية. فالجانب الديني الذي شكّل شرعية الحكم كان مدخلا للكثير من التشييدات أهمها، المساجد والزوايا والقباب التي امتزج فيها الفن المعماري المغربي بالأندلسي منذ جامع القرويين بفاس حتى مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. لا ننسى أيضاً أن مواقع أثرية وتراثية كثيرة لا تزال تنتظر من ينقّب عنها، بالإضافة إلى ضياع الكثير من التماثيل بسبب الإجماع الفقهي على تحريمها.
في هذا السياق، نذكر حدثاً طريفاً؛ حينما أقدم قبل أشهر عمدة مدينة طنجة على طلب فتوى من المجلس العلمي للمدينة، بخصوص مشروعية تشييد تمثالين: الأول للرحالة ابن بطوطة والثاني للإمبراطور البيزنطي هرقل الذي مرّ في المدينة. هذا الحذر يفسّر إلى حد كبير غياب التماثيل والمجسّمات عن المدن المغربية بشكل مطلق.
الحادثة تشير أيضاً إلى أن النظرة إلى التراث المغربي لا تزال تشابه إلى حد كبير نظرة الماضي. هذه الخيارات الانتقائية في التعامل مع التراث، جعلتنا لا نتعرّف على جزء كبير من تاريخ المغرب، وفي أحسن الأحوال ظلّ الاقتراب منه محتشماً، مثل ما هو الحال بالنسبة لمدينة "ليكسوس" أو "وليلي" وغيرها من المواقع الأثرية.