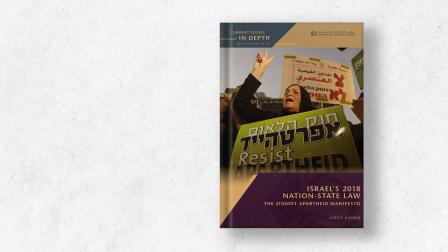(1)
كان ذلك قبل أن يشاهد مالك بن فهم الأزدي لقطة كبيرة لقرية مسفاة العبريين وهي تتراءى له على شاشة واحد من أحفاده السينمائيين العمانيين الشباب. كان ذلك في التراتيل، والأهازيج، والتنهدات، والآهات، والإحباطات، والأمنيات، والرذاذ الذي يهطل على الأرض كما يَتَمَطُّرُ الجرح على غيمة فوق جبل سمحان في يونيو العظيم. وكان الحلم يقطن في ما هو مهرَّب على ظهور الجمال، وما لا يُهرَّبُ من صدور النساء والرجال. كان ذلك في الوقت الجَمْرِيِّ الذي عاد فيه الماء إلى السماء، واكتشفت السماء الشفاه، والحناجر، والغيوم، والدماء.
كان ذلك قبل أن يقول لي صديقنا العزيز المشترك سماء عيسى بالحرف الواحد قُبيل الطرق ذات ظهيرة صيفية قديمة وحارقة على باب شقة متواضعة في بناية صغيرة في منطقة الولجة – فعلاً بالحرف الواحد، وبالفصحى: “ستتعرف الآن إلى شخص يندر وجوده في هذا الزمن السيء"!.
بلى، في تلك الظهيرة الصيفية القديمة تعانقنا للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين قبل أكثر من ثلاثين سنة لا تزال صدور الأحياء ورئاتهم تتشبث بضلوع الموتى، ولا يزال الموتى يذكِّرون الأحياء بما اختفى، أو أخْفِيَ، في منتصف المسافة الحَرِجَة بين الحياة والموت.
(2)
لم يكن سماء عيسى يعلم (ربما لغاية هذه الليلة) أني قبل ذلك عرفته قبل أن أراه. رأيته قبل أن أعرفه. استشعرته قبل أن أقرأ شعره، ونثره، وأسمع أحاديثه الطويلة العذبة خاصة حين يتعلق الأمر بالتاريخ العماني. سمعت عنه قبل أن يُسمعني الكثير. علمت عنه قبل أن تراني عيني، وهو ببصيرته علَّمني وأسكنَ في عيني إلى الأبد الكثير مما لم أرَ.
بلى، فقد شاهدته قبل أن أشهد أني أقمت في بيته مُعَزَّزاً مُكَرمَّاً حين لم يكن لي أهل، ولا مأوى، ولا أمان، بل كانت "النِّصال تتكسر على النِّصال"، وذلك حين عدت إلى بلادي في 1983 – بلادي التي هي ذاتها بيته، ووطن الجميع، بما في ذلك الحِل، والترحال، والمنفى، والموت، والحياة أيضاً.
ومع ذلك فإني لا أستطيع أن أعرف أحمد الزبيدي حق المعرفة إلا بما في المعرفة من حق. لا بأس أن يستمر الأمر بهذا الشكل. كلنا يمر ببأس الشكل والمضمون. أحمد الزبيدي؟!. كلا – "عبيد العماني"!. سأوضح الأمر أكثر. قبل تلك الظهيرة برفقة سماء عيسى أمام باب شقة صغيرة في منطقة الولجة سألت صديقاً عزيزاً من المخضرمين في دولة الإمارات حين كنت مقيماً فيها: "هل تعرف شخصاً عمانياً اسمه أحمد الزبيدي، فاسمه يتكرر على مسمعي في بعض الأوساط والدوائر"؟. رد عليَّ: " كلا!. لا أعرف شخصاً اسمه أحمد الزبيدي، لكني أعرف شخصاً اسمه عبيد العماني"!.
الشيء الوحيد الذي أدركته فوراً من هذا اللغز العجيب الغريب هو أننا كنا في آخر الليل أو في أول النهار. وفي آخر الليل أو في أول النهار يمكن أن يخلط صاحبي ذاك أسماء البشر بتقاليد البنادق، والدماء، والحجر، وذهاب الهجرات من اليمن إلى عمان، أو من عمان إلى الصين. ولذلك فقد رأيت انه خير للبشر، والبنادق، والدماء، والحجر، والهجرات الانتقال إلى موضوع آخر للحديث!.
لكن ما حدث بعد ذلك بفترة قصيرة هو انه اختلطت أسماء البشر بتقاليد الحجر؛ فقد نشرت مجلة "الأزمنة العربية" (التي مُنعت من الصدور لاحقاً) قصة قصيرة بعنوان "انتحار عبيد العماني" لكاتب عماني اسمه أحمد الزبيدي؛ فعدت لصديقي ذاك لاهثاً وصارخاً: "هذا هو أحمد الزبيدي من جديد!". رد صاحبي: "انتحر عبيد العماني؟!. معقول؟!. لا، مستحيل. يستحيل ينتحر!، لا انتحر ولا بينتحر!. ما معقول ينتحر!. هذا شخص قوي وصلب وشجاع وأنا أعرفه زين، وما ممكن ينتحر!. إذا بغيت الحقيقة روح عند"الجماعة" واسألهم عن أحمد الزبيدي وعبيد العماني".
لم يقل لي صديقي ان "عبيد العماني" كان الاسم الحركي لـ "أحمد الزبيدي" لدى "الجماعة". هكذا يتحد الشخص بالشخصية في الحياة، وفي العمل، وفي الإبداع. هكذا نذهب إلى التراب كما لو أننا نشرب الماء، كما لو أن السماء لا تستطيع أن تمطر سوى الذكريات الأكثر عذوبة وقسوة من المطر.
(3)
حين كنت مقيماً في بيته، كان أحمد الزبيدي، أقصد عبيد العماني، يخصني بقطعة اللحم الأكبر في وجبة الغداء ويضعها أمامي بطريقة إيثاريَّة على طبق الرز الأبيض الدَّسم. لكنه كان يرمي لي أكبر قطع ممكنة من الحزن والشجن في أحاديث الليل وما يرافق عذابات استشهاد سبارتِكوس، أو المسيح، أو خنتور، أو طفول، أو ما حدث ذات ليلة تتحدث عنها الكتب العربية والإنجليزية في مرباط، وما حدث بعد ذلك. شكراً له لكل ذلك العذاب.
أتذكر كل ذلك، وأتذكر أيضاً ما لا أستطيع أن أذكره الآن.
كان أيضاً يرمي لي أكبر كتلة من الغمِّ الضبابي عند الصباح الذي نتبادله مع القهوة التركيَّة والتبغ (بالمناسبة، يمكن أحياناً أن يكون أحمد الزبيدي صامتاً بعض الشيء في الصباحات، ولا يلعن كل أحد، وكل شيء في هذا العالم). وكانت مريم التي سيأتي أوان الحديث عنها في يوم ما، هي التي لا تحب الحديث عنها في أي يوم من الأيام؛ مريم التي أسماها سماء عيسى مُحِقَّاً "أمُّ العمانيين"؛ مريم التي لا تستطيع الشمس أن تشرق في عماننا من دون أن تتذكر وجهها والأطفال الذين يتدفقون من روحها كما تتدفق الغيوم من المسامات. وكانت عبير الصغيرة التي كانت تقول ضاحكة انه يستحيل أن يكون اسم أمي مريم في الوقت الذي اسم أمها فيه هو مريم أيضاً؛ عبير التي أصبحت الآن أُمَّاً. وكان الأحنف الذي لم يعد يلعق ابهامه ويختبىء تحت الطاولة، بل صار ولده يفعل ذلك بالنيابة الاستعاديَّة والوراثيّة.
وكنا نزور بوابة السجن في شهر رمضان قبيل الغروب من أجل إيصال "الهمبا" (المانجو) والرّطب والفطور للماكث هناك وحيداً، مغدوراً، بلا ألوان، ولا فصول، ولا أيام، ولا أسابيع، ولا شهور، منذ سنين. سيكون لذلك السجين المجهول في هذا الزمن الجاهل أن يموت بالكمد والغصّة لاحقاً لفرط ما حاقَ به من وطن، ولكثرة ما أُصيبَ به من كبرياء، ولشدّة ما أتته الذكرى. له الحياة كلّها في أية حال، وله الذكرى حيث وحين لا أحد يتذكر.
(4)
ألا يا ريح الليل الطويل: لا تترفقي بالجهات، لأن أحمد الزبيدي توأم البوصلة!.
(5)
إذا كان من المفروغ منه أن عبدالله الطائي هو مؤسس القصة القصيرة والرواية في عُماننا بالمعنى التاريخي (أي الزمن)، فإن أحمد الزبيدي هو مؤسسهما بالمعنى الجمالي والفكري (أي النوع) منذ مجموعته القصصية الأولى "انتحار عبيد العماني" التي تأخر صدورها أكثر مما ينبغي لأسباب هي أيضاً أكثر مما ينبغي.
(6)
من الناحية التقنية فإن "أحوال القبائل" رواية بصورة صريحة. لكن فيما يخص اعتباره "قاصَّاً" فإن أحمد الزبيدي هو الوحيد بيننا الذي يكتب وبِتَمَكِّنٍ كبير "الرواية القصيرة" أو "القصة القصيرة الطويلة"، الـ novella. لماذا؟. لأن أحمد الزبيدي ليست لديه رغبة في الاختصار والتكثيف كما هو في وارد المألوف من تقنيات الكتابة في القصة القصيرة. لماذا أيضاً؟. لأن أحمد الزبيدي ليس معنيَّاً بلحظة آبقة في الزمن، بل بالطلقات المغدورة في معركة انتحارية، وبالتاريخ غير المؤرَّخ له، وبالشمس والقمر معاً، وبالنجوم أيضاً من باب تحصيل الحاصل، وبالضحايا بأكملهم، وبالجلادين عن بكرة أبيهم، وبالدم بكل ما سطَّره، وبالماء في كل قوله.
لا يستطيع احمد الزبيدي ان يتزلف هواءه. هو أقل قدرة من مجاملة النوع الأدبي. هو – الثائر والمتمرد بطبيعته القديمة – يشعر بالاختناق في أقبية النُّقاد لذلك فإنه لا يقدر على الذهاب إلى الكتابة برئة النوع التقني، بل لا يستطيع أن يشهق ويزفر برئتيه الاثنتين وحدهما: انه يجلب إلى هواء الكتابة رئات مُعَطَّلة، وضلوعاً نافرة عن ومن صدورها، وأحلاماً خذلتها بنادقها، وصدوراً تبكي على أحضانها، وعظاماً مهشَّمة في اندحاراتها، وانحداراتها، وانتحاراتها، وحكايات لا تروى ولا تقال، ممن رحلوا قبله على دربه أو ممن أبقى قلبه رهينة كالفنار الوحيد على رياحهم. يصير أحمد الزبيدي الحكاية. وتصير الحكاية أحمد الزبيدي. لكن منا من لا يفقهون كيف يمكن أن تحكى الحكاية، ولماذا ينبغي أن تُحكى أصلاً.
يستمر أحمد الزبيدي في سرد الملحمة إذ أنه من ندرة أقل من نادرة من الكتّاب العمانيين الذين لا يريدون للزمن أن ينسى ما حدث في التاريخ العماني المعاصر لمدة عشر سنوات كاملة. ولا يزال النقاد يلتزمون الصمت والخوف،. وأحسب أن في هذا خيراً للجميع.
(7)
يشرب أحمد الزبيدي في كل كتاباته – التي لم يقرأ غالبنا غالبيتها – الكأس المُخَلَّدة الطويلة المترَعة لوحده. لا أستطيع تصور كاتب عماني أكثر وحدة من أحمد الزبيدي. وحيد في الدم، وحيد في الجدوى، أو عدم الجدوى، وحيد في الذاكرة التي هي نفسها وحيدة ومهجورة.
(8)
... في مشروع "أ، ب، ت،..." المُجْهَض – وهو المشروع المغدور لأول وآخر مطبوعة ثقافية عمانية مستقلة الذي ليس هذا مقام الحديث عنه، والذي كدنا أن ندفع له أرواحنا (أحمد الزبيدي، وسماء عيسى، ومريم، وأنا) ثمنا له في حادث سيارة ذات ليلة على خط الباطنة الذي لم يكن مضاءً عهدذاك عائدين من أبوظبي، كان هناك أيضاً وطبعاً أحمد الزبيدي!.
(9)
في كتابه "إعدام الفراشة" يذهب الزبيدي بامتياز نحو الأثير في كتابته: الخصوصية الجمالية، والتاريخية، والميثولوجية (الأخيرة بمعنى مزدوج: الاتكاء إلى الميثولوجيا الظفاريّة من جهة، وإيجاد السرد للميثولوجيا الخاصة به نفسه بنفسه وهو يتقدم في الذاكرتين الفرديَّة والجمعيَّة من جهة أخرى). مما يميز هذه المجموعة أيضاً اتصال، وتواصل، وتلاحم شخصيات الكاتب ورموزه التي عرفناها في أعمال سابقة (بدءا منذ مجموعته القصصية الأسطورية "انتحار عبيد العماني") مثل رَايَة وسلطان الخروصي. إن الكاتب هنا يتمرأى من جديد في وجوه وأرواح شخصياته التي نحتها قبل أكثر من ثلاثين سنة؛ وهو بهذا إنما يكافح ضد النسيان، وضد الموت، ويا لَهُ من كفاح. أظن ان هذا نادر جداً في الكتابة العمانية الإبداعية المعاصرة.
(10)
نشوان يا أحمد الزبيدي، نشوان يا عبيد العماني، نشوان يا أبا الأحنف. دوماً، دوماً، دوماً، نشوان *
* عنوان أغنية يمنية شهيرة
**نشرت هذه الشهادة في كتاب "عبيد العماني حيّا" (دار "سؤال"/2015) من إعداد وتحرير سليمان المعمري وسعيد الهاشمي.