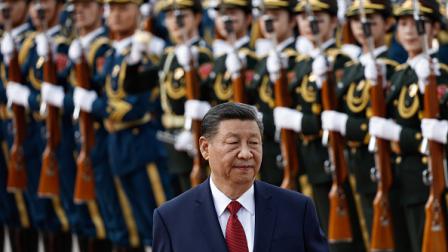الحكومة التركية قلصت تأثير الجنرالات في الحياة السياسية(أمين سنسار/الأناضول)
بدت المحاولة الانقلابية في تركيا، في 15 تموز/يوليو الماضي، كآخر جهود المؤسسة العسكرية لاستعادة دورها التاريخي المسيطر على الحياة السياسية في البلاد، بعد الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها على يد حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002. يدرك الساسة الأتراك خطورة التعامل مع المؤسسة العسكرية التي استولت على الحكم منذ الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908، وتعزز دورها مع حرب الإنقاذ وتأسيس الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923. ولم توفر أي شيء في سبيل استمرار هيمنتها على الدولة والمجتمع. ونفذت أربعة انقلابات لتغيير الحكم في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997؛ وفيما كان الأخير انقلاباً أبيض، يطلق عليه في تركيا انقلاب "ما بعد حداثي"، تميزت الانقلاب السابقة بدموية عالية. واتسمت العلاقة بين حكومات حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية بالشد والجذب، وبالتقلّب بين محاولة التعايش والحذر والتشكيك من جهة، والمواجهة من جهة أخرى، لكن ضمن حدود معينة لا تخرج مارد العسكر من ثكناته.
رغم التوتر المستمر مع المؤسسة العسكرية، أبدت الحكومة التركية حرصاً كبيراً على زيادة ميزانية الجيش وتعزيز قدراته الدفاعية وعدم المساس بأي من الامتيازات التي لطالما تمتع بها ضباطه، فبات الجيش التركي خلال سنوات من أكثر المؤسسات العسكرية في المنطقة سرعة في التطور. كما تعززت الصناعات العسكرية التي جعلت من تركيا إحدى أكبر 10 دول في العالم لهذه الناحية. تم إنتاج حوامات وسفن وفرقاطات ودبابات ومدافع وطائرات تدريب محلية الصنع، وزادت نسبة اعتماد الجيش على الصناعات المحلية في مشترياته، من 20 بالمائة عام 2002، إلى ما يقارب الخمسين بالمائة العام الماضي. فضلاً عن ذلك، تعد تركيا أحد أهم المشاركين في صناعة طائرات "إف 35" الأميركية، مع بدئها بإنتاج دبابات محلية الصنع، والعمل على مشروع إنتاج طائرة حربية محلية الصنع.
بموازاة ذلك، عملت الحكومة التركية على سحب الملفات الأمنية تدريجياً من يد المؤسسة العسكرية. فبعد إسناد أمر حماية المدن لوزارة الداخلية، والسيطرة على جهاز الاستخبارات، تم أيضاً سحب ملف الصراع مع حزب العمال الكردستاني وتسليمه لجهاز الاستخبارات، الأمر الذي ترافق مع تعزيز قوات الشرطة التابعة لمديريات الأمن، والتي أدت دوراً حاسماً في دحر المحاولة الانقلابية الأخيرة، قبل أيام. ويمكن تقسيم المواجهات بين الحكومة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية، والمؤسسة العسكرية التركية، إلى مرحلتين رئيسيتين:
2003: المواجهة الأولى
بدأت المواجهات بين الجانبين باكراً. في شهر أبريل/نيسان 2003، قاطع مسؤولون في الجيش حفل استقبال أقامه رئيس البرلمان، بمناسبة أحد الأعياد الرسمية، بسبب ارتداء زوجته الحجاب المحظور لبسه في مؤسسات الدولة والجامعات. في أعقاب ذلك، وبعد أيام قليلة، صعّد مجلس الأمن القومي، الذي كان تحت سيطرة العسكر، من لهجته، عبر بيان شدد فيه على ضرورة "حماية مبادئ العلمانية التي تشكل الدعامة الأساسية للبلاد".
وسمح القانون للبرلمان بدراسة نفقات الجيش مع نصّه على أن تبقى هذه الدراسة "سرية". وتلاها في ديسمبر/كانون الأول 2003، إقرار قانون جديد ينص على إلغاء السرية التي تحيط بنشاطات مجلس الأمن القومي، الذي يسيطر عليه الجيش، استجابة لمطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على هذه المؤسسة لتحسين مستوى الديمقراطية في البلاد.
2007 -2014: المواجهة الثانية
ارتفع التوتر، مرة أخرى، بين الحكومة التركية والمؤسسة العسكرية إثر ترشيح حزب العدالة والتنمية، وزير الخارجية آنذاك، عبد الله غول، لرئاسة الجمهورية، خلفاً للرئيس ذي التوجهات الكمالية نجدت سيزار، ليتكرر ما يشبه سيناريو الانقلاب الأبيض الذي كان حصل في عام 1997. وضغطت قيادة الجيش بالتعاون مع الاستخبارات التركية على الحكومة الائتلافية بين حزب الرفاه بقيادة نجحم الدين أربكان، وحزب الطريق القويم بقيادة تانسو تشيلر، مما دفع الحكومة للاستقالة. فقد أصدرت قيادة الأركان، في شهر أبريل/نيسان 2007، بياناً على موقعها الإلكتروني، تضمن تحذيراً شديد اللهجة لحزب العدالة والتنمية، وأكدت خلاله المؤسسة العسكرية أنها ستتدخل إن رأت بأن "قيم البلاد العلمانية مهددة"، وهي العبارة السحرية التي لطالما ذيّلت بيانات الانقلابات السابقة. وتزامن تحذير الجيش مع تظاهرة حاشدة في مدينة إسطنبول نظمها الكماليون اعتراضاً على ترشيح غول، ذي التاريخ السياسي الحافل في صفوف حركة "ميللي غوريش" الإسلامية بزعامة أربكان.
هذه المرة، أيضاً، لم يتأخر رد الحكومة التركية، فأطلقت تحقيقاً رسمياً في مزاعم وجود مخطط انقلابي لإسقاطها، بقيادة المدعي العام في اسطنبول، زكريا أوز. هذا الأخير هو عضو في حركة الخدمة، وتولى أيضاً ما يعرف بقضية المطرقة ضد العسكر، ودعاوى الفساد ضد الحكومة التركية في عام 2013، حين انفجر إثرها الصراع مع حركة الخدمة، ليصدر قرار قضائي في أغسطس/آب من العام الماضي باعتقال أوز، لكنه فرّ إلى جورجيا ومنها إلى أرمينيا، ثم ألمانيا حيث يعيش لاجئاً سياسياً. واتُهمت مجموعة سرية بالتخطيط لذلك الانقلاب، وهي مجموعة "الأرغنكون"، السرية، التي تعتنق الفكر القومي التركي الكمالي، والمتواجدة في الجيش. تجدر الإشارة إلى أن اسم أرغنكون موجود في الميثولوجيا التركية ويطلق على واد تقول الأسطورة إن العرق التركي عاش فيه حقبة من الزمن.
وبحسب التحقيقات، ضمت منظمة الأرغنكون العديد من قادة الجيش ونوابا عن حزب الشعب الجمهوري ومدعين وقضاة وصحافيين وعمداء جامعات وزعماء نقابيين. والمجموعة، بحسب الادعاء، كانت تخطط لنشر الفوضى في البلاد وإقامة أحداث عنف، تبرر تدخل الجيش ضد الحكومة التركية، لتؤدي القضية، بعد خمسة أعوام، إلى اعتقال والحكم بالسجن المؤبد لأول مرة بحق قائد سابق لهيئة الأركان وهو الجنرال إلكر باشبوغ، مع مجموعة من كبار الضباط في الجيش. وساهمت التحقيقات ضد المؤسسة العسكرية في تخفيف موقفها المعارض لانتخاب غول رئيساً للجمهورية، الأمر الذي تم بالفعل في نهاية أغسطس 2007.
لم تتوقف الاعتقالات بحق الضباط في قضية الأرغنكون. وكشفت صحيفة طرف التركية في يناير/كانون الثاني 2010، عن تفاصيل خطة انقلاب عسكرية تقع في 500 صفحة، كانت تحضر لها مجموعة من ضباط الجيش التركي عام 2003، أطلق المنفذون على خطتهم اسم "المطرقة". وكانت تهدف إلى إثارة البلبلة والقلاقل في أنحاء البلاد، من خلال تنفيذ تفجيرات في المساجد والشوارع العامة وإسقاط طائرة حربية وإلقاء اللوم في ذلك على اليونان. ونصت الخطة أيضاً على أن الجيش يستغل هذه الظروف من أجل استلام الحكم وتعطيل البرلمان وحل الحكومة. وبعد كشف الخطة الانقلابية وما تلاها من اعتقالات، ردت هيئة الأركان في فبراير/شباط 2010، في بيان إلكتروني، حذرت فيه من خطورة الأوضاع الداخلية، رداً على اعتقال عدد من كبار ضباطه بتهمة الضلوع في مخطط "المطرقة" الانقلابي، والذين كان معظمهم من البحرية التركية، بينهم قائد سلاح البحرية السابق، الفريق أوزدن أورنيك، والقائد السابق للجيش الأول، جتين دوغان، المتهم بأنه "رأس الحربة" في خطة الانقلاب.
استغلت الحكومة التركية قضية المطرقة لتمرر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010، عبر مجلس الأمن القومي، تعديلات جديدة على "الوثيقة السياسية للأمن القومي" في تركيا. وبموجب هذه التعديلات تم شطب عبارة "خطر الرجعية والجماعات الإسلامية" واستبدالها بعبارة "الأخطار المتوقعة من التنظيمات المتطرفة دينياً"، كما أضافت خطر الانقلابات والعصابات السرية إلى قائمة التهديدات الداخلية.
وبينما فتحت قضية محاسبة الضباط، الذين أشرفوا على انقلاب العام 1997، في أبريل/نيسان 2011، أقدم رئيس هيئة أركان الجيش التركي، الجنرال إيشيق كوشانير، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، استقالاتهم في شهر يوليو/تموز 2011، قبيل الاجتماع السنوي لمجلس الشورى العسكري الأعلى، بعد خلاف مع الحكومة بشأن ترقية قادة عسكريين مسجونين، واعتقال نحو 165 ضابطاً، منهم 40 جنرالاً، في محاكمات محاولات انقلابية.
ولم تتوقف الإصلاحات القانونية عند هذا الحد. فقد وافق البرلمان التركي، في يوليو/تموز 2013، على تعديل للمادة 35 من قانون الجيش، الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، ويحدد طريقة عمل الجيش وعقيدته العسكرية. وساهمت الصيغة الجديدة في الحد من مجال تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية، وحصر مهامها بـ"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج"، والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان، بدلاً من "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها".
ولم تخفّ وتيرة الصراع مع المؤسسة العسكرية، وبالذات مع التيار الكمالي القومي فيها، إلا مع انفجار الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة بقيادة فتح الله غولن، والتي قاد أعضاؤها ومقربون منها التحقيقات ضد ضباط الجيش، ليتحالف بالتالي الجيش والحكومة ضدها، ولتبدأ أول المصالحات بين الجانبين، في بداية 2014، عندما مررت الحكومة في البرلمان تعديلات قانونية، تقضي بإلغاء المحاكم الخاصة بالضباط، وبفتح الطريق أمام إمكانية محاكمة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة وقوات الدرك أمام محكمة الديوان العليا، بدل المحكمة الجنائية، في حال ارتكابهم جرائم تتعلق بمناصبهم. وكذلك اشترطت التعديلات مصادقة رئيس الوزراء على فتح أي تحقيق بحق رئيس هيئة الأركان العامة وقادة قواته المسلحة، مما أدى إلى إطلاق سراح جميع الضباط المتهمين بقضية "الأرغنكون" والمطرقة، ومن ثم تبرئتهم بل وتعويضهم، ليصبح إعلان انتهاء الوصاية العسكرية، أهم بنود الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، في شهر أغسطس/آب من العام نفسه.