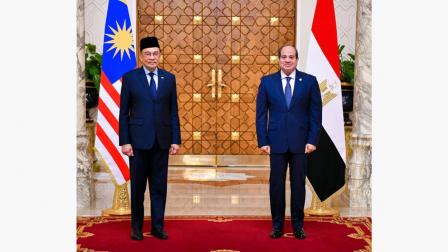حلق شبان فلسطينيون رؤوسهم "على الصفر"، في محاولة للتمويه على منفذ "عملية شعفاط"؛ عدي التميمي، قبل أن يستشهد في عملية ثانية. ما ذّكر الفلسطينيين بحادثة مشابهة وقعت خلال ثورة 36، عندما لبس الرجال من سكان المدن "الكوفية" بدل "الطربوش"، للتمويه على الثوار آنذاك. على الرغم من التشابه بين الحدثين، الذي يؤشر إلى ترابط اجتماعي ووطني ميكانيكي بين ذوات فاعلة ضمن صيرورة نضالية، إلا أن هذه الصيرورة قطعت مرات عدة.
منذ تلك الثورة حتى اليوم، تعرض الشعب الفلسطيني لكثير من سياسات التقويض والإزالة، والمحو المادي والمعنوي على السواء، لكن مقابل كل عملية محو، كانت هنالك دائماً إعادة إنتاج للذات الفلسطينية الرافضة والمقاومة، هنا تكمن المفارقة الهامة، أي في قدرة الفلسطيني على إعادة إنتاج ذاته، أكثر مما هي في إعادة إنتاج الفعل المقاوم بمعناه المجرد، أو بكلمات أكثر دقة، إن جوهر مقاومة هذا الشعب، تكمن في قدرته على العودة من المحو، كأن تاريخه النضالي يتلخص في جدلية المحو والعودة منه، هذا ما يحدث مؤخرا في فلسطين؛ في الضفة الغربية على وجه الخصوص، جيل يقاوم للخروج من أكبر عملية محو معنوي شهدها في تاريخه.
"الذات" مجال للصراع
مثلت النكبة المحو المادي الأكبر بحق الفلسطيني، من خلال سلبه أرضه واقتلاعه منها بالقتل والتهجير، وهي في الوقت ذاته عملية استلاب لهذا الفلسطيني، وإعادة تشكيل وعيه بذاته وهويته، فالوعي في النهاية ابن التجربة. كان يفترض بهذه التجربة القاسية، التي أخذت طابع الصدمة والهزيمة، أن تنتج فلسطينياً متقبلاً لواقعه الجديد ومهيأً للذوبان في الجغرافيات التي فرضت عليه. كان يجب أن يتبع سلب الأرض، استلاب الإنسان، حتى تكتمل النكبة وتتحقق.
لهذا، لا يمكن فهم الفعل النضالي، وحركة التحرر التي تبلورت فيما بعد، في حدود الفعل المباشر الرافض للاحتلال، ما بين انطلاق المقاومة وتحرير الأرض زمن يتمدد، قد يطول أو يقصر، لكن عبر هذا الزمن الفاعل؛ أو لنقل في "زمن المقاومة والرفض"، تتحقق عودة الفلسطيني إلى ذاته قبل عودته إلى أرضه، إذ يتكون وعيه في خضم تجربة مضادة لتجربة الهزيمة.
من هنا؛ كان من الطبيعي أن تعتبر "معركة الكرامة" عام 1968، أول مواجهة مباشرة يخوضها الفلسطيني مع الاحتلال ويحقق فيها نصره الأول، نقطة تحول اجتماعية قبل أن تكون سياسية، فقد أصبح "اللاجئ الفدائي"، أحد مكونات وتعبيرات الهوية الفلسطينية الجديدة، ومشروعه الوطني التحرري، بات بمثابة الأرض المتخيلة، التي تجمع هذا الشعب رغم شتاته، فلا يمكن تخيل هوية جامعة لشعب فقد أرضه ووطنه دون مشروع تحرري فاعل. لهذا كله، لم تعد معادلة "الكبار يموتون والصغار ينسون" واردة، فالذاكرة حية تغذى وتورث للأجيال بفضل الفعل الحي والذات الفاعلة. هذا يعني، أن الذات المستعمَر تمثل مجال الصراع الرئيسي مع المستعمِر، عبر جدلية الهيمنة عليها ومحوها من جهة، وتحريرها وإعادة إنتاجها من جهة أخرى.
إذا كانت النكبة ذروة محاولات المحو المادي للوجود الفلسطيني، فإن "مشروع أوسلو" بكل مراحله وتحولاته يمثل ذروة محاولات المحو المعنوي، فهو أضخم عملية إعادة هندسة اجتماعية للفرد والمجتمع. لم تحاول إسرائيل طوال العقود الثلاثة الماضية تفكيك وتحييد "الفعل المقاوم" فقط، إنما تفتيت وإلغاء "ثقافة الفعل" أيضاً، فالفعل؛ إن غاب لظرف ما، سيعود بالضرورة، ما دامت "معركة الذات" محسومة لصالح المستعمَر. لذلك سعت إسرائيل؛ على سبيل المثال، إلى تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، والمناهج المدرسية، وحاربت الأغنية الوطنية، والموسيقى والإعلام والكلمة...إلخ، وحاولت إحداث قطيعة بين الجيل الجديد وذاكرته الجمعية الموروثة.
كُتب الكثير حول سياسات إعادة الهندسة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تحت مظلة "أوسلو"، لا مجال لإعادة سردها هنا، لكن لنقل بتكثيف واختصار، إن تلك السياسات التي رسمت ونفذت بالشراكة مع المجتمع الدولي، نجحت في كثير من المجالات، فهي استطاعت تفكيك "التجاوب الميكانيكي" بين أفراد وفئات الشعب الفلسطيني، سواء داخل الجغرافيا الواحدة، أو ما بين جغرافيات الوطن والشتات المختلفة، وأسكنت الفلسطيني في عالم مواز لعالمه الحقيقي، وصاغت له وعياً مزيفاً لا ينسجم مع حقيقة واقعه، وخطاباً جديداً أعاد تقديم الصراع على الوجود على أنه صراع على الحقوق. غياب الفعل المقاوم وتحييده، أو على الأقل نقله من المركز إلى الهامش في "مرحلة أوسلو"، مثَل فرصةً لغزو الذات الفلسطينية الفاعلة، وإعادة تشكيلها وتدجينها.
من الضروري الإشارة هنا إلى أن عملية المحو المعنوي، التي دشنها "أوسلو"، لم تأت في سياق هزيمة كالنكبة، إنما في سياق حركة تحرر وطني فاعلة، في أعقاب عملية نضالية شعبية رائدة، الانتفاضة الأولى، هذا ما يجعل آثارها في تقديرنا أعمق وأثقل وأكثر خطورة على الوجود الفلسطيني. خسارة المعركة وأنت مؤمن بأنك تملك جميع أسباب النصر، بعد النجاة من محو سابق، سيصيبك بالخيبة والشك وفقدان الثقة، مما يجعلك طيعاً أكثر لسياسات المحو، وبالتالي فإن عودتك منه أكثر تعقيداً، كما يبدو الآن.
في زمن المقاومة والرفض يعود الفلسطيني لذاته قبل عودته لأرضه
مخيم جنين والعودة من المحو مرة أخرى
لا أتخيل، ما الذي تفكر به القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية اليوم، وهي تكاد تعود إلى نقطة الصفر في الضفة الغربية، بعد كل ذلك الوهم الذي بنته فيها؟ ما هو وقع المستجدات الميدانية عليها، وهي ترى أن رفض المحو ومحاولات العودة منه، تأتي من أكثر مكان اعتقدت أنها حققت فيه "كي الوعي"، مخيم جنين؟ هل يسمح لها عقلها الاستعماري، بأن ترى أن محاولات نهوض الفلسطيني اليوم، تأتي ضمن جدلية المحو ورفض المحو، الممتدة من ثورة عز الدين القسام ودير ياسين والطنطورية و"أوسلو" والانتفاضة الثانية، وصولاً إلى جنين ونابلس العتيقة اليوم؟ هل يمكن أن تستنتج أن المحو التام للفلسطيني مستحيل، وبالتالي كل ما تفعله هو مجرد شراء الوقت؟
عندما اندلعت الانتفاضة الثانية، استخدمت إسرائيل سياسة؛ ما سمته "كي الوعي"، أي إيقاع أقصى درجة ممكنة من الألم والخسارة، على اعتبار أن ذلك يبني سوراً واقياً يحميها من عودة الفلسطيني إلى المقاومة، بعد تحميله ذاكرة مكوية بالحديد والنار، تمنعه من ذلك. جعلت من مخيم جنين "نموذجاً" لتلك السياسة، حيث دمرته دماراً شبه كامل فوق رؤوس ساكنيه، وتركت في كل بيت فيه قصة فقد وخسارة لا تعوض.
بعد الانتفاضة مباشرةً، عادت إلى تصميم سياسات اقتصادية جديدة، تستأنف بها عملية "التدجين والتفتيت"، لكن المفارقة كما ترون الآن، جيل في ربيع العمر، يخرج علينا من جنين ونابلس وحاراتها العتيقة ومن القدس، كما سبق وخرج العام الماضي خلال العدوان على قطاع غزة من اللد وحيفا، ومن كل مكان خضع للمحو و"كي الوعي"، لينحت تجربته النضالية الخاصة به، والملائمة لماهية المرحلة.
المثير في هذه التجربة، أن "فعلها النضالي"، يتجاوز، مرة أخرى، حدود الفعل المجرد، إلى إعادة إنتاج الذات الفلسطينية، ولملمة شتاتها، يعيد انتشالها من العالم الموازي، الذي صنعه أوسلو، كما فعل جيل ما بعد النكبة. لا نتحدث هنا عن مستقبل هذه المقاومة وكيف ستتطور، فهذا بحاجة إلى منحى آخر من التحليل، لكن الذي نحاول قوله؛ ربما هو الأهم، أن مقاومة هذا الجيل، في هذه المرحلة البائسة، التي عنوانها المحو والتفتيت، تمثل إعادة بناء القيم المجتمعية والوطنية، وخطاب وطني يتجاوز التقسيمة الاستعمارية، إنها تنفخ روحاً جديدةً في الجسد الفلسطيني. لعل بلورة هذه المقاومة خارج البنية الحزبية الرسمية، وتحولها إلى نموذج عمل وحدوي، يمثلان رمزية خاصة في رفض هذه المرحلة وثقافتها.
السؤال، كيف لهذا الجيل أن يشق طريقاً معاكساً لكل تفاصيل المرحلة وثقافتها، ويتحرر من "كي الوعي"؟
رغم خصوصية المرحلة الراهنة، ينطبق هذا السؤال على مختلف مراحل التاريخ الفلسطيني، قد نجد الجواب الرئيسي في جوهر الاستعمار والاحتلال ذاته، وفي ماهيته، فهو بالضرورة يخلق التناقض مع "الآخر"، من خلال الإيغال في تدميره ومحوه وإزالته، كلما كان "الآخر المستعمَر" أكثر ضعفاً، تفتحت شهية المستعمِر على التدمير والمحو أكثر، كأنه يعتاش على ذلك، هذا لابد أن يخلق، في لحظة ما وعند جيل ما، رد فعل، كأن ذلك محكوم بقانون فيزيائي.
اللافت هنا تحديداً، أن الاحتلال مهما حاول تفتيت "ثقافة الرفض والمقاومة" ومحاصرة "مصادرها الوطنية"، فإن فعله هو وطبيعته يبقيان مصدراً رئيسياً لتخليق تلك الثقافة، فالمستعمِر يحمل فناءه في جوهره وفعله. الطفل "محمد أبو خضير" و "عائلة الدوابشة" يمثلان رمزية جلية لتلك العلاقة، التي تنشأ بين "مستعمَر" ذاته ساكنة غير فاعلة وهو في حالة المحو، وبين مستعمِر تتفتح شهيته على ذلك الضعف والهوان لدرجة يحرق فيها أطفالا. لهذا، العمليات الفردية التي رافقت حادثة حرق الطفل "أبو خضير" عام 2014، والهبة التي جاءت بعدها بعام واحد، تمثل تجسيداً لما يقوله فرانز فانون، بأن العنف هو الباب الوحيد الذي يستدرك منه المستعِمر إنسانيته المفقودة المهانة والمذلة.
أما بخصوص المرحلة الراهنة تحديداً، فهنالك مبدأ "التراكمية والمحاكاة"، لا يمكن فصل بلورة وظهور نواة مقاومة صلبة في جنين ونابلس؛ أخذت بنية المجموعات المسلحة وشبه المنظمة، بمعزل عن تكرار "الفعل الفردي" طوال السنوات العشر الماضية، يوجد رابط ما بين الفتى "مهند الحلبي" الذي خرج بسكينه إلى القدس، و"إبراهيم النابلسي" الذي حمل بندقيته بعده بسنوات. الفعل ينتج فعلاً آخر، كما ينتج ثقافة تعيد تغذية هذا الفعل وتوليده وتطويره.
نجد هذا المبدأ متجسداً في وصية تركها الشهيد "عدي التميمي"، تحديداً في قوله: "أعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا واضع هدفاً أمامي، أن تحرك العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية بعدي". الرابط بينهم ليس معنوياً فقط، إنما هو رابط اجتماعي مباشر بين أصدقاء وأقارب أيضاً، هذا واضح جداً في مخيم جنين ونابلس.
أما "كي الوعي"، الذي راهنت عليه إسرائيل في الضفة الغربية، كما راهنت عليه في عدوانها المجنون على قطاع غزة عام 2008، وكررته مرات عدة عله يعطي نتائج، فهو كما يبدو يورث الأجيال اللاحقة ذاكرة محرضة على الفعل، والفعل في هذه الحالة هو ضرورة التحرر من عبء تلك الذاكرة وثقلها.
رغم كل تلك العقود، ما زالت إسرائيل، كما يبدو، تخطئ في قراءة سيكولوجيا الإنسان الفلسطيني، وإلا لما نشرت الفيديو الذي يوثق لحظة المواجهة الأخيرة مع الشهيد التميمي، ظنت أنها بذلك تكسر صورة البطل، ولكن لا شك أن تلك اللحظة قد سكنت في مخيلة أبناء جيله، تحرضهم على محاكاة بطولة بهذا القدر من الاستثنائية.