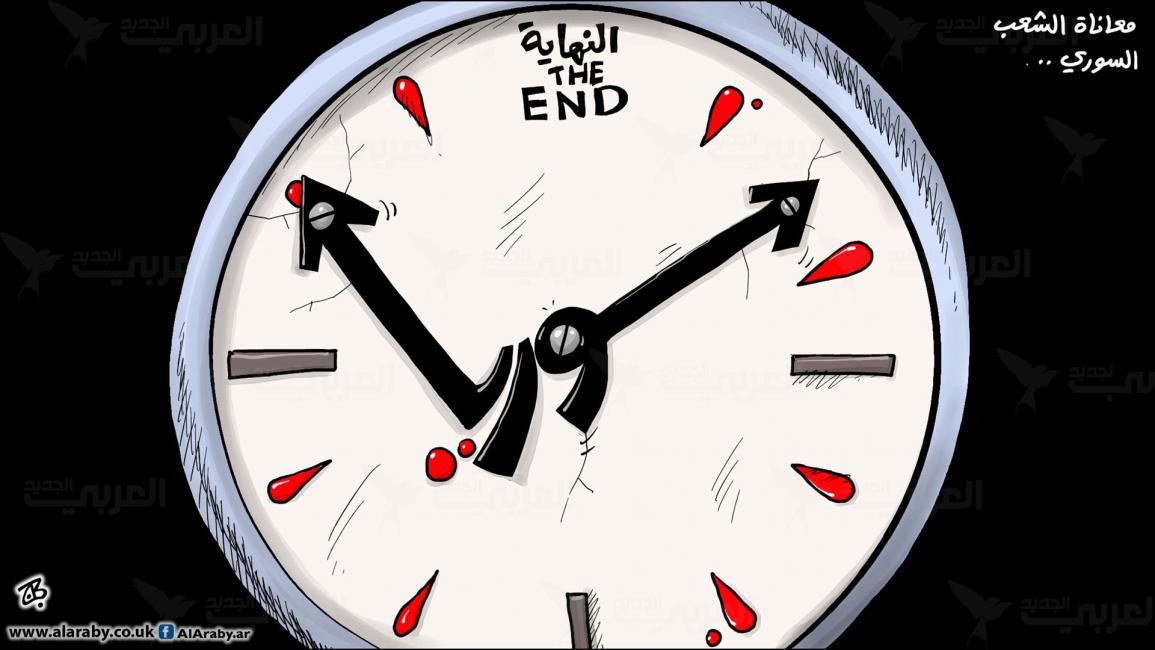12 نوفمبر 2024
ربيع الاستقلال السوري القصير وشتاء الاستبداد الطويل

عبد الباسط سيدا
كاتب وسياسي سوري، دكتوراه في الفلسفة، تابع دراساته في الآشوريات واللغات السامية في جامعة ابسالا- السويد، له عدد من المؤلفات، يعمل في البحث والتدريس.
شهدت المرحلة التي تلت الاستقلال في سورية حياة سياسية نشطة، وعرفت النظام البرلماني الحر. وتم التوافق على دستور عصري، وفق مقاييس تلك المرحلة، راعى الخصوصية السورية، غير أن تلك المرحلة أجهضت بسلسلة من الانقلابات العسكرية التي كانت نتيجة التفاعل بين المخططات الدولية والنزعة المغامراتية الشخصية لدى بعض العسكريين. وأخيراً سيطر حزب البعث على الحكم في سورية، متسلحاً بالأيديولوجية القومية - الاشتراكية، وذلك بعد تجربتي الوحدة مع مصر (1958 - 1961) والانفصال عنها في 1961. وإذا أخذنا المسافة الزمنية بين عامي الاستقلال 1946 وانقلاب حزب البعث 1963 نجدها مسافة زمنية قصيرة جداً في عمر الدول (في حدود 17 عاماً)، فهي أقل، على سبيل المثال، من الفترة التي قضاها بشار الأسد في حكم البلد منذ عام 2000.
أما المسافة الزمنية بين انقلاب "البعث" وسيطرة حزب حافظ الأسد على مقاليد الحكم السوري فهي جد قصيرة، سبعة أعوام، كانت متخمة بالصراعات بين مختلف القادة الحزبيين الذين كانوا في الوقت نفسه قادة الدولة والجيش. وقد بذل حافظ الأسد، في السنوات الأولى من حكمه، جهوداً لافتة على المستويين، الداخلي والإقليمي، وحتى على المستوى الدولي، لاستمرار حكمه، فأسس الجبهة الوطنية التقدمية التي تمكّن من خلالها من تدجين الأحزاب المعارضة، خصوصا الحزب الشيوعي، وتمكّن من الحد من نفوذه الشعبي بين طلبة الجامعات والجيش. كما نجح حافظ الأسد في استمالة تجار المدن، خصوصا في دمشق وحلب، ونسج علاقات متينة مع المؤسسات الدينية الرسمية، خصوصا السنية منها. وفي الوقت ذاته، سوّق نفسه بطلاً للتحرير بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، واستعادة القنيطرة بموجب اتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل.
وقرّر حافظ الأسد الحسم العسكري مع القوى الإسلامية، ومع الإخوان المسلمين تحديداً،
والأجنحة المحسوبة عليهم في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات. وكان الصراع في جوهره على السلطة، أما الأيديولوجيا التعبوية التي اعتمدها كل طرف، فقد كانت عابرة للحدود السورية. اعتمدت السلطة الأيديولوجيا القومية العلمانية، واعتمد الطرف الآخر الأيديولوجيا الدينية المشوبة بنكهةٍ قومية. وفي خضم الصراع العنيف بين الطرفين، التزم معظم السوريين الصمت، لأن الطرف الآخر المبشر بالأيديولوجيا الدينية لم يكن يطرح ما يطمئن، بل اتخذ الصراع طابعاً طائفياً أثار هواجس الناس، الأمر الذي كان لمصلحة السلطة.
وبعد حسم الصراع لصالح حافظ الأسد الذي مارس بطشاً غير مسبوق في تاريخ البلاد ضد الإسلاميين، وارتكب المجازر في مدينة حماه التي تعرّضت للتدمير، أصبح المذكور الحاكم المطلق في أمره، واستطاع، بفعل استخدامه الذكي الأوراق الإقليمية، سواء اللبنانية أم الفلسطينية والعراقية، وحتى الكردية، من أداء دور إقليمي، خصوصا بعد خروج مصر من المعادلة العربية في مواجهة إسرائيل، وبعد التخلص من وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
استغل حافظ الأسد ظروف الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988)، فبدأ بنسج العلاقات مع النظام الإيراني الجديد الذي كان يرى فيه عوناً له لمواجهة خصمه اللدود صدام حسين الذي كان يمثل التهديد المستمر على نظامه، لا سيما أنهما كانا يتقاسمان الأيديولوجيا القومية ذاتها، والتوجه العلماني البراغماتي ذاته، بل الحزب نفسه، هذا إلى جانب القدرة على توظيف التنظيمات المتطرّفة. ومن ثم جاءت حرب تحرير الكويت (1990 – 1991) التي وفرت فرصة ذهبية لنظام حافظ الأسد، فالحرب كانت بداية النهاية لنظام صدام حسين. كما كانت مناسبة مكّنت الأسد من بناء علاقاتٍ أعمق مع الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في
أجواء بواكير انهيار الإمبراطورية السوفييتية.
لقد وظف حافظ الأسد مشروعه الإقليمي لتعزيز نظام حكمه العائلي، واستغل الطائفة أداة لضبط الأوضاع على المستوى الأمني القمعي في جميع المناطق السورية. كما استخدم الشعارات القومية بغرض إيهام غالبية السوريين وتضليلهم. ولم يسع إلى إنجاز المشروع الوطني السوري على أساس احترام الحقوق والخصوصيات والمشاركة العادلة في الإدارة والثروات، فهو كان على يقين بأن مشروعا كهذا يتعارض بالمطلق مع مشروعه العائلي التسلطي الذي حرص على استمراريته عبر التوريث الذي فرضه على رموز الحزب والدولة عبر الضباط الموالين المرتبطين به عضوياً. وبغرض السيطرة، شجع الأسد إثارة النزعات المذهبية والقومية، وحتى الجهوية المناطقية. وعوضاً عن النهوض بالريف، من خلال مشاريع تنموية، عمد إلى أسلوب ترييف المدن الكبيرة، خصوصا دمشق التي كان يدرك تماماً أن السيطرة عليها تعني السيطرة على سورية كلها. وقد أخذ عنه نجله بشار هذا الدرس، وطبّقه منذ بدايات الثورة السورية. إذ ركز على الاحتفاظ بدمشق، حتى ولو اضطر للانسحاب من معظم المناطق السورية. وكان غرضه إبعاد دمشق، وبأي ثمن، عن الثورة، وقد استند في ذلك إلى أجهزته القمعية، وإلى شبكة العلاقات الزبائنية الواسعة مع رجال الأعمال الدمشقيين ورجال الدين القريبين أو المقرّبين من النظام.
ما يخرج السوريين من الدوامة التي تطحنهم راهناً، وينقذ بلادهم من مشاريع النفوذ، وربما التقسيم، هو مشروع وطني محوره حيادية الدولة، فالدولة جهاز إداري من مصلحة الجميع أن
تكون في منأى عن الأيديولوجيات المبنية على الهويات القومية أو الدينية أو المذهبية، حتى يشعر الجميع بأنها تخصهم، لا تتعامل معهم بعقلية تمييزية، بل تطبق القانون على الجميع، وتحرص على طمأنة الجميع. تعمل على حل المشكلات، والنهوض بكل المناطق عن طريق توفير فرص التعليم والعمل وتأمين الخدمات؛ ومعالجة القضايا الخلافية وفق آلية دستورية قانونية، تقرها مؤسسات منتخبة.
ولعله من نافل الأمور هنا الإشارة إلى أن مبدأ حيادية الدولة لا ينفي حقيقة أن غالبية السوريين هم من العرب السنّة. وأن سورية ترتبط بعلاقات تاريخية اجتماعية اقتصادية ثقافية مع محيطها العربي. نحن لا نشكك في الواقع القائم، بل ندعو إلى البناء عليه، والاستفادة من علاقة سورية مع محيطها العربي والكردي والتركي، لصالح المشروع الوطني الذي أساسه تعزيز الثقة بين السوريين، بممارسات واقعية ملموسة، وذلك لن يكون من دون ترميم النسيج المجتمعي السوري الذي أنهكته عقود من سياسات وممارسات حكم مستبد فاسد مفسد. وقد بلغت هذه الممارسات ذروتها السلبية مع بدايات انطلاقة الثورة السورية، وما زالت مستمرة، فقد أدخل نظام حكم العائلة القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها إلى جانب مليشيات حزب العمال الكردستاني والقوات الروسية إلى سورية بغرض حماية نفسه. كما مهد الطريق أمام دخول الفصائل الإسلامية المتطرفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة. بل أسهم في تشكيلها، وتبادل الأدوار معها من أجل إقناع السوريين والرأي العام الدولي بأن ما يجري في البلاد إنما هو صراع بين نظام علماني حامٍ للأقليات وإرهابيين، "حاضنتهم الأغلبية السنية".
ما نحتاج إليه هو الاستفادة من روابط السوريين وانتماءاتهم ووضعها في خدمة المصلحة السورية، وذلك ضمن إطار مشروع وطني واقعي، يركز على سورية الوطن، ويأخذ بالاعتبار أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل جميع المشكلات الداخلية والإقليمية بالحوار والتفاهم وعلى أساس تبادل المصالح، ولنا في تجربة سويسرا مثال رائد، فقد استطاع هذا البلد الصغير المحافظة على استقلاله، وحقق قفزات اقتصادية نوعية. ولم تكن الانتماءات القومية والدينية المتباينة مشكلة له في يوم ما، بل استطاع التوفيق بين جميع مكوناته على أساس احترام الحقوق والخصوصيات، والتزام التوجه العقلاني في التعامل مع الدول الكبرى المتاخمة له ( ألمانيا، فرنسا، إيطاليا)، التي لم تستغل ورقة السويسريين الذين يشاركون معها في الانتماء القومي أو المذهبي.
الحلول الإيجابية الواقعية ممكنة، شرط التحرّر من أوهام النزعات العصبوية، وقطع الطريق أمام القوى التي تستغل تلك النزعات لصالح مشاريعها الخاصة، خصوصا تلك العابرة للحدود. وتستوجب عملية التحرر هذه التعامل مع الواقع، وأخذ تناقضات ومآلات عشرة أعوام من التدمير والقتل والتهجير بعين الاعتبار، والتعامل معها بحكمةٍ بعيدة النظر، تنبذ النزعة الانتقامية، وتبعد الأحكام المسبقة السوداوية؛ حكمة تبني على القواسم المشتركة بين السوريين، كل السوريين، من دون تمييز أو استثناء.
وقرّر حافظ الأسد الحسم العسكري مع القوى الإسلامية، ومع الإخوان المسلمين تحديداً،
وبعد حسم الصراع لصالح حافظ الأسد الذي مارس بطشاً غير مسبوق في تاريخ البلاد ضد الإسلاميين، وارتكب المجازر في مدينة حماه التي تعرّضت للتدمير، أصبح المذكور الحاكم المطلق في أمره، واستطاع، بفعل استخدامه الذكي الأوراق الإقليمية، سواء اللبنانية أم الفلسطينية والعراقية، وحتى الكردية، من أداء دور إقليمي، خصوصا بعد خروج مصر من المعادلة العربية في مواجهة إسرائيل، وبعد التخلص من وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
استغل حافظ الأسد ظروف الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988)، فبدأ بنسج العلاقات مع النظام الإيراني الجديد الذي كان يرى فيه عوناً له لمواجهة خصمه اللدود صدام حسين الذي كان يمثل التهديد المستمر على نظامه، لا سيما أنهما كانا يتقاسمان الأيديولوجيا القومية ذاتها، والتوجه العلماني البراغماتي ذاته، بل الحزب نفسه، هذا إلى جانب القدرة على توظيف التنظيمات المتطرّفة. ومن ثم جاءت حرب تحرير الكويت (1990 – 1991) التي وفرت فرصة ذهبية لنظام حافظ الأسد، فالحرب كانت بداية النهاية لنظام صدام حسين. كما كانت مناسبة مكّنت الأسد من بناء علاقاتٍ أعمق مع الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في
لقد وظف حافظ الأسد مشروعه الإقليمي لتعزيز نظام حكمه العائلي، واستغل الطائفة أداة لضبط الأوضاع على المستوى الأمني القمعي في جميع المناطق السورية. كما استخدم الشعارات القومية بغرض إيهام غالبية السوريين وتضليلهم. ولم يسع إلى إنجاز المشروع الوطني السوري على أساس احترام الحقوق والخصوصيات والمشاركة العادلة في الإدارة والثروات، فهو كان على يقين بأن مشروعا كهذا يتعارض بالمطلق مع مشروعه العائلي التسلطي الذي حرص على استمراريته عبر التوريث الذي فرضه على رموز الحزب والدولة عبر الضباط الموالين المرتبطين به عضوياً. وبغرض السيطرة، شجع الأسد إثارة النزعات المذهبية والقومية، وحتى الجهوية المناطقية. وعوضاً عن النهوض بالريف، من خلال مشاريع تنموية، عمد إلى أسلوب ترييف المدن الكبيرة، خصوصا دمشق التي كان يدرك تماماً أن السيطرة عليها تعني السيطرة على سورية كلها. وقد أخذ عنه نجله بشار هذا الدرس، وطبّقه منذ بدايات الثورة السورية. إذ ركز على الاحتفاظ بدمشق، حتى ولو اضطر للانسحاب من معظم المناطق السورية. وكان غرضه إبعاد دمشق، وبأي ثمن، عن الثورة، وقد استند في ذلك إلى أجهزته القمعية، وإلى شبكة العلاقات الزبائنية الواسعة مع رجال الأعمال الدمشقيين ورجال الدين القريبين أو المقرّبين من النظام.
ما يخرج السوريين من الدوامة التي تطحنهم راهناً، وينقذ بلادهم من مشاريع النفوذ، وربما التقسيم، هو مشروع وطني محوره حيادية الدولة، فالدولة جهاز إداري من مصلحة الجميع أن
ولعله من نافل الأمور هنا الإشارة إلى أن مبدأ حيادية الدولة لا ينفي حقيقة أن غالبية السوريين هم من العرب السنّة. وأن سورية ترتبط بعلاقات تاريخية اجتماعية اقتصادية ثقافية مع محيطها العربي. نحن لا نشكك في الواقع القائم، بل ندعو إلى البناء عليه، والاستفادة من علاقة سورية مع محيطها العربي والكردي والتركي، لصالح المشروع الوطني الذي أساسه تعزيز الثقة بين السوريين، بممارسات واقعية ملموسة، وذلك لن يكون من دون ترميم النسيج المجتمعي السوري الذي أنهكته عقود من سياسات وممارسات حكم مستبد فاسد مفسد. وقد بلغت هذه الممارسات ذروتها السلبية مع بدايات انطلاقة الثورة السورية، وما زالت مستمرة، فقد أدخل نظام حكم العائلة القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها إلى جانب مليشيات حزب العمال الكردستاني والقوات الروسية إلى سورية بغرض حماية نفسه. كما مهد الطريق أمام دخول الفصائل الإسلامية المتطرفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة. بل أسهم في تشكيلها، وتبادل الأدوار معها من أجل إقناع السوريين والرأي العام الدولي بأن ما يجري في البلاد إنما هو صراع بين نظام علماني حامٍ للأقليات وإرهابيين، "حاضنتهم الأغلبية السنية".
ما نحتاج إليه هو الاستفادة من روابط السوريين وانتماءاتهم ووضعها في خدمة المصلحة السورية، وذلك ضمن إطار مشروع وطني واقعي، يركز على سورية الوطن، ويأخذ بالاعتبار أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل جميع المشكلات الداخلية والإقليمية بالحوار والتفاهم وعلى أساس تبادل المصالح، ولنا في تجربة سويسرا مثال رائد، فقد استطاع هذا البلد الصغير المحافظة على استقلاله، وحقق قفزات اقتصادية نوعية. ولم تكن الانتماءات القومية والدينية المتباينة مشكلة له في يوم ما، بل استطاع التوفيق بين جميع مكوناته على أساس احترام الحقوق والخصوصيات، والتزام التوجه العقلاني في التعامل مع الدول الكبرى المتاخمة له ( ألمانيا، فرنسا، إيطاليا)، التي لم تستغل ورقة السويسريين الذين يشاركون معها في الانتماء القومي أو المذهبي.
الحلول الإيجابية الواقعية ممكنة، شرط التحرّر من أوهام النزعات العصبوية، وقطع الطريق أمام القوى التي تستغل تلك النزعات لصالح مشاريعها الخاصة، خصوصا تلك العابرة للحدود. وتستوجب عملية التحرر هذه التعامل مع الواقع، وأخذ تناقضات ومآلات عشرة أعوام من التدمير والقتل والتهجير بعين الاعتبار، والتعامل معها بحكمةٍ بعيدة النظر، تنبذ النزعة الانتقامية، وتبعد الأحكام المسبقة السوداوية؛ حكمة تبني على القواسم المشتركة بين السوريين، كل السوريين، من دون تمييز أو استثناء.


عبد الباسط سيدا
كاتب وسياسي سوري، دكتوراه في الفلسفة، تابع دراساته في الآشوريات واللغات السامية في جامعة ابسالا- السويد، له عدد من المؤلفات، يعمل في البحث والتدريس.
عبد الباسط سيدا
مقالات أخرى
29 أكتوبر 2024
15 أكتوبر 2024
17 سبتمبر 2024