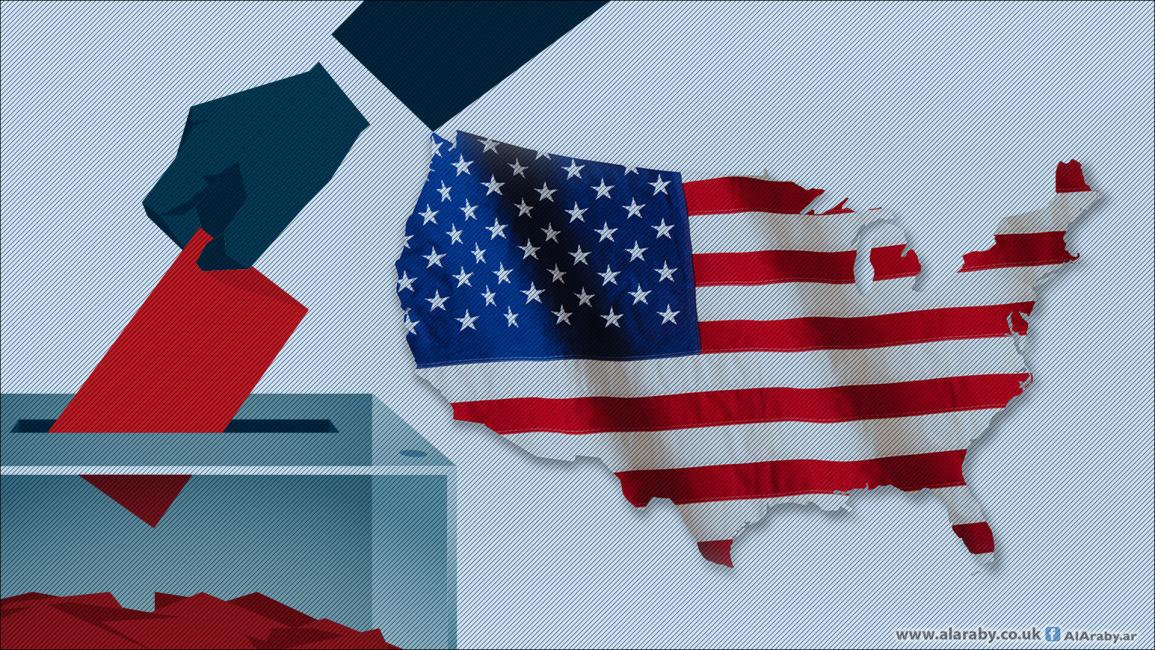الاستثناء والقاعدة .. ماذا يختار الأميركيون؟

باحث سوري في قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. عضو في المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين ورئيس تحرير موقع "سيريان أبزرفر" ومسؤول تحرير في موقع الأوان.
لا يحبّ الأميركيون كثيراً أن يمنحوا ثقتهم لسياسييهم طويلاً. ولعلّ واحدةً من أكثر القواعد صرامة في السياسة الأميركية أن يخسر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفي. ولم ينجُ أيّ رئيس تقريباً من هذا المصير منذ ثلاثة أرباع القرن. ففي عهد الرئيس جيمي كارتر، عندما كانت مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة تشبه إلى حدّ بعيد مشكلات الإدارة الحالية، كان الديمقراطيون يسيطرون أيضاً على مجلسي الكونغرس. وقد بذلت إدارة كارتر الممكن وغير الممكن للاحتفاظ بمجلسي الكونغرس تحت جناح الديمقراطيين، فأنشأت وزارة جديدة للطاقة، وأعادت تنظيم الخدمة المدنية، وسنّت لوائح جديدة تنظّم استخراج الغاز الطبيعي، وقانون التجارة، وأقرّت معاهدة قناة بنما. وحقّقت إدارة كارتر أكبر نصر في السياسة الخارجية، عندما جمعت الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن في كامب ديفيد، منهية الصراع التاريخي بين مصر والدولة العبرية. مع ذلك، في انتخابات التجديد النصفي لعام 1978، خسر الديمقراطيون 15 مقعداً في مجلس النواب وثلاثة مقاعد في مجلس الشيوخ. وفي عهد الرئيس جورج دبليو بوش، تلقى الجمهوريون ضربة صاعقة في انتخابات 2006. وتلقى ديمقراطيو الرئيس باراك أوباما خسارة أشدّ في عام 2010. وفي 2018، كان الجمهوريون يسيطرون على مجلسي النوّاب والشيوخ في الكونغرس، وكان الرئيس دونالد ترامب في أوج شعبيته، لكنّ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 جاء، وخسر الجمهوريون مجلس النوّاب، وبالكاد حافظوا على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان حزب الرئيس يحظى باستمرار بنسبة أقل من التصويت الشعبي في مجلس النواب في الانتخابات النصفية، مقارنةً بالانتخابات الرئاسية التي سبقتها. وقد تكرّر ذلك في 19 انتخاباً نصفياً جرت بين 1946 و2018، فخسر حزب الرئيس 18 مرّة ولم ينجُ من هذا المصير سوى جورج دبليو بوش، الذي استطاع ذلك في انتخابات 2002 بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية التي سبقت الانتخابات بعام، فارتفعت حصّته في التصويت الشعبي في مجلس النواب.
اليوم، يسيطر الديمقراطيون مرة أخرى على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض. ورغم أنّ الرئيس جو بايدن ليس أكثر الرؤساء شعبية وتألّقاً، فقد استطاع أن يحقّق عدداً لا بأس به من الإنجازات، أهمها مشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة نتائج جائحة كوفيد- 19، ومشروع قانون البنية التحتية، ومشروع قانون أشباه الموصلات، ومشروع قانون سلامة المحاربين القدامى، وقانون خفض التضخّم، وأعفى الرئيس بايدن نحو أربعة ملايين طالب وخرّيج جامعي من عشرة آلاف دولار من ديون كلّ منهم. كما نجح الديمقراطيون في تثبيت تعيين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا في تاريخ الولايات المتحدة. ونجح بايدن في قتل أحد أهمّ أعداء الولايات المتحدة: زعيم تنظيم القاعدة المتطرّف أيمن الظواهري. وفي المقابل، تقف أمور كثيرة في الكفّة الثانية من الميزان، لعلّ أهمّها التضخم والانسحاب المعيب من أفغانستان.
قاعدة ترامب ليست قادرة على الانتصار له في انتخابات 2024 إذا ما قرّر أن يرشّح نفسه، وهي لن تستطيع الانتصار له حالياً
عصف التضخم وارتفاع الأسعار بالحياة الأميركية في العامين الأخيرين، واضطر كثيرون إلى تغيير عاداتهم الشرائية ونمط الحياة. ووفق كبير المسؤولين الماليين في أكبر هايبر ماركت شعبي أميركي (وول مارت)، جون ريني، بات الأميركيون يشترون أكثر من قبل "النقانق والتونة المعلبة والدجاج" بدلاً من اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات. ولا يعدو هذا أنّ يكون مثالاً واحداً على كيفية تغيير المستهلكين الأميركيين عاداتهم الشرائية للتعامل مع أعلى معدّل تضخّم في 40 عاماً. وهنالك أمثلة أخرى لا حصر لها: صار الأميركيون يقودون سياراتهم أقلّ لتوفير ثمن الوقود، ويشترون طعاماً أرخص، ويختارون مزيداً من العلامات التجارية الرخيصة، ويقلّلون من تناول الطعام في الخارج، ويخفّضون من الإنفاق على الملابس والكماليات. وباختصار، تتغيّر يومياً عادات الشراء لدى المستهلك بشكل كبير، ما يضع ضغطاً شديداً على تجار التجزئة، ومن ثمّ على الاقتصاد ككلّ، وهو ما ينعكس بالتأكيد على شعبية الرئيس بايدن والديمقراطيين.
أما أفغانستان فما زالت بالنسبة للسيرة السياسية للرئيس جرحاً نازفاً. جاء الانسحاب الارتجالي للقوات الأميركية من هناك ليبين سوء إدارة الأميركيين هذا البلد وحجم الفساد المريع فيه وهشاشة الحكومة الأفغانية، التي فشلت خلال عشرين سنة من أن تشكّل جيشاً يحمي البلاد أكثر من أسبوع. وما زالت صورة الرئيس الديمقراطي، ورأسه منحنٍ في وضع كئيب في لحظةٍ خلال كلمته في مؤتمر صحافي، تملأ وسائل التواصل الاجتماعي. ومشكلة أفغانستان أنّ الديمقراطيين والجمهوريين قد عارضوها معة، وهي بالتأكيد ستسبّب صداعاً مستمرّاً له في السنوات المقبلة.
أسدى ترامب للديمقراطيين خدمة كبيرة بدعمه مرشّحين غير أكفاء، وفي تاريخ بعضهم نقاط سود
التاريخ، إذاً، والوقائع، كلاهما يؤكّد أنّ حظوظ الديمقراطيين في نوفمبر/ تشرين الثاني قليلة. ولنتذكّر أنّ أهم قانون صدر في العقدين الأخيرين كان قانون التأمين الصحي الذي تسهم فيه الدولة، والمعروف باسم "أوباما كير" والذي قدّم مساعدات لملايين الأميركيين ليحصلوا على تأمين صحي كانوا يفتقدونه، لم ينقذ الرئيس أوباما، الذي كان أكثر شعبية من بايدن، من خسارة 63 مقعداً في مجلس النواب وستة مقاعد في مجلس الشيوخ في انتخابات 2010 النصفية. على أنّ المنطق يقول إنّ لكلّ قاعدة استثناءها، ولكلّ انتخابات عوامل خاصة بها. وما يميّز انتخابات هذا العام هو الدور الاستثنائي الذي يلعبه الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، بشكلٍ مباشر وغير مباشر. ولم يلعب أيّ رئيس سابق مثل هذا الدور في المائة سنة الفائتة، أي منذ أن داعبت الرئيسَ الأسبقَ ثيودور روزفلت فكرةُ الترشّح لانتخابات الرئاسة لعام 1920، كما يفعل دونالد ترامب الآن.
سوف يستخدم الديمقراطيون الرجل كفزّاعة، فرغم القاعدة الشعبية الثابتة التي تؤيّد ترامب بشكل أعمى، وتتراوح بين 35% و40%، فإنّ رهان الانتخابات دوماً على المستقلين والمتقلّبين ومن هم بين بين. والأكيد أنّ قاعدة ترامب ليست قادرة على الانتصار له في انتخابات 2024 إذا ما قرّر أن يرشّح نفسه، وهي لن تستطيع الانتصار له حالياً. ويمكن القول إنّ ترامب قد أسدى للديمقراطيين خدمة كبيرة بدعمه مرشحين غير أكفاء في تاريخ بعضهم نقاط سود، فتبنّيه أشخاصاً مثل النجم التلفزيوني دكتور أوز الذي يهتم بالربح الشخصي أكثر من الدستور، ولاعب الكرة الأميركي السابق هيرتسل ووكر الذي يبدو مهرّجا أكثر منه رجل دولة، إنّما يشجّع المحايدين والمستقلين على اختيار شخصياتٍ أكثر احتراماً وصدقية.
صار الأميركيون يقودون سياراتهم أقلّ لتوفير ثمن الوقود، ويشترون طعاماً أرخص، ويختارون مزيداً من العلامات التجارية الرخيصة
وبقيت نقطتان حاسمتان. في يونيو/ حزيران الفائت، وجّهت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون المتعصّبون ضربة قاصمة للحقوق المدنية وللنساء والحريات السياسية، عندما ألغت حقّ النساء في الإجهاض. وقد لعبت هذه المسألة، وما زالت، دوراً كبيراً في الحملات الانتخابية للديمقراطيين في كلّ الولايات، وهنالك من يعتقد أنّها قد تعطي نتيجة مختلفة. والحال أنّ هجوم المحافظين على الحريات المدنية ليس أقلّ كثيراً من هجوم الإرهابيين على برجي مركز التجارة العالمية في 2001.
وسبقت ذلك، في شهر مايو/ أيار، مأساة مقتل 23 تلميذاً في مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس، ومعهم معلّمتان. وعلى الرغم من أنّ الأميركي سريع النسيان، ستظلّ هذه الحادثة راسخة في ذاكرته حتى انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، ويمكن أن تلعب دوراً في إنقاذ الديمقراطيين. أقول: "يمكن"، لأنّ أحداً لا يستطيع أن يتنبّأ بنتائج الانتخابات قبل صباح 9 نوفمبر/ تشرين الثاني في اليوم التالي لتاريخ الانتخابات. ولذلك يُحجم زعيما الديمقراطيين والجمهوريين، شومر وماكونيل، عن التفاؤل في هذه المرحلة الحرجة. ومن يدري، فقد تحدُث المفاجأة، وربما يبرز هذا العام في التاريخ باعتباره استثناء القاعدة، من الأمثلة السابقة. ولنتذكّر القول المأثور لمدرّب كرة السلة أدولف روب: "إنّنا نلعب المباراة لنرى من يفوز".


باحث سوري في قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. عضو في المكتب التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين ورئيس تحرير موقع "سيريان أبزرفر" ومسؤول تحرير في موقع الأوان.