بحلول القرن الثاني، شهِد المسلمون تحوّلين أساسيين يتصل أوّلهما بتطوّر المعارف مع حركة الترجمة والنقول عن اليونانية والفارسية والهندية، وإن كانت بداياتها تعود إلى مرحلة أقدم، إذ قادت إلى نهضة شاملة كرّست تقاليد وأعرافاً في تلقّي العلم، ومُنحت مكانة اجتماعية وسياسية مرموقة لأصحابه لم تعطَ لهم من قبل.
وارتبط التحوّل الثاني بأخذ الصراع السياسي والفكري بين الفرق والتيارات المتصارعة طابعاً أيديولوجياً تناظرياً، في لحظة تاريخية أصبحت بغداد، ومدن العراق، حواضر كوزموبوليتية تستقطب النخب من جميع أنحاء الدولة الإسلامية، والتي بات لزاماً عليها أن تستوعبهم في مناخ من الانفتاح والتعدّد النسبي، وتُطوّر في الوقت نفسه جهازاً دعائياً قوياً يفرض هيمنتها الثقافية.
وتأسّس جزء كبير من هذه الدعاية على تنظيرات شخصية واحدة امتلكت وعياً وسعة معرفة واطلاعاً لم يؤتَ لواحد من المشتغلين في الشأن العام خلال عصره، وهي أبو عثمان عمرو بن بحر الملقّب بـ"الجاحظ" (776 – 868 م) الذي كان يواجه خصومه بكلّ ما اختزنه من علوم وإمكانيات في الجدال، إلى درجة لم يستغنِ عنه الحكْم في مرحلة كان من أشدّ المختلفين معه فكراً ووجهات نظر.
ميّزات استحقّها صاحب كتاب "الحيوان" وصادق عليها مجايلوه، ومن أتوا بعده كذلك، فقد ظلّت أعماله موضع درس وقراءة حتى يومنا هذا ضمن استعادات متنوّعة له ناقداً ومفكّراً وفيلسوفاً ورجل سياسة وباحثاً في العلوم الطبيعية، وهو فوق ذلك كلّه كاتب استطاع أن يتفوّق على كتّاب عصره ويُحدث نقلة نوعية في المنهج والأسلوب خلقت مقلّدين لمدرسة أو تيار حملت اسمه لقرون لاحقة.
يتناول كتاب "رؤيةُ الجاحظ في عصرَي بني أُميَّة وبني العبّاس (41 – 255 هـ/ 661-868م)" الذي صدر حديثاً للباحث العُماني سليم الهنائي عن "الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء" و"الآن ناشرون وموزعون" الروايات التاريخية التي تضمّنتها أعماله والتي تكشف عن رؤيته التي "لم تأتِ مباشِرةً وواضحة في كتاب أو رسالة من رسائله بل جاءت عبر روايات مبثوثة في مختلف كتبه"، كما ورد في التقديم.
يوضّح المؤلّف أن دراسة صاحب "البيان والتبيين" بوصفه مؤرخاً، قد استحوذت على عدد من الباحثين في الآونة الأخيرة، ويشترك معهم في التأكيد على أن مقاربته للوقائع والأحداث كانت تستند في جزء مهم منها إلى فكره كواحد من أبرز رموز العقلانية في زمنه، مؤمناً بقيم أساسية لبناء الدول في مقدّمتها العدل والانفتاح على الحضارات والحوار القائم على الاختلاف والتنوّع.
وليس غريباً أن يرى الجاحظ أن وظيفة الدولة الأولى تتمثّل في بناء الحضارة وإنتاج المعرفة، وهو موقف ينسجم مع طبيعة المتغيّرات الكبرى التي شهدتها العلوم في العهد العباسي، مع تطوّر تصنيفها ومحتواها والتحوّل في وظيفتها لتساهم في التخطيط ووضع سياسات الدولة وخطابها، وهو دور استوعبه باكراً وعلى نحو متقدّم.
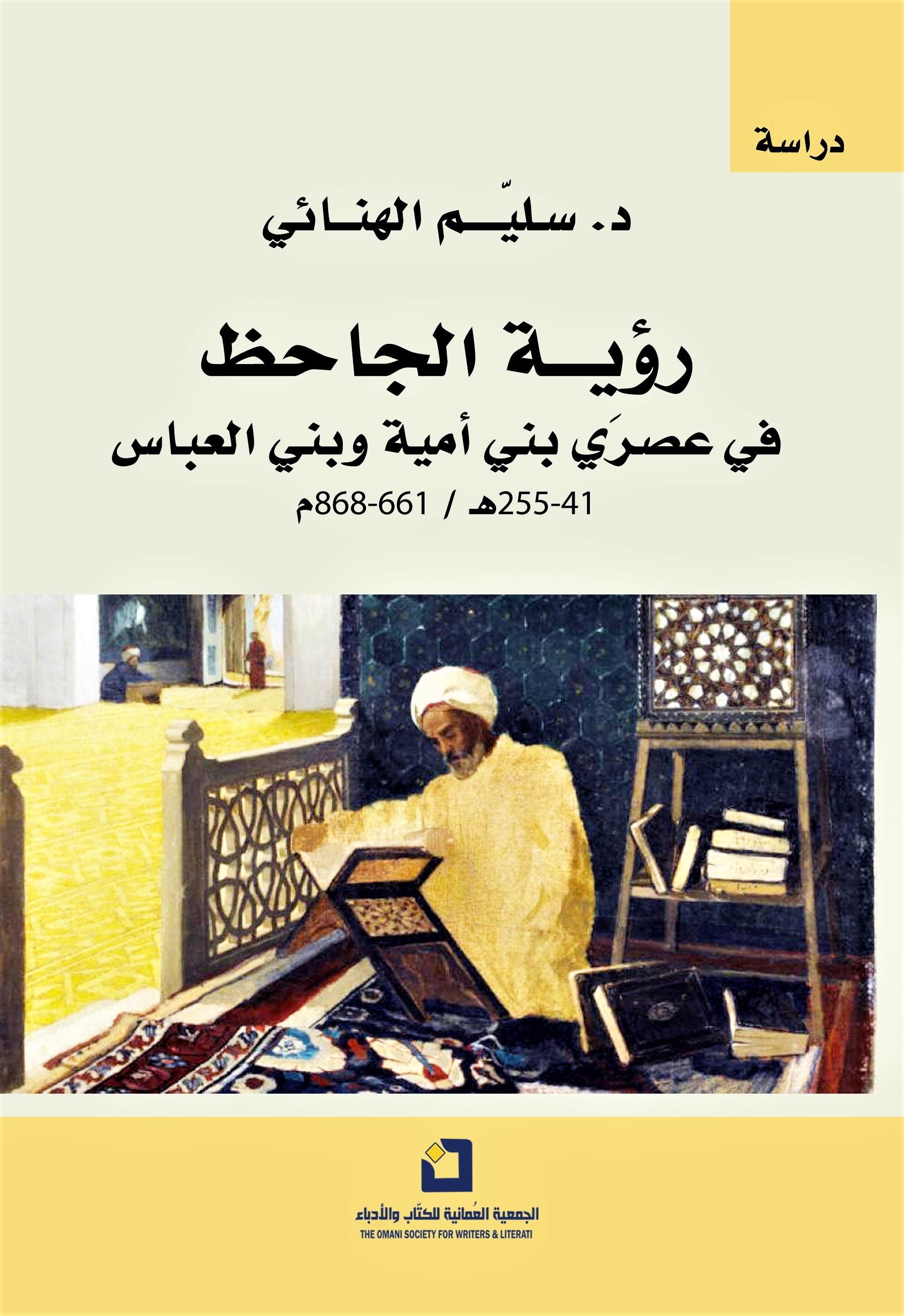 هنا، يشير الكتاب إلى نقطة مهمّة تبيّن كيفية فهم صاحب كتاب "البخلاء" العلاقة مع السلطة، التي دافع عن مشروعيتها ومشروعها، وتنبّهت من جهتها إلى وجاهة طرحه وقُدرته على تفكيك الطروحات المغايرة، لكنها حين منحته منصب رئيس ديوان الرسائل في زمن المأمون مكافأة له على رسالته في "استحقاق الخلافة"، لم يصبر على "نفاق" الموظفّين كما وصفه، فاستقال بعد ثلاثة أيام فقط حين أدرك مدى حجم النفوذ الفارسي في دواوين الدولة، ودورهم في تحريك وتأجيج تيار الحركة الشعوبية، وأطلق مقولته الشهيرة "ظواهر نظيفة، وبواطن سخيفة".
هنا، يشير الكتاب إلى نقطة مهمّة تبيّن كيفية فهم صاحب كتاب "البخلاء" العلاقة مع السلطة، التي دافع عن مشروعيتها ومشروعها، وتنبّهت من جهتها إلى وجاهة طرحه وقُدرته على تفكيك الطروحات المغايرة، لكنها حين منحته منصب رئيس ديوان الرسائل في زمن المأمون مكافأة له على رسالته في "استحقاق الخلافة"، لم يصبر على "نفاق" الموظفّين كما وصفه، فاستقال بعد ثلاثة أيام فقط حين أدرك مدى حجم النفوذ الفارسي في دواوين الدولة، ودورهم في تحريك وتأجيج تيار الحركة الشعوبية، وأطلق مقولته الشهيرة "ظواهر نظيفة، وبواطن سخيفة".
وفق تلك المعادلة، نظر الجاحظ إلى نفسه باعتباره منظّراً لمشروع سياسي لا خادماً عنده، لا يغريه منصب وجاه لكنه يعلم جيداً كيف يأمن أذى السلطة وعقابها، كما يبرزه الكتاب حين يتطرّق إلى انقلاب المتوكل على المعتزلة وبطشه برموزها، حيث حفِظ الجاحظ مسافة تحميه كمعتزلي ومعارض لتصالح الخلافة مع خصمه أحمد بن حنبل، فالاختلاف في السياسة لا يعني خروجاً على الثوابت.
يعرض الهنائي لدور آخر يستوجب الانتباه، متمثّلاً في دفاع صاحب كتاب "المحاسن والأضداد" عن "اللّغة العربية وعن العروبة التي اتَّخذَتْ بُعداً ثقافيَّاً وفكريّاً جديداً. كما تصدّى للحركات الفكرية التي تستهدف الإسلام واللغة العربية"، بحسب الكتاب، مع الإشارة إلى أن انتماء الجاحظ العربي كان خياراً ولم يكن انتساباً، وهو "المولى" ذو البشرة السوداء.
آمن الجاحظ بحركة التاريخ وفق منحى تطوّري ظهر في جزء مهم من كتاباته، المتأخرة منها خاصةً، وفق الهنائي، والتي تحرّر فيها من الانحيازات السياسية التي اضطر إليها في بداية الحكم العباسي، حيث تحضر المقارنة في حديثه عن الأمويين بين هاتين المرحلتين، ففي الأولى كان يهاجمهم لمنح الشرعية لبني العباس وفي الثاني ذكَر محاسنهم وكان موضوعياً في تناول سير خلفائهم وصفاتهم.
في تحليل الجاحظ لخلاف عليّ ومعاوية لا يغيّب جميع العوامل التي ساهمت في ترجيح كفّة على أخرى، فينظر إلى المشهد بكليّته والعوامل التي صنعته متخلّصاً من أية آراء مسبقة – رغم فكره المعتزلي وولائه للدولة العباسية-، فلا يبدي مثلاً تعجبه من موقف معاوية المطالب بدم عثمان مشيراً إلى أن طلحة والزبير سبقاه إلى ذلك، أو في إشارته إلى تماسك جيش معاوية وتضعضع جيش علي، وإلى حكمة عمرو بن العاص ودوره في غلبة الأمويين، لكنه ظلّ يعتبر وصولهم إلى السلطة مبنياً على الحيلة وليس على اختيار المسلمين لهم.
أما دفاعه عن العباسيين، فأسّس له عبر تعظيم الروايات التاريخية التي أعلت من مكانة جدّهم عبد الله بن العباس وصلة قرابته بالنبي، وذكر مواقفه البارزة خاصة في عهد الخلفاء الراشدين مورداً أهمّ صفاته ومنها جزالة الرأي ونبوغه في الخطابة، والتبجيل الذي حظي به سواء عند علي بن أبي طالب وذريته أو لدى معاوية وبني أمية، وهي سمات تمنح بني العباس شرعية الحكم بحسب رأي الجاحظ الذي اعتبر أن تنازل أبناء علي عن الخلافة زمن الأمويين، لا يمنحهم الحق في المطالبه بها بعد ذلك.
ينبّه الكتاب إلى صمت الجاحظ عن حوادث عديدة تحرّج فيها عن إبداء موقفه، ومنها سكوته عن الخلاف بين الأمين والمأمون، وهو الذي كان منحازاً للأول بسبب انتصاره للعرب في مواجهة العجم والدعوات الشعوبية، لكنه عاد وتقرّب للثاني لتوافقهما على مبادئ الاعتزال، وكذلك لتشجيعه العلوم وإحداثه نهضة علمية أشاد بها مرّات عديدة في مؤلّفاته.
أما الفصل الأخير، فقد خُصّص لمواقفه من الحركات السياسية والفِرقِ الدينية؛ الشعوبية، والزندقة، والشيعة، والخوارج، والمعتزلة، وينبّه المؤلّف إلى أن تلك المواقف لم تعبّر فقط عن ميله إلى السلطة بمواجهة التيارات التي خاصمتها فحسب، إنما عكست فكره في معظم الأحيان من خلال منافحته عن فهمه الإسلام وإيمانه بالعروبة، خاصة حين أخذ الصراع مع العجم طابعاً يطعن بالعرب في نسبهم وعلمهم وتمكّنهم من اللغة والخطابة والأدب، فقدّم الجاحظ مرافعات تاريخية معتمداً على مصادر تاريخية لتفكيك الروايات المضادة، وبشكل أكبر على قدرته في الحجاج والجدال ودفع البراهين والإثباتات العقلية.
يلفت الهنائي إلى غاية رئيسة تفرّغ لها صاحب "التبصرة في التجارة" وتجسّدت في الردّ على الأفكار الشعوبية التي انتشرت، وهو المعروف بعدائه النزعة العنصرية لدى الفرس بالتحديد، مبيناً أن مؤلّفاته التي وضعها حول أنساب العرب وتاريخهم خلّدت آثاره مقارنة بتعرّض إرث المعتزلة إلى التلف في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.



