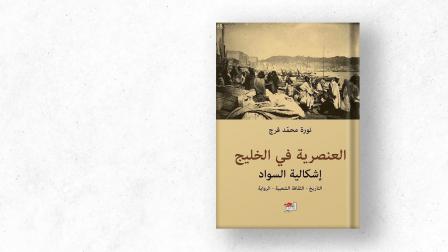في أيام طفولتي، لم تكن الفصولُ مجرد فصول تدلّ عليها الظواهر الطبيعية؛ بدا لي أنها تتجاوز كونها نتاج ميلان محور الأرض، إلى كونها مراحل زمنية يدلّ عليها أناسٌ يتجولون في عالم طفولتي، تجاراً وأساتذة وحرفيين.
وظننتُ من وقت لآخر أنهم بعض محاربين قدماء اعتادوا القتال، ليس بالأسلحة والآلات الحربية، ولكن بأدوات ومعدات بريئة. حتى أسماؤهم كانت تحتشد بأصواتٍ قديمة. البوسنيون قادمون.. المقدونيون.. الفلاخيون.. اليونان.. الصرب.. سكان الجبل الأسود.. كل هذه العبارات رنّت في سمعي مثل "الإليريون قادمون.. الإسبارطيون.. الميرميديون..".
كانت علامات حلول الخريف طقوسَ شتائم ولعنات يبدأ أقاربي بإطلاقها ضد الجولابورديين من مقدونيا الذين لا يصلون أبداً في الوقت المحدّد لإصلاح الجدران المتآكلة بفعل الرطوبة والسقوف الراشحة. وبعد ذلك نتوقع مجيء المهاجر، ذلك الرجل البوسني الذي يخصنا، بشاربه اللطيف وساعة جيبه ذات السلسلة، الذي اعتاد النزول من قرية شيجاك الصغيرة حاملاً تبغاً أصفر إلى جدّي، وخضراوات طازجة لعائلتي، وفواكه لامعة لنا نحن أطفال المنزل.
ومع اقتراب الربيع، نكون عرفنا مسبقاً أن جرابوفار الآروميني الذي يخصّنا، على وشك الظهور؛ ذلك الرجل الذي يقوم بصيانة مصارف مياهنا، وقنوات الريّ. أحياناً يبدو لإدراكي الساذج شبيهاً بساحر، ما عدا حين يبدأ الحديث عن نتائج الطين الشافي، عن ديدان العلق وفوائدها، مثل العلاج بالفصد. يؤمن أن العلق كان رسول الإله، ومهمته تطهيرنا. وآمن أن العلق أرسله ربنا: "لا تخافوا.. لا تقتلوه.. إنه مقدس.. إنه يمتص أسوأ ما فينا. إنه يفعل للإنسان ما تفعله الأشجار: تمتص الشرَّ منه. العلق والأشجار والمسيح قديسون؛ إنهم الثالوث المقدس". هذا ما كان يزعمه بجدية تامة.
لم نكن نحن الأطفال وحدنا نعرف، بل والكبار أيضاً، أن بداية الصيف ستشهد عودة الروما، الغجر من الهند، مرة أخرى إلى حيّنا، إلى المكان الذي نشأتُ فيه، في مكان ما عند أطراف مستنقع دورس. أربكني الروما (كان يدعى حيناً "المتشرد" و"الجوال"، وحيناً راج كابور نجم السينما الهندية الواقعي): "روما، روماي! أين تخبئ السيف ودرعك؟! روما، روماي، لماذا لا تلبس مثل الرومان الذين رأيتهم في الأفلام يا روماي؟! أنت بلا خوذة ولا فرقة! لماذا؟ ليس لديك سوى بعض الأحزمة يا روماي البائس، وقميص قصير الأكمام براق ذي أزهار مجففة يا روما!".
كان روما الخاص بنا، مختلفاً اختلافاً تاماً عن بقية الرومان. يجلب معه مسامير، يصلح عربات اليد، ويقوم بأي نوع من الأعمال اليدوية، بينما تتنبأ زوجه المحبوبة بالطالع، بقراءة خطوط الكف، أو تبيع، زيادة على ذلك، تلفيعات ومرايا ومناخل.
ما زلت أعزُّ تلك اللحظات التي كانوا يرتجلون فيها سيركاً صغيراً يعرض لنا نحن الصغار ألعاباً. ثم يهربون. عائدين إلى مكان ما. في الهند أو روما. لم أعرف أين أبداً. "حتى في السجن" كما سمعت.
ومع مرور الصيف، تثارُ أسئلة عن هيكوران (يرنّ اسمه في سمعي كما لو أنه "رجل حديدي"). ماذا حدث لذلك الغجري آفجيت، ذاك المصري الخاص بنا، الذي اعتاد سنّ سكاكين مطبخنا، وسكاكين أضاحي كوربان بيرام، وإصلاح أدواتنا القليلة، ومظلاتنا وأباريقنا وأحواضنا؟ ومع ذلك كان هيكوران يجلب لنا مسامير أيضاً.
اعتقد بعض الناس أن مسامير هيكوران ملعونة لكونه أحد المتحدرين، أحد ورثة المسامير التي صلبت المسيح. لهذا خشيتُ لمس مسامير الروما، مثلما كنتُ أخشى لمس مسامير هيكوران. كيف يمكنني تمييز الملعونين من المباركين؟ كيف يمكنني معرفة أي مسامير صُلب بها المسيح وأي مسامير اعتاد استخدامها حين كان نجاراً؟ كان روما يضحك، وهيكوران يغني، ولم يعطني أحد جواباً.
ما زلتُ أتذكرُ الأغاني التي اعتاد أن يغنيها هيكوران خلال عمله في أحواش حيّنا. حسناً، لهيكوران شغلٌ آخر لا يشيدُ به إلا عجائز العائلات؛ فإذا خططتَ لإقامة عرس واحتجت إلى فرقة غنائية بالمناسبة، فسيكون هو الرجل المناسب للقيام بهذه المهمة.
لا.. لن أنسى أبداً تلك الظهيرات القائظة، وأنا أحاول أخذ غفوة من المؤكد أن يقلقها إزعاج "رجل الشمال"، جيجا، بصوته الجبلي العالي المجلجل. أظن أنه كان أكثر كسلاً من أن يمرّ بكل واد من الوديان، لهذا كان يصيح من كل زاوية بأسماء مشروباته المخمرة ومثلجاته: عندنا بوظة.. بوزة.. حلويات.. بسكويت، ويكرر "بوووووووووووظة".
كان صوته أعلى من صوت المؤذن الذي يدعو إلى الصلاة من منارة المسجد. وفي نظر الأطفال بخاصة، هزم صوتُ جيكا صوت المؤذن الداعي إلى الصلاة، في وقت يكون فيه صوت السوق عادة أعلى من صوت الإيمان.
بوسنيننا..! آرامينننا.. رومننا .. يوناننا.. مصريننا، جيكاننا. بوسناي..! أرومناي.. روماي، يونانياي.. مصرياي!
شعرتُ بنفسي نوعاً من باشا، باشا حقيقي في إمبراطوريتي، واحدة صغيرة، تماماً مثل حديقة جدّي. وكل من هم "لنا" كانوا خدماً سحريين، عبيداً ذوي معرفة وحكماء، يأتون من أمكنة بعيدة، يعلمونني أن الكلمة أوسع وأكبر من حديقتي، من إمبراطوريتي حيث نشأت.
خلال ذلك واصل "أناسنا" القيام بالعمل نفسه الذي يقوم به الناسُ الآخرون في العالم: البستنة والزراعة، والعمل في المصانع حيث تنتج الأدوات والأشياء المعدنية المصنعة أثاثاً وزجاجاً وأوعية بلاستيكية وورقاً، ومسامير أيضاً، مختلفة حقاً، لأن مساميرنا كانت مختلفة عن مسامير الروما وهيكوران.
ومع ذلك، سيصبح حيّنا في مخيلتي؛ كل بيت، كل طريق صغير، كل زاوية وزقاق، شركة أمم متعددة يديرها تجارٌ وأساتذة من جميع أرجاء الأرض، يظهرون ويمدون لنا يداً مع واجبات، ومجلس حكم في نهاية المطاف.
ذلك العالم الخيالي بأكمله، تلك الصدامات الثقافية، الناس الذين وجدوا هناك بالمصادفة ومن دونها، منحوا حياتنا نكهة، أعادوا رسم أبعادٍ كونية للحيّ الذي نشأتُ فيه. ما زلتُ أجد هذه الشخصيات المبهجة تتجول في أكثر ذكرياتي حيوية. لستُ واثقاً من أن أي أحد منهم ما زال بيننا، ولكن.. نعم، إنهم يقفون هنا، حاملين لعنة دائمة تنطق بها أشغالهم: الجولابورديون يصلحون الجدران الرطبة والسقوف الراشحة، البوسنيننا، أحدهم اللطيف، المهاجر مع ساعة الجيب ذات السلسلة سيظل يبيع فواكه طبيعته السماوية، الأرومنيننا سيظلّ إلى الأبد ينظف الخنادق، وينطق بكلمته الحكيمة عن الطين الشافي أو العلق، والزائر من النيل، المصري، لا يزال يسنّ مناجل، يصلح أدواتٍ ومظلات، ورومننا يعمل بأفضل ما لديه من معرفة، يقرأ الطالع أو يبيع الكستناء المشوي، وأخيراً وليس آخراً، جيكا الألباني من الشمال، الذي أكسبت حلوياته جزءاً من حياتي حلاوة.
كل هذا يشعرني بالأسى، أشعر بالأسى أن هؤلاء الناس وصلوا إلى نقطة وقوف. توقفت مسيرتهم الصاعدة، تجمدوا في ذاكرتي، تماماً كأنهم في مختبر يحتشد بآنية زجاجية ممتلئة بالفورمالين.
هل كان هذا شكلاً طفولياً لنزعة قومية مهنية، أو شكل ملحمة لفردوس مفقود منذ زمن طويل؟ ربما كان ميلاً متعدد الثقافات ساذجاً حيث "نحن" و"هم"، حيث "ما لنا" و"ما هو لهم"، وصفة لطبق بلقاني تقليدي ذي طعم لذيذ أيّاً ما كان. ولكننا أصبحنا ندرك اليوم أن هذا النوع من العوالم انقرض. أولئك الناس وأشغالهم امّحوا. يظل التحامل موقفاً مسبقاً. ما زال المربع المحدّد على رقعة الشطرنج ماثلاً. إنه موجود، موجودٌ ولكن في مكان لا زلنا فيه وحيدين: نحن وأناسنا. أناسنا. وأنا أيضاً.
* Arian Leka شاعر وروائي ألباني من مواليد 1966. ينتمي إلى جماعة من الكتّاب والشعراء الذين ظهروا في المشهد الأدبي بعد فتح الحدود الألبانية عام 1990، حيث شهدت الثقافة تغيّراً دراميتيكاً حينها، ويمكن اعتباره من "الطلائعيين" في الأدب الألباني.
يكثر ليكا (الصورة) من استخدام الرموز البحرية التي تبدو كما لو كانت بصمة في كتاباته، وكثيراً ما يميل إلى نسج كينونة أسطورية حول بلاده، لكن بلغة جديدة تبدو كما لو أنها واقع يعاش يومياً.
** ترجمة: محمد الأسعد