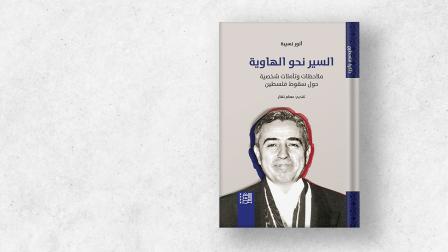أكاد أجزم أن كورونا هي الانطلاقة المُثلى والحقيقية، انطلاقة الإنسان وتدحرجه نحو بداياته الأولى، حيث الخوف والهلع واللاأمن والجوع واللهاث وراء سدّ رمق العيش والبحث عن حياة واصطياد الفرائس والتجمّع حول النار والعيش مع الغير أو التزلّف للذات والتعصّب للمكان والقبيلة في أنانية متناهية والاختباء في الكهوف والاختفاء عن الأنظار والاعتراف بالضعف والهوان والانكسار. كرٌّ وفرٌّ في كل الاتجاهات وهروب من وإلى الشر والخير معاً.
كورونا اليوم جعلني أستشعر بداية النهاية التي لطالما نسيتها أو تناسيتُ وجودها الدامغ. الشعور ببداية النهاية هو أن تتوسّط كتلاً بشرية محنّطة تُعدّ بمثابة مشاريع لضحايا عدوّ لعين ومقيت يختفي في اللامكان واللاوجود وبين ذرّات الهواء الحقيرة. بأي سلاح ستحاربه؟ لا حربة الرجل البدائي تنفع ولا تكنولوجيا الإنسان المتحضر تفيد. يا إلهي، كم نحن جبناء وقد مسّنا الوهن وخذلتنا عقولنا بعدما اجتثتنا القلوب وأغفلنا المشاعر وأشهرنا الحقد والغلّ والتشفّي والرياء وكل معاول الدمار الشامل.
عندما تسلّلت أخبار الوباء رويداً رويداً بين جنبات العالم، كرّر بعضنا على مسمعهم جملة وردت في قصة جحا مع النار يوم أتت على قريته: "تخطي داري" ثم "تخطي رأسي". لكن النار بلغت داره ورأسه معاً فحطمتهما ولم تُبق ولم تذر.
اليوم، وقد سكنت الجائحة ديارنا فإننا تحوّلنا إلى وحوش فتاكة، لا تخرج من جحورها سوى لتشبع نزوات البطن وما تحته وتكدسها في غباء، وكذلك حال أغلبها. لا شيء يبعث على الارتياح مع تدفق الأخبار غير السارة عبر نشرات القنوات التلفزية المتفننة في نقل الحصائل والمتنافسة في تصوير الضحايا وهم يصارعون في وجل ذاك الوباء المستشري. باتت القنوات في حكم الناعي الذي ينبئ بأسماء الهالكين ومصير الناجين، مؤقتاً.
فماذا يفعل المرء قبالة هكذا وضع سوى الاستسلام لضيق في التنفس والاسترسال في الإصغاء لخفقات قلب منكسر يسكنه الضعف والقلق والرعب مما هو آت. كم هو جميل وأنا أفتح كتاباً لأقرأه وأضع فيلماً أمتّع به ناظري وأستخرج لعبة أتقاسمها مع ما تبقى من أفراد عائلتي لأفرح وأنسى وأسرّع عقارب الزمن... لا، مستحيل، فلا الكتاب قرأت ولا بالفيلم استمتعت ولا اللعبة تقاسمت.. لم تكن سوى أضغاث أحلام ليس إلا. ما أنا إلا مجرّد هيكل أنهكته منغصات قديمة فرّت من كراس الذكريات وطفت على سطح الأحداث بمناسبة الحجر المنزلي لتفسد ما نجا من الوباء.
ما أتعس الإنسان وهو يملك السيارة والكمبيوتر والويفي والكتب والأصدقاء والأقلام والمناصب والشهادات وكل المعدات والمنافع، لكنه لا يستفيد منها البتة ساعة حاجته إليها. الموت في كل مكان من قسنطينة إلى وهران، وصابرٌ أنا ومصطبر لعل الله يُحدِث بعد ذلك أمراً.
وكيف لا أجنّ وأنا أسمع بعض مدّعي الإسلام اليوم وهم يتشفون في إخوانهم في الإنسانية بسبب الوباء؟ بل ولا يدعون بالشفاء سوى لمن هو شريكهم في الدين واللسان والتخلف والتفاهة. وما أزال متأكداً من أن أبناء جيلي في الجزائر قد خبروا كل ما هو فظيع وسيّئ، حتى ليخيّل إليك أنهم لم يخلقوا لغير ذلك. فقرٌ، فإرهاب، فمشلول محنّط، فعصابة، فكورونا، والبقية تأتي.
* كاتب وباحث في التاريخ من الجزائر