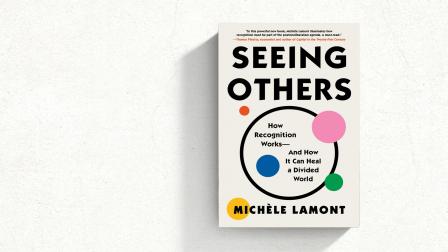صدرت مؤخّراً نسخةٌ مُحيَّنة من معجم "مَلاحِن الفرنسية" (Dictionnaire de l’argot français)، بعد قرابة قرنَيْن من ظهوره. وكان قد جمعه، سنة 1829، أوجين فرانسوا فيدوك، ووقّعه برتبته كضابط في الأمن الفرنسي. ومنذ ذلك التاريخ، لا تزال جهود تطوير هذا المعجم مستمرة بشكل مطرد في الفضاء الفرنسي، بما يظهر ذلك من تجدّد لا يهدأ للكلمات ذات الاستخدامات غير الرسمية، والتي يُطلَق عليها مصطلح "Argot".
يحيل هذا المفهوم، الذي تَصعب ترجمته إلى العربية، على أجناس كلام فرعية؛ مثل: كلام المراهقين، ومشجّعي كرة القدم، وسكّان الضواحي، وطبقة المزارعين وغيرهم من الفئات.
وكانت هذه التسمية، في أصل نشأتها، تُطلَق على الرموز والإشارات الخاصّة التي تُبتَكر في قاع المجتمع، بين اللصوص والعيّارين والسجناء، للتعبير عن أشيائهم الحميمة ومحيطهم الإجرامي بشكل مُشَفَّر، لا تفهمه علية المجتمع. ثم صار المصطلح يُطلق على ما يميز فئةً من الناس ويعطيها فرادتها الاجتماعية والمهنية، دون أن يعني حقلَ المصطلحات - المفاتيح الخاصة بطبقة ما أو مهنة، وهو ما يُسمّى "Jargon"، أو الاصطلاح.
وتُعتَبر جهود توثيق هذا النوع من سجلات الكلام إسهاماً علمياً أساسياً، وهو يتجاوز نطاق المعجمية كحقل معرفي إلى فهم "الثقافات التحتية" (sous-cultures) في مجتمع ما وطُرق توليدها، أكانت شكلية أو استعارية، للكلام. فهل تُبذل جهودٌ مماثلة في حقل المعجميات العربية؟
ثمّة مجموعة من العراقيل اللغوية والثقافية وحتى السياسية التي تتداخل، فتشكّل ما يشبه "العائق المعرفي" الذي يحول دون القيام بهذه المهمّة. وتكمن أولى الصعوبات في الترجمة العربية لمصطلح "Argot"، في حد ذاته.
فحين يُترجم بـ "العامية" أو "السوقية"، سرعان ما يحيل في الأذهان إلى صفات "الابتذال" و"السقوط"، وكأنَّ الأمر يتعلّق ضرورةً بحقل الكلام البذيء الذي يمجّه الذوق العام، في حين أن هذا الكلام يحمل من اللطائف والقدرات البلاغية ما لا يقل عن اللغة الرسمية.
وإن أردنا تحديداً أولياً لهذا المجال، يُمكن القول إنه مجموعة الكلمات والعبارات التي تعتمدها جماعة تعوِّض بها المصطلحات الرسمية، التي تنحدر من السجل العالي (Le haut langage)، وتقوم خصوصاً على كنايات وتوريات يَبتكرها الاستعمال اليومي للدلالة على معنىً ما ولكن بشكل أقل سلامةً، فتكون درجة الجدية فيه دون مستواها في السجل الفصيح. ومن أمثلته الشائعة التعبير عن عقوبة "السجن المُؤبَّد" بنظيره: "تأبيدة"، وعن "العطلة" أو "الإجازة" بمقابلهما "فُرْصة".
ومن جهة ثانية، ثمة صعوبة ثانية تقف أمام دراسة هذا النوع من الكلام، وتكمن في تحديد الفضاء اللغوي الذي ستُنتَقى منه الألفاظ، بما أن هذه الظاهرة عامّة في كل اللهجات المحكية، فلا يمكن تجميعها في معجم واحدٍ وذكر مقابلها الفصيح. فلكل لهجة طريقتها في نقل المعاني من المستوى الرسمي إلى ما دونه.
فمفردة "مال" مثلاً لها من المقابلات بقدر الدوارج العربية، فهي عند أهل اليمن "زَلَط"، و"حَنَيْنات" في التونسية، و"دراهم" في المغربية و"مَصاري" عند أهل الشام و"فْلوس" في المصرية.. هذا فضلاً عمّا يُلصَق بها من كنايات كـ "الدرهم" و"الدينار"، و"محيي النفوس" و"وَسخ الدنيا"... فلا يمكن للألسنيّين العرب جمع كل المفردات لأنها، بحكم طبيعتها، جِهَوية، تخص منطقةً اجتماعية محدّدة، وهو ما يُسمّى في اللسانيات "sociolecte" أو الاستعمال الاجتماعي الخاص بطبقة معيّنة.
ويَصعب أخيراً التمييز في سجلّات القول، من جهة بين حدود الدروج والابتذال والسوقية والتمييز الاجتماعي، وهي حدود دقيقة للغاية. ومن جهة ثانية بين المسار الدلالي في نقل كلمةٍ ما، من سجلّها الأعلى إلى الأدنى. ولذلك، يبدو بديهياً أنَّ المرحلة المنهجية الأولى تكمن في التحديد الدقيق لهذا المجال ورَسم قائمة واضحة بمكوّناته ومفرداته، حتى تتّضح الحدود الغامضة بين هذه القطاعات المتداخلة.
وممّا يزيد في تعقيد مسألة رسم حدود هذا السجل، أن الخطاب الرسمي قد يستعير منه بعضَ عباراته، ومن ذلك مثلاً استخدام الرئيس التونسي بورقيبة (1903 - 2004) عبارة "المادة الشخمة" من المعجم الشعبي للدلالة على العَقل أو التفكير. وهنا تكون هذه الكلمات بديلاً مخفَّفاً عن السجل الشكلي، من أجل تحميل شحنة تواصلية جديدة، يحدّدها السياق التفاعلي بين المخاطبين.
ولا تخلو من هذه الظاهرة أية لهجة عربية، وفيها تؤدّي وظائفَ تداولية ثابتة، منها السخرية والتخفيف من الأعباء الرسمية التي تحيط بسياق ما، فضلاً عن الالتفاف حول القيود الاجتماعية والسياسية وما تمارسه من رقابة على الإنتاج اللغوي، ولذلك غالباً ما تتّسم بقدر عالٍ من الانزياح الاستعاري؛ فالمبدأ الذي يحكمها جميعاً هو التورية بما هي عدولٌ عن اللفظ الموضوع في اللغة الرسمية إلى رديفٍ له، يقاربه في المعنى ويؤشّر إليه.
ففي كل مُلاحَنة، وهذا من خيارات ترجمة مصطلح "Argot"، توسيعٌ للمعنى لوجود علاقة تماثلية يفطن إليها المخيال الشعبي بما فيه من رمزية وعلاقات خفية، يدركها بحسه العملي. فلو عدنا إلى تحليل مفردة "حَنَيْنات" التونسية لرأينا كيف وُرِّيَ بها عن القِطع النقدية، لأنها "تَحنُّ" على الإنسان وتعطف عليه حين ترفعه من حضيض الفقر.
ولا يخفى أن لهذه المعاجم أهمية كبيرة في إثراء اللغة وتتبُّع تطورها وتحولاتها. وليس من العسير الاستفادة من المفردات الواردة فيها إن جُمعت ونُقّيت من الشوائب، أن تُدمَج في لغة الأدب والإعلام أو الخطاب السياسي.
وتتمثل فائدتها الثانية في قدرتها على الرصد السريع لتطوُّر كتلة الكلمات التي تتشعب دلالاتها في الثقافات الفرعية، وذلك مقارنةً بمادة القاموس الرسمي، وفيه تظل المعاني ثابتة إلى حد كبير. وآية ذلك إمكان استشارة قاموس مدرسي، صادر في أربعينات القرن الماضي، في أيامنا هذه دون مشقّة، مع أنَّ عربية الحياة اليومية تغيّرت بشكل كبير دون أن يتمَّ تسجيل ما طرأ عليها من تطور في معاني كلماتها.
ويبقى احتمالُ الاستفادة من مثل هذه المعاجم مرهوناً بتجاوز النظرة المعيارية التي تقلّل من شأن كلام فئة دون أخرى، وهذا من آفات الأكاديميا العربية، وهو دليلٌ على انغلاقها وتغافلها عن أمر بديهي مفاده أنَّ أيَّ استخدام في اللغة، جلَّ أو انحطّ، يؤدّي وظيفة تداولية، لا ينفع غيره في النهوض بها. وهو ما يؤكّد أنَّ الملاحِن يمكن أن تغذّي الضاد، بل قد تكون محطّة انتقال بين الفصيح، المنحدر من بادية العرب، وبين ما تُنشئه الناس في المدن الصاخبة من معانٍ حافة، بفضل عبقرية التورية.