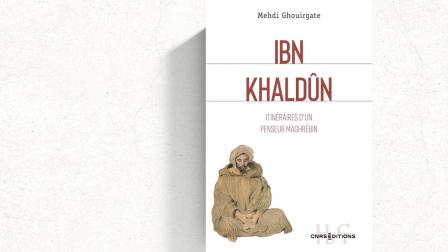كتب الأديبُ والتربوي الفلسطيني خليل السكاكيني (1878-1953) لابنه سريّ المغترب للدراسة في أميركا في 3 أيار/ مايو 1934 يُبشّره: "اعتمدنا بعد الاتكال عليه تعالى أن نشتري قطعة أرض نبني فيها بيتاً متواضعاً نأوي إليه بعد أن أُحال إلى التقاعد". خرج السكاكيني بعد هذا الاتكال مع زوجته وابنتيه وبعض الأصدقاء في موكب إلى القطمون، غرب القدس المسوّرة، حاملين خرائط أراضيها إلى أن وقع اختيارهم على واحدة "إلى الشمال من القطمون هي ملك أحد الرهبان".
لا يفوت السكاكيني أن يصف لابنه حماسة أمّه سلطانة بقرب انتهاء معاناة الانتقال من بيت مستأجر إلى آخر، والاستقرار أخيراً في بيت مملوك، فيقول: "لقد كادت أمك تنقل الأثاث إلى قطعة الأرض التي أمامنا فتُعلق حبلاً على شجرة الصنوبر الكبيرة وتترجح وتزغرد". تأخر بعد ذلك بناء البيت في ظلّ الإضراب الكبير الذي ساد فلسطين الانتدابية وأحداث ثورة 1936، إلا أن الموت حرم سلطانة من التنعم طويلاً بهذا البيت بعد انتهاء بنائه، إذ توفت عام 1939، ولحق هذا الحرمان بزوجها وأولادها بعد أن سقط البيت "الجزيرة" بيد العصابات الصهيونية.
نشعر ونحن نقرأ تلك الرسائل في يومياته المنشورة "كذا أنا يا دنيا"، بالرمزية الدافئة والعميقة التي يُمثِّلُها بناء البيت في وجدان السكاكيني، باعتباره حيزاً عائلياً حيّاً نابضاً تتجسد فيه بعض أحلام الطبقة المتوسطة المثقفة المتشكلة في القدس آنذاك. فهو يريده على "أحسن حال" وهيأ له "أعظم الحدادين والنجارين". يشاركنا هذا العمق قائلاً: "لم أكن أفكر قبل اليوم أن تكون لي دار، وأما في هذه الأيام فإني أحسب أن بناء دار متواضعة هو السعادة كلّها. إذا كانت لنا دار فمهما كان دخلنا قليلاً استطعنا أن نعيش راضين مطمئنين، وإذا رحلتُ عن هذا العالم بعد أو أوفيكم حقّكم من العلم والثقافة وأهيئكم للحياة، وكانت لكم فوق هذا دار تسكنونها، ذهبت راضياً مطمئناً مجبور الخاطر بعد عمر طويل إن شاء الله".
هذه الدار التي سمّاها السكاكيني "الجزيرة"، لأن الطرق كانت تحيط بها من كل الجهات إلا جهة واحدة، وسمّى غرفها: صنعاء، ودمشق، وقرطبة، وبغداد، والقاهرة، أراد لها ـ كما يظهر في يومياته ـ أن تكون ذات بناء منيع مقاومٍ للزلازل والحرائق. هذه الدار التي رآها جامعة للعائلة وللأدباء والمهتمين بالثقافة، سقطت أمام حرائق وزلازل الحرب. فما حالها اليوم، ومن "تجمع" بين جدرانها المنيعة؟
في حيّ القطمون الذي تطور في نهاية القرن التاسع عشر ونشأت فيه برجوازية فلسطينية، لا تجد تلك الجبال والسهول التي قطعها "موكب" السكاكيني للبحث عن قطعة أرض، فكل الأراضي اليوم "محتلة": هنا مستشفى، وهناك مدرسة، وهنا كنيس، وهنا بيت حديث البناء يأوي مستوطنين جدد من استراليا، وغيرهم. وبينما كان المارّة في الشوارع يدققون النظر ويتفحصون الوجه العربي "الغريب" المقتحم لـحارتهم، كنت منشغلة في "العثور على البيوت العربية المنهوبة".
الدخول إلى حي القطمون كان ـ وبتعابير التكنولوجيا الحديثة ـ أشبه بلعبة "game" على الحاسوب، على اللاعب فيها أن يلتقط الكنوز والنقود الظاهرة فجأة في طريقه قبل أن تسبقه خطوته وتفوته. الكنوز هنا هي التحف المعمارية التي خلفتها وراءها الطبقة الوسطى المقدسية بعد تهجيرها عام 1948. تصادفك بنايات حديثة النشأة لا ذوق فيها ولا معنى، مبانٍ سكنية مصفوفة برتابة أقصى آمالها أن تؤدي مهمة الإيواء بعملية شديدة. هل لسكان هذه العمارات أبناء في الغربة يوصيهم آباؤهم بالجدّ في طلب العلم؟ فجأة وسط هذه تلك العلب العمرانية تلوح لك الكنوز، بيوت عربية بنيت بعناية فائقة وبجمالية عمرانية مبهرة: هذا واسع وذو طوابق، وهذا مع حديقة واسعة، هذا من طابق واحد أضيف فوقه بناء حديث لا يشبهه. تسمح لنفسك باغفال معايير الأمان على الطريق وأنت تخفض رأسك لتجمع ما استطعت من نظرات إليها من واجهة السيارة الزجاجية.

في بيت السكاكيني
ملابس قديمة منثورة في كلّ مكان، على الطاولة، على الأريكات، عند الباب. صور لرجال دين يهود على الحائط عرفت منهم ذلك الذي وصف العرب بالفئران والأفاعي "الحاخام عوفاديا يوسف". قال لي بالعربية رجل سبعيني ذو لحية بيضاء مبعثرة ومتسخة: "أهلاً وسهلاً". إنه رافئيل، يهودي كردي من العراق، "يسكن" في الطابق الأول من بيت السكاكيني منذ أكثر من أربعين عاماً. يقول رافئيل إنه وجد في البيت أكياساً من الرمل، ربما هي تلك التي ذكرها السكاكيني في يومياته، أثناء وصفه يوميات عائلته في نيسان/ أبريل 1948: "القتال مستمر، تمر الليلة تلو الليلة ونحن ايقاظ لا تأخذنا سنة، ونحن وقوف في الطبقة السفلى من الدار وراء أكياس الرمل".
كان يبدو عليه من تأثير الكبر وطول العمر ما يكفي ليجعله يغض الطرف عن الدخول المفاجىء لفتاة عربية إلى "بيته". عرض علي الجلوس، هممت أن أجلس بعد يوم عمل متعب وطويل، لكن ارتسمت أمامي في ذات اللحظة ملامح خليل السكاكيني في صورته المشهورة و"شنبه" المهيب، كأنه ينهاني عن الجلوس في بيت محتل، فامتنعت. تكلم رافئيل عن ذكريات هجرته إلى "أرض الميعاد" مطلع الخمسينيات. قال: "لو لم نأت إلى هنا لقتلنا صدام في العراق". "كانت القدس فقيرة، وكنت أعمل في المستوطنات، نزرع ونأكل. لكني قررت الهجرة الى القدس لأكون قرب أمي، وكانت القدس فقيرة.. ليرة فوق ليرة حتى استطعت شراء هذا البيت". لا يمكنك هنا إلا تذكر السكاكيني وهو يصف تعبه وتجميع ما لديه من أموال لبناء هذا البيت وتحويله محجاً للأدباء والمثقفين.
وبينما كان السكاكيني يجمع الكتب النفيسة، حتى أن الأطباء كانوا يقصدونه ليجدوا إجابات عن أسئلتهم الطبية في مكتبته، يجمع "رافئيل" في هذا البيت الملابس الملقاة في حاويات القمامة ليبيعها ويعتاش من ثمنها. قالت لي ذلك بهمس جارته الأميركية اليهودية التي تسكن هي الأخرى في بيت عربيّ مجاور، وأضافت "إنهم "بدائيون".. .يصرخون على أبنائهم.. هم أكراد من العراق". تلك الأميركية حدثتني لاحقاً عن رغبتها في التعايش مع العرب، وعددت أسماء فلسطينيين معروفين التقتهم في لقاءات تطبيعية، ومع ذلك فهي لا ترى تناقضاً بين هذا "الميل إلى السلام"، وبين وصف اليهود الشرقيين بأنهم "بدائيون".
أما الطابق الثاني، فتحتله اليوم جمعية إسرائيلية باسم "فيتسو"، وهي جمعية أسستها نساء كنديات يهوديات عام 1917، وتدير مشاريع تتعلق بالأطفال والصحة العامّة والنساء في "إسرائيل" وكندا. وتُشغل هذه الجمعية في الطابق الثاني من بيت السكاكيني روضةً للأطفال من أبناء الطبقة الوسطى العاملة في المجتمع الإسرائيلي. تخوّفت مديرة الروضة من الكاميرا فرفضت بشدة دخولنا البيت، فاكتفينا بمراقبة الأطفال فرحين بمغادرة الروضة ولقاء أهاليهم.
أما السكاكيني الذي غادر بيته مضطراً حزيناً قبل 66 عاماً ولم يعد، فقد رثى ما ترك وراءه من أثاث ومكتبة وبيانو وذكريات، ورثى ما هو أثمن، قائلاً: "الوداع يا دارنا! يا دار الأمّة! يا ملتقى أقطاب السياسة ورجال الصحافة، وكبار الخطباء والفنانين من مصر ولبنان وسوريا والعراق". "الوداع يا مكتبتي! يا دار الحكمة يا رواق الفلسفة يا معهد العلم يا ندوة الأدب.. الوداع يا كتبي النفيسة القيمة المختارة".