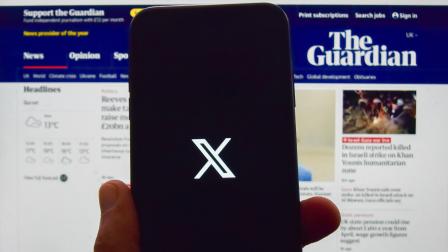استمع إلى الملخص
- المتحف الفلسطيني ومبادرة سنابل نظما فعالية "كف قمح" لتسليط الضوء على دور القمح في التاريخ والثقافة الفلسطينية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث والهوية الثقافية الفلسطينية.
- "كف القمح" يحمل دلالات ثقافية واجتماعية، يرمز إلى الخصوبة والنماء ويعتبر تميمة حظ، مشدداً على الأبعاد الثقافية والروحية لهذا التقليد في الحياة الفلسطينية وأهميته كجزء من التراث الغني.
صنع الفلّاح الفلسطيني "كفّ القمح"، وعلّقه على باب بيته، هدية شكرٍ على غلّة وفيرة أنعم الخالق عليه بها، في تقليد شعبي استمر آلاف السنين في فلسطين. ووسط حرب الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين في غزة، "حيث لا بيادر قمح، ولا حصاد، ولا خبز، وحيث الجوع هو عنوان الأيّام واللّيالي"، دعا المتحف الفلسطيني إلى "التأمّل في هذا الطقس التقليدي، وحصد سنابل القمح في حديقة المتحف، وصنع أكُفًّ منها، لتعلق على الأبواب، كصلاةٍ ودعاءٍ ليرفع اللّه الغمّة عن غزّة، وتكتنز سنابل قمحها من جديد، ويغمرها بخير كثير لآلاف السنين القادمة"، وفق بيان المتحف.
وانطلاقاً من ذلك، نظم المتحف الفلسطيني، بالشراكة مع مبادرة سنابل، فعالية "كف قمح"، في مقره في بلدة بيرزيت، قرب رام الله، مساء أمس الثلاثاء. وشددت مساعدة البرامج التعليمية في المتحف الفلسطيني، لانا عبيدة، على أن غزة كانت المصدر الرئيسي لزراعة القمح في فلسطين عبر العصور، فقبل قرن كان القمح هو المنتج الغذائي والرافد الاقتصادي للفلسطينيين في غزة، وكان يصدّر في العهدين العثماني والبريطاني، وحتى حين كان القطاع يتبع الحكم المصري بعد النكبة وحتى احتلال 1967، وكان يخزن هناك، كما الشعير، في أماكن مخصصة تحت التراب، قبل نقله عبر تجّار يافا، ومن خلال مينائها، إلى أوروبا. وبقيت تجليّات موسم الحصاد في غزة تحديداً حتى حرب الإبادة المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، بما فيها "كف القمح" الذي هو طقس تاريخي فلسطيني موغل في القدم.
وأكدت عبيدة أن شكل "كف القمح" لم يتغيّر منذ آلاف السنين، ولفتت في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أن الكثير من القطب المستخدمة في تطريز الأثواب الفلسطينية، وخاصة في المناطق الريفية، تتقاطع وشكل الكف، وتكوين سنابل القمح فيه.
وأشارت المشرفة على ورشة تدريب صناعة "كف القمح"، ذكريات عديلة، إلى أن شغفها بسنابل القمح، لما تحمله من دلالات عدّة مرتبطة بالأرض والإنسان والثقافة والتراث والحالة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، دفعها للعمل على إعادة إحياء "كف القمح" كحالة تراثية أسطورية كنعانية مُتوارثة ومُستمرة في فلسطين، خاصة بعد أن لاحظت محاولات من جهات إسرائيلية عدّة للسطو على هذا المنتج وترويجه عبر منصات عالمية باعتبارها جزءاً من تراثهم.
وعديلة التي تقطن مدينة رام الله أكدت لـ"العربي الجديد" ضرورة الحفاظ على هذا المنتج التراثي المرتبط بالأرض الفلسطينية وأصحابها، خاصة في ظل حرب الإبادة المُتواصلة على قطاع غزة، وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات ومشاريع استيطانية إسرائيلية، أو قيام المستوطنين بحرق مساحات كبيرة مزروعة بالقمح في موسم حصاده.
ولفتت عديلة لـ"العربي الجديد" إلى أن "كف القمح" كان يُعرف أيضاً باسم "مشط الحنطة"، لطبيعة تكوينه الشكلي، وإلى أنه مع الوقت بات يشكل تميمة أو تعويذة حظ، وبات يُوضع على مداخل المنازل أو داخلها.
وحضور القمح في التاريخ الفلسطيني ليس عابراً، بل برز في طليعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. في كتابه "فجر الحضارات في الشرق الأدنى"، يشير عالم الآثار الهولندي هنري فرانكفورت إلى أن "الأصول البرية الأولى للقمح والشعير لا تزال في سورية وفلسطين، إذ تطور فنّ حصاد القمح في تلك المنطقة". وهنالك أصناف متعددة عكف المزارعون الفلسطينيون على زراعتها وتصديرها عبر العصور، منها ما ذكرها وصفي زكريا في كتابه "المحاصيل الحقلية" الصادر مطلع خمسينيات القرن الماضي، وبينها القمح الحوراني والقمح النورسي في الجليل الأعلى المُحتل عام 1948، والأبوفاشي في طولكرم، وحرباوي في قرية بيت جرجا المُهجرة، شمال شرقي غزة، والجلجولي في السهول الفلسطينية الساحلية، واحتلت غالبيتها عام النكبة، علاوة على القصري والهيتي، وغيرها.
والحضور الثقافي للقمح له أشكال عدّة، من بينها الصناعات التقليدية، ولوحات الفنانين عبر العقود الماضية، وبعض الأعمال السينمائية والمسرحية، علاوة على الكثير من الأغنيات المرتبطة بموسم حصاده، وحتى في أشعار كبار الشعراء الفلسطينيين كمحمود درويش ومعين بسيسو وحسين البرغوثي، وغيرهم.