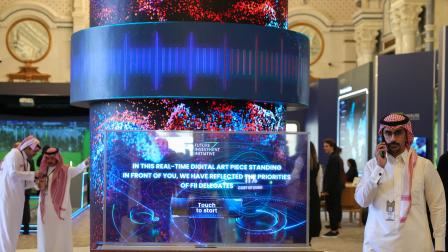جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لتؤكد إصرار الاحتلال على استكمال مخططاته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بمختلف الطرق إلى جانب تدمير الاقتصاد الفلسطيني.
وفي أحد المؤتمرات، تحدّث المؤرخ الإسرائيلي المعارض للصهيونية وللاحتلال إيلان بابيه، الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكستر في المملكة المتحدة، عن مفهوم النكبة الفلسطينية.
كما أكد أنها لم تتوقّف مع تهجير الفلسطينيين عام 1948، بل لا تزال مستمرة كعملية تطهير عِرقي تقوم على الطرد المُمنهج للفلسطينيين من أراضيهم لاجتثاث عروبة فلسطين وبناء دولة يهودية على أنقاضها، وهي مستمرة لأنها لم تكتمل بعد، قاصدًا استمرارها بالأشكال السلمية كما العسكرية.
وترتبط النكبة المستمرة بسياسة ديمغرافية مستمرة لإسرائيل للحفاظ على يهودية الدولة (كهدف أساسي) مع التوسّع الجغرافي (كإمكانية مُحتملة)، تستلزم في نظر خبرائها الحفاظ على أغلبية يهودية لا تقل عن 75% إلى 80% من السكان داخل ما تعتبره إسرائيل أراضيها.
ولا شك أن استمرار التوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المُعترف بها دولياً يستتبع ليس فقط مدّ نطاق هذه السياسة إلى ما تضمّه وضمّته فعلاً من أراضٍ جديدة، بل يتضمّن أيضاً التمهيد لها بتقويض شروط حياة الفلسطينيين بما تستهدفه من مساحات جديدة من أراضيهم، فهذا أبسط المنطق مع وضع إسرائيل عام 2019 خطط ببناء 13700 وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة الغربية، حسب مذكرة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربيّ آسيا (إسكوا).
وهكذا، فخلافاً للتهجير الدموي الصاخب تحت وقع الصواريخ والقنابل، تمارس إسرائيل تهجيراً آخر أبطأ وأقل ضجيجاً، لكنه لا يقل قسوةّ وخطورة، هو التهجير بالخنق المتزايد للاقتصاد الفلسطيني لجعل شروط الحياة المُستدامة شبه مستحيلة.
ومن ثم دفع الأقلية التي تمتلك فرصاً في الخارج من الفلسطينيين للخروج طوعاً تحت ضغط انعدام آفاق الحياة الكريمة في أراضيهم الوطنية، مع انشغال الأغلبية الأقل حظاً بتأمين الفتات لمجرد البقاء على قيد الحياة، بل وارتباط قطاع منها اضطرارًا بالاقتصاد الإسرائيلي نفسه؛ ومن ثم تقليل الاحتقان والاضطراب الأمني في المناطق الفلسطينية، فضلاً عن إخضاعهم عملياً وتطبيعهم نفسيًا بالتدريج مع حالة الاحتلال؛ وتحوّلهم لاحتياطي استسلامي، ربما حتى مُعاد للمقاومة، داخل الجسد الفلسطيني نفسه.
في هذا السياق، تتكامل سياسة الخنق الكلي مع سياسة الجسور المفتوحة التي أعلنها موشيه ديان يومًا لربط واستتباع الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي؛ فبسبب سياسة الخنق الكلي، بما تؤدي إليه من ضعف في فرص العمل ومستويات الدخول وتوفّر السلع والخدمات، يصبح ربط واستتباع الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي ممكناً، بل ومفيداً للاقتصاد الإسرائيلي؛ بتوفيره يدا عاملة رخيصة لبعض أكثر القطاعات حيوية كالزراعة والتشييد والبناء؛ بما يرفع أرباح المستثمرين ويخفض تكاليف الحكومة، بل ويعزّز التنافسية الكلية للاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى هذا الأساس، تعيد إسرائيل إنتاج منطق المركز والهامش والتبادل اللامتكافئ الإمبريالي على نطاقها المحلي المباشر؛ بما يوفّر حافزاً إضافيًا، إلى جانب دوافعها العنصرية، لرفضها القاطع لحل الدولة الواحدة الذي يضعف إمكانية وفاعلية ومشروعية هذا الإطار الاقتصادوسياسي القائم على التمييز بين نوعين من العمالة متفاوتي الأجور بفوارق قسرية -تتراوح ما بين الضعف والضعفين- ما بين الإسرائيلي والفلسطيني العاملين بنفس المهنة.
ومن خلال هذا التكامل بين السياستين، تتراوح ممارسات إسرائيل وفقاً لتوازنات قواها السياسية والاجتماعية في إطار من تكامل تبادلي بين السيناريوهين، تكون ضمنه سياسة الجسور المفتوحة السيناريو قصير الأجل لتقليل سقف المقاومة الفلسطينية من خلال الهيمنة اللوجيستية والعلاقات الاقتصادية، فيما تكون سياسة الخنق الكامل السيناريو طويل الأجل الهادف في نهاية المطاف للتفريغ الديمغرافي -السِلمي ظاهرياً- لفلسطين من أهلها.
وعلى هذا يجتمع علمانيو إسرائيل الليبراليون وأصوليوها المتطرّفون، فخلافاً لحلم إسرائيل الكبرى أرض الميعاد لدى الأخيرين، يؤمن الأولون بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تأمن على بقائها في محيط عربي إسلامي مُعاد إلا بتصّفية كاملة للقضية الفلسطينية، يختفي ضمنها الوجود الفلسطيني باعتباره "جسم الجريمة" بالمصطلح الجنائي، وتُفرَّغ الحدود الفاصلة بين إسرائيل ودول "المُعاهدين العرب".
يؤكد هذا أن حتى إسحاق رابين، الذي يعتبره الكثيرون أيقونة السلام الإسرائيلية التي اغتالتها قوى التطرّف الإسرائيلي، صرّح يوماً بحلمه بأن يستيقظ ذات يوم ليجد غزّة وقد ابتلعها البحر، وذلك قبل أن يكون لحماس -التي تتخذها إسرائيل اليوم ذريعةً لتدمير غزّة- فيها صَول ولا طَول.
تصدّق على هذه النوايا ممارسات العزل والحصار المُفرطة على القطاع، والتي وصلت به حسب الإشارات العديدة بتقارير الأمم المتحدة منذ ما يقرب من عقد إلى حالة كارثية جعلته بحاجة لإجراءات استثنائية ليصبح فقط صالحاً للسكن، كذا إلى حدّ وصفت الاقتصادية اليهودية الأميركية سارة روي الموقف عام 2016، في الطبعة الثالثة من كتابها الشهير عن الاقتصاد السياسي لتصفية التنمية بقطاع غزّة The Gaza Strip: The Political Economy of De-development، بتحوّل غزّة من منطقة متكاملة اقتصادياً مع الضفة الغربية وإسرائيل إلى جيب معزول يمكن التخلّص منه ببساطة، والتي نقلت كذلك، على النطاق الفلسطيني الأوسع، ما وجدته من اتفاق بين تصريحات المسئولين الإسرائيليين منذ أواسط الثمانينيات على عدم السماح بتنمية اقتصادية في فلسطين؛ لإعاقة أي فرصة لقيام دولة فلسطينية.
أدوات إسرائيلية متعددة لخنق الاقتصاد الفلسطيني
لكن كيف تخنق إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني؟ لا تتطلب الهيمنة على أي اقتصاد سوى التحكّم في ثلاثة مكوّنات رئيسية، أولها رأس المال العام من سلع الأرض والمياه والطاقة (المُحددة لإمكانات البنية التحتية وقاعدة التجديد الاجتماعي ومتوسط الإنتاجية الكلية)، وثانيها منافذ التبادل الداخلية والخارجية (المُحددة لإمكانات حركة العمل والسلع والموارد)، فيما ثالثها مفاصل السياسة الاقتصادية من مالية عامة ونقد وطني (المُحددة للإنفاق العام وتخصيص الموارد وأسس القيم والمبادلات).
وعلى هذا الصعيد، لم تدخر إسرائيل وسعاً لتجاروز الهيمنة إلى الخنق، بما يعكس الأرجحية طويلة الأجل لهدف التفريغ الديمغرافي على حساب هدف الاستتباع الاستغلالي للفلسطينيين، والتي تزايدت منطقياً مع عدم نجاح الأخير في قتل روح المقاومة فيهم وصعود الأجنحة المتطرفة داخل إسرائيل، وكما تجلّت بشكل أكثر وضوحاً في الحصار الشديد على غزّة منذ صعود حماس إلى السلطة؛ لما أبدته من مقاومة أشد، كذا لكون غزّة القطاع الأصغر جغرافياً وسياسياً بما يسهّل منطقيا البدء به، للاستفراد لاحقاً بالضفة الغربية.
ويمثل العزل الداخلي بين القطاعات الفلسطينية نفسها، وأبرزها بين الضفة وغزة، كذا بينهما وبين عرب 48 داخل إسرائيل، أول وأوضح أشكال الخنق المادي للاقتصاد الفلسطيني؛ حيث تمنع حرية حركة السكان والسلع وسيولة المبادلات حتى في ما بين الفلسطينيين وبعضهم مع بعض، ويصل عدد الحواجز التي تفصل مناطق الضفة الغربية لكانتونات معزولة عاجزة عن الحركة والتوسّع إلى أكثر من 700 حاجز ثابت عام 2023، بخلاف الحواجز المتحرّكة المتغيّرة التي وصلت إلى ما يقرب من 500 حاجز عام 2011 مثلاً.
وتزاوج مع ذلك العزل الداخلى عزل كامل للفلسطينيين عن العالم الخارجي؛ بمنع وجود أي مطارات أو موانئ مستقلة للفلسطينيين، وبتوسّطها كافة تعاملات الفلسطيين مع الخارج استيراداً وتصديراً، بما يشمله ذلك من رقابة وتقييد لنوعيات وكميات السلع موضوع التبادل، ومن سيطرة على نظام الجمارك الفلسطيني، وإعطاء مزايا تفضيلية للشركات الإسرائيلية على حساب نظيرتها الفلسطينية، وعلى سبيل المثال، قدّر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2013 أن إعادة بناء ستة آلاف وحدة سكنية فقط كان سيتطلّب 80 سنة، لو اعتمدت فقط على ما تسمح به إسرائيل من مواد بناء.
انعكس هذا التحكّم الإسرائيلي -المُنحاز غير النزيه بالطبع- في العلاقات الفلسطينية الخارجية؛ فبلغت كُلفة الاستيراد على الشركات الفلسطينية ثلاثة أضعاف نظيرتها الإسرائيلية، وبالمثل بلغت كُلفة التصدير للأولى أربعة أضعاف الثانية؛ واستأثرت إسرائيل بنسبة 72% من الصادرات الفلسطينية، فيما حازت فلسطين 3% فقط من الصادرات الإسرائيلية؛ ما يعكس الفارق الهائل في حجمّي الاقتصادين، والموقع المهيمن لإسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية.
سياسة الأراضي التمييزية ضد الفلسطينيين
وتعزيزاً لأثر ذلك العزل المُزدوج داخلياً وخارجياً، ولإحكام السيطرة على شروط حياة الفلسطينيين، تتحكّم إسرائيل في أهم مكوّنات رأس المال العام، فتتحكّم في استخدام الأراضي الفلسطينية، بدءاً من السيادة الفعلية بعدم رسم حدود نهائية ورفض الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبالفصل ما بين الولاية على السكان والولاية على الأرض في علاقتها بالسلطة الفلسطينية، بتقسيمها المناطق الفلسطينية إلى أقسام مختلفة تضغط بها 90% من سكان الضفة في 40% منها، محتفظةً لنفسها بباقي المساحة لمستوطناتها التي لا تتوقف.
ورصدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بسياسة الأراضي التمييزية ضد كافة الفلسطينيين، بما فيهم عرب 48، مطبقةً سياسات عنصرية تمنع تصاريح البناء والاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنطقة (ج) التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية، حتى إنها لم تسمح سوى بنسبة 1% من طلبات البناء الفلسطينية منذ عام 2016 حسب بيانات الإداراة المدنية الإسرائيلية، وتضاعف ذلك باستقطاع أراضي فلسطينية عنوة بدعاوى أمن المستوطنات غير القانونية أساساً.
كذا أشارت منظمة إسكوا إلى منع إسرائيل فلسطينييّ الضفة من استخدام نصف أراضيهم الزراعية البالغة 37% من مساحتها، واقتطاع 35% من أراضي غزّة الزراعية ضمن المساحات الحدودية المحظورة على الفلسطينيين، بل وضلوع الجيش الإسرائيلي في رش هذه الأراضي بمبيدات ضارة بالتربة والمزروعات.
وفي هذا السياق، نذكر، مما له بالغ الدلالة، ما أوردته قناة الجزيرة الوثائقية من إحصاء بقطع الاحتلال الإسرائيلي مليونيّ ونصف مليون شجرة زيتون منذ عام 1967، ناقلةً عن أحد أعضاء لجنة طوارئ بلدية غزّة أن الاحتلال قد اقتلع حوالي 70% من أشجارها خلال ثلاثة أشهر فقط منذ بداية الحرب الأخيرة، ما وصفه الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله يومًا: "لم أرَ أحداً في هذا العالم يعادي الأشجار مثل هؤلاء الإسرائيليين وجيشهم".
وتكاملاً مع هذه السياسة، تمنع إسرائيل حفر آبار مياه جديدة، وتهيمن على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، مُخصّصةً 80% تقريبًا من المياه للمستوطنين؛ ما أدى إلى انخفاض حصة الفلسطيني عن المعيار الصحي العالمي البالغ 100 ليتر مياه يومياً، فلا يتجاوز متوسط استهلاك الفلسطيني من المياه 86.3 ليتراً يومياً، بمقدار 86 ليتراً للفلسطينيّ من الضفة، و82.7 ليتراً للفلسطينيّ من غزّة، تنخفض في حالة الأخيرين إلى 21.3 ليتراً فقط من المياه العذبة الصالحة للشرب، بينما يحصل الإسرائيلي على متوسط 300 ليتر مياه يومياً، تصل إلى 816 ليترا في بعض المناطق.
أما الطاقة، فتتحكّم إسرائيل في أكثر من 85% من إمدادات الطاقة الكهربائية في المناطق الفلسطينية، وتديم هذه الاعتمادية بمنع بناء محطات وشبكات توليد ونقل الكهرباء بين المناطق الفلسطينية، بل يمتد الأمر لاشتراط مرور خطوط الغاز التي كان مُزمعاً إنشاؤها لاستغلال حقول غزة البحرية من خلال إسرائيل وبقائها تحت سيطرتها، علماً أنها هي من منعت الاستفادة منها رغم اكتشافها منذ ما يقرب من 25 عاماً، ولم تستجب سوى بعد ضغوط أميركية وضمانات مصرية أواخر العام الماضي.
نتج عن كل ذلك عدم تجاوز حصة الفلسطيني من الكهرباء 15% من حصة الإسرائيلي؛ ما يعكس فارق الانحياز التنموي الهائل لمنظومة الفصل العنصري الاستيطانية؛ باعتبار متوسط وتطور متوسط استهلاك الطاقة أحد أبرز مؤشرات مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي.
سيطرة إسرائيلية على مفاصل السياسة الاقتصادية الفلسطينية
أما على صعيد السيطرة على مفاصل السياسة الاقتصادية، فبفرضها الشيكل عملةً على الفلسطينيين؛ تمنع إسرائيل وجود عملة فلسطينية؛ ومن ثم أيّ إمكانية لوجود سياسة نقدية مستقلة؛ بما يعنيه ذلك من تبعية كاملة للسياسة النقدية الإسرائيلية المنطلقة من مصالح وظروف الاقتصاد الإسرائيلي، رغم الاختلاف الهائل في الأوضاع والدخول بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في غير صالح الأخيرين؛ بما يعنيه من آثار سلبية عليهم جرّاء هذه السياسات التي لا تراعي مصالحهم، بل وتتيح إمكانية تحميلهم أعباء ومشكلات لا تخصّهم، فضلاً عن خلق ميزة تنافسية مُصطنعة للإنتاج الإسرائيلي على حساب الفلسطيني.
تمنع إسرائيل حفر آبار مياه جديدة، وتهيمن على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، مُخصّصةً 80% تقريبًا من المياه للمستوطنين
من جهة أخرى، تسيطر إسرائيل على السياسة المالية الفلسطينية، حيث تتحكّم في ثلثيّ الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية؛ بتحصيلها الضرائب الجمركية وضرائب القيمة المُضافة بفضل سيطرتها على كافة المنافذ والتعاملات الخارجية المفروضة ببروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 (الذي وُقع باعتباره مؤقتاً لفترة خمسة أعوام فقط)؛ بحيث تحوز هي العوائد الضريبية وتقوم بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، ما يخوّلها سلطة فرض كثير من الشروط والرقابة وحتى المنع كما حدث مرارًا، خصوصًا مع كل اصطدام بالمقاومة؛ ما يجعلها أداةً إضافية للسيطرة على الفلسطينيين واقتصادهم وشلّ حركة سلطتهم نفسها عن أي اعتراض.
كانت نتيجة كل ذلك تدهوراً مستمراً في الاقتصاد الفلسطيني، بل وصعوبة استحقاقه هذا الوصف ابتداءً كاقتصاد متكامل ذاتيًا بأي شكل، لا نام أو مستقل، ناهيك عن انهيار إلى ما دون اقتصاد الكفاف في غزة مع الحرب الإجرامية الأخيرة، ضمن سلسلة الحروب المشابهة، الهادفة لتدمير ما بقي من مادته المادية والبشرية.
وقُدّرت تكلفة التضييقات الإسرائيلية على الضفة الغربية بمتوسط 2.5 مليار دولار سنويًا، وبإجمالي تكلفة 50 مليار دولار خلال الفترة 2000-2020؛ لا عجب أن بلغ متوسط دخل الفلسطيني 3789 دولاراً مقارنةً بحوالي 54660 دولاراً للإسرائيلي عام 2022.
ولا غرابة في ظروف الحصار الأشد لقطاع غزّة أن يزدهر اقتصاد الأنفاق كمنفذ وحيد للبقاء على قيد الحياة، الذي تستهدف إسرائيل حاليًا القضاء عليه ضمن محاولتها التهجير الصاخب العنيف لأهل القطاع، ما دام التهجير الصامت السلمي ظاهريًا لم يُجدْ نفعًا، ولم يدفع بالفلسطينيين خارجًا بالسرعة الكافية.