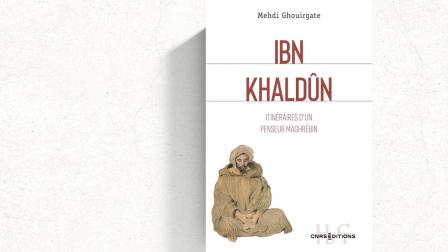الآن، وقد مرّت على موجة "الربيع العربي" بضعُ سنواتٍ، بات من المشروع، بل من الضروري، إجراء مراجعة ألسنية وثقافية لحصاده على صعيد التسميات والدلالات. يحق لنا البدء بإنجاز جَردٍ معجميّ نستعيد من خلاله أهم المفردات التي وُظّفت في تسمية هذه الأحداث التاريخية، بما أنها غيّرت واقع بلدان عربية عديدة وأسقطت أنظمة الحُكم فيها، فضلاً عن مُخرجات جانبية، منها صعود العنف والطائفية وغير ذلك.
لقد بات بإمكان الباحث أن يرى اليوم، بموضوعية أكبر، ما آلت إليه الأحداث فيضع عليها أسماء أدقّ من تلك التي قُدّمت في غَمرة التدافع والتجاذب. فسائر ما كُتب، منذ أن أضرم محمد البوعزيزي النار في نفسه، في ديسمبر/ كانون الأول 2010، افتقد المسافة النقدية وحَكَمَه الانفعال وحتى التلاعب المقصود، فلا يخفى أنّ شخصيات سياسية وأحزاباً، وحتى دولاً، قد جَنحت إلى "ركوب الثورة" وتَوجيهها.
يظل الاسم الأشهر الذي هيمن، طيلة السنوات الأولى، هو "الربيع العربي"، في استدعاءٍ نصّي إمّا لـ"ربيع الشعوب"، الذي عرفته أوروبا سنة 1848، أو لـ"ربيع براغ" الذي شهدته سنة 1968، وكلا الدالّيْن يرتبط بانتفاضة شعوبٍ رفضت الاستبداد ورَنَت إلى الحرية. فهل كان الطابع الجماعي والتلقائي لهذه التحرّكات التي عرفتها عدّة دول عربية في الآن نفسه، هو الذي أوحى بهذه التسمية، أم هو استلهامٌ لإيحائية فصل الربيع وما يعقبه من تفتُّح للأكمام والخصوبة.
في المقابل، استعمَل الرافضون لـ"الربيع" نفسَ السجلّ المجازي، فأطلقوا تسميات سلبية ساخرة؛ مثل: "الخريف" أو "الشتاء العربي"، في إشارة إلى ما في هذَين الفصلين من الانقباض والتجهّم.
من جانب آخر، اعتمد هؤلاء الرافضون للربيع والمشكّكون في ثماره كلمات شديدة السلبية مثل: "فتنة" و"فساد في الأرض" و"بغْي"، فضلاً عن تهمة "الإرهاب" التي فقدت كل معنى لكثرة ما لاكتها الألسن. وجلُّها مفرداتٌ تنحدر من السجل الديني، وبالتحديد من كتب الفقه وعلم الكلام الأشعري التي تعتبر كلّ تمرّد "خروجاً على السلطان" و"نكثاً للبيعة".
ولا هدف لهذه التوصيفات سوى محاربة "أنصار الثورة"، من ذوي المرجعية الدينية، بسلاحهم وإظهارهم بمظهر "الخارج" عن سلطة الإمام. ومعلومٌ ما في كلمة "خروج"، المُلتصقة بفرقة الخوارج، من الشحن السلبية التي تقترن بالكفر والتقتيل. وقد دعمت الأجهزةُ الإعلامية والدينية، مثل دُور الإفتاء، الأنظمة المستبدّة في تعميم هذه التوصيفات والتنظير لها ضرباً للثورة.
وقد حضر هذا السجل الديني بشكل واضحٍ في البحرين والمغرب الأقصى، اللذين رأيا في الربيع "فتنة" وحذّرا منها، ممّا خلق تناقضاً كبيراً في مواقف بعض الدول التي ساندت بعض الثورات في حين وَصَمَتِ الآخرَ بالفوضى. ولذلك استُعيض عن كلمة "ثورة" بكلمة "حَراك" حتى تظلّ الشرعية الدينية، التي تعتمد عليها هذه الأنظمة الملكية، ثابتةً.
ذلك أنّ كلمة "حراك" تفيد مجرّد حيوية يعيشها النسيج الاجتماعي من أجل المطالبة المشروعة بتحسين الوضع الاقتصادي للجهات المحرومة. وهذا لا يزعج، في حين أنّ كلمة "ثورة" من شأنها أن توحي بالانتفاضة والتمرُّد على النظام الملكي القائم منذ قرون وهو "ضمان الاستقرار ورمز للوحدة الوطنية".
هكذا نشطت الآلة السياسية في بلدان عدّة، خصوصاً منها ذات الإرث الديني، في استخدام هذا المعجم الديني واعتماد مفرداته المثقلة بالإيحاءات الأصولية، وكأنّ المجتمعات العربية لا تزال تعيش في ظل الخلافة. وهدفها نَزع مصداقية هذه التحرُّكات الثورية واعتبارها مجرّد "خروج" في غمزٍ من قناة الإسلاميّين.
وأمّا ما جرى ويجري في سورية، فيُمثّل مسارَ تَسميةٍ أعقد، فالثورة أو الانتفاضة ضد نظام الأسد أفضت، على أرض الواقع، إلى شيءٍ قريب من "الحرب الأهلية"، في مفهومها الأبسط، وهو تصارع قسم من الشعب ضد قسم آخر، وإن كانت الحالة السورية محكومة بصراعات إقليمية معقّدة لا يمكن اختصارُها في اسم.
ولذلك تعدّدت المجازات وصوَّرها كلُّ طرفٍ بحسب موقعه في الصراع الدموي الذي دمّر البلاد والعباد. فالنظام لا يزال يصرّ على اعتبار "الثورة" "إرهاباً"، ويؤكّد هذه الوصمة في المحافل الدولية حتى يعطيها طابعاً قانونياً وأمنياً يشرِّع له محاربته. ومن جهتهم، يصرّ الثوارُ على النظر إلى حركتهم، بمختلف فصائلها، كمسار "تحرير" و"ثورة".
وهي نفس اللفظة التي انتقلت من تونس إلى سائر الدول العربية الأخرى وترسّخت في الاستعمال وما يزال يُحال على معانيها لما لها من شُحنٍ إيجابية في التاريخ الحديث، حيث تقترن بالكفاح المسلَّح ضد الاستعمار والنضال لنيل الاستقلال، علاوةً على استدعائِها ولو من طرفٍ خفيٍّ لـ"الثورة الفرنسية"، التي تحتلّ مكانة هامة في مخيّلة المثقّفين التنويريّين.
ومن اللافت أنَّ الجزائر، وهي جارةٌ لها وتقاربها في التاريخ، يُلحّ شبابها على تسمية "ثورتهم" حَراكاً، ربما بسبب حمولاتٍ سلبية التصقت بالصراع المسلَّح، ولا سيما خلال "العشرية السوداء" وما خلّفته من الهلع في الذاكرة الشعبية وفي "ذاكرة الكلمات"، كما يسمّيها رولان بارت.
آثر السودانيّون أيضاً تسمية تمرّدهم على نظام البشير "حراكاً" واعتبروه سلمياً رغم بعض الانفلات الذي عَراه، مجرّد "وَثبة" لاسترجاع السيادة. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب التخوّف من اسم "الثورة" في هذا البلد.
ومن اللافت، أنَّ بعض السياسيّين في المغرب العربي، استعملوا مفردة "فورة"، عبر إبدال الثاء فاءً، في عملية تحقيرية للربيع العربي واعتباره مجرّد فوران شعبي انفعالي، يفتقر إلى التوجيه الفكري ويعوزه المشروع التغييري الهادف إلى وضع حدٍّ للاستبداد.
إذن، تلاعبت، خلال السنوات الثماني الماضية، الأنظمة العربية وقُوى المعارضة والفصائل المقاتلة بما في الأسماء من إيحاءاتٍ ومعانٍ ثوانٍ وحمولات في سبيل توصيف ما يجري. ولا تكاد توجد، في آلاف الخطابات التي أُنتِجت خلال هذه الفترة، تسميةٌ بريئةٌ لا تنخرط، من بعيد أو قريب، في عنف المناورات السياسية ولا تستفيد من الطابع الفضفاض لإيحاءاتها، كأنّ الضّادَ نفسها تواطأت مع هذه الأطراف وأمْكنت من ذاتها حتى تُستغلّ في تشويه الواقع وإقامة بناءاتٍ أيديولوجية لا تساعد على التبصُّر بحقيقة ما يجري وتعطّل اجتراح المقاربات المناسبة لإدراك هذا الواقع.
وتُشبه هذه المناورات التي صاحبت تسمية الثورة في العالم العَربي ما حصل في فرنسا أو روسيا عندما أَطلقت القوى الرجعية كلمة "الأحداث" على التمرُّد الشعبي العارم، هكذا، في برود تامٍّ بغرض نزع الشرعية عنها. وهذا ما أوضحته الدراسة التي أجراها جون- فرنسوا بايار: "عود إلى الربيع العربي" (2014)، وما حاول استجلاءه المفكّر القانوني التونسي عيّاض بن عاشور في كتابه "تونس: ثورة في بلاد الإسلام" (2018)؛ حيث خصّص فقراتٍ مهمّة منه لاستراتيجيات التسمية والتوصيف وما تخفيه من المناورات والرهانات.
فهل تتحمّل العربية جريرة هذه المناورات بسبب ذاكراتها وجمالية إيحائها في "أوقات الأزمة"؟ هل نسينا أنَّ شعار الثورة الأول: "الشعب يريد إسقاط النظام" دوّى فصيحاً جَزْلاً، لا عامياً مُبتذلاً؟