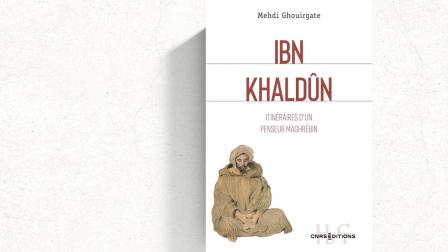كان أحد أسباب وجود الرسم في الكنائس، في حقبات زمنية عدة، أنه وسيلة تعليم للمصلّين الأمّيين. ولأنّ غالبية الناس كانوا غير قادرين على القراءة أو جاهلين للغة التي تتلى بها الأناجيل، اعتبرت الرسوم المحيطة بهم على جدران الكنائس وسيلة بصرية تساعدهم على فهم النصّ المتلو عليهم. وذلك أشبه اليوم بكتاب مصوّر، تساعد الصورة فيه على فهم النصّ.
في الغرب، وخصوصاً في عصر النهضة، تمتّع الرسام بكثير من الحرية في تجسيد النصّ الديني، بأحداثه وشخوصه داخل الكنائس. هذه الحرية في تأليف العمل الديني الفنّي، سمحت للفنان الغربي من خلال اعتماده على أسس المنظور، أن يبتكر، مثلا،ً المكان الذي يراه مناسباً لحصول الحدث المرسوم، بحسب ذائقته أو حساسيته الفنية، حيث يرينا الأفق والسماء والحدائق ونور النهار الملائم لتوقيت حصول الحدث.
كما أنّ اعتماده على لعبة "النور والظلّ" في تنفيذ العمل المرسوم؛ جعلت الرسم أقرب إلى الحقيقة، حيث تظهر الأبعاد وتغيب المساحات المسطّحة.
اعتماد تقنية "النور والظلّ"؛ جعلت الشخصيات المرسومة في الأعمال الدينية لفنّاني عصر النهضة يبدون كأنّهم أشخاص حقيقيون من لحم ودم، يتحرّكون في المكان ويعبّرون من خلال طريقة جلوسهم أو وقوفهم، التي تتغير بتغير الأعمال والفنانين الذين أنتجوها.
فلكل رسام أسلوبه الشخصي وطريقته في معالجة موضوعه. وقد اعتمد هؤلاء الرسامون على "موديل" حقيقي لرسم الشخصيات في أعمالهم الدينية، مثل لوحة "عذراء سيغيولا" لرافاييل، التي تشبه حبيبته فورناريانا، التي رسمها في لوحة "بورتريه".
أما الأجسام المرسومة في هذه الأعمال، فهي أجسام حسيّة ممتلئة حركة ومشاعر وأحاسيس. فجسد المسيح في كنيسة سيستين في الفاتيكان لمايكل أنجلو، هو جسد جميل مشدود العضلات يذكّر بأجساد الآلهة الرومانية القديمة، ولا يشبه على الإطلاق الأجساد الضامرة التي نراها في الأيقونات البيزنطية التي تختفي تحت ثنيات الثياب بأشكالها الهندسية الصارمة.
إذاً، رغم الموضوع الديني للفنّ الغربي، يبقى الرسام الفرد هو صاحب القرار، فتنتفي بذلك صفة المقدّس عن العمل ليصير دنيوياً، بينما لا يتمتّع رسام الأيقونة الشرقية بتلك الحرية التي يتمتع بها نظيره الغربي، فهو لا يمتلك موضوعه، بل يصوغه معتمداً على النصوص المقدّسة، وعلى نموذج أوّلي (بروتوتيب) وتحت إشراف لاهوتي، له سلطة قبول أو رفض قانونية الأيقونة المرسومة.
فالأيقونة المرفوضة، التي لم تخضع للأسس الصحيحة، لا يُصلّى عليها ولا تستقبل حلول الروح القدس. لذا لا يقال عن المشتغل بالأيقونة الشرقية إنه "يرسمها" بل "يكتبها"، تماماً كما يكتب النسّاخ من الرهبان الأناجيل المقدسة.
للأيقونة الشرقية أسس ومعايير صارمة ونموذج تقتدي به. فمن غير المسموح أن تظهر شبهة لأية حسيّة أو شهوانية على الأجساد والوجوه، لأنّ شخوص الأيقونة لا يعيشون في العالم المادي الذي نعرفه، وإنما في العالم الروحي والمقدّس المطموح إليه.
هنا، لا مكان للفردية والمزاج الشخصي. الوجوه المرسومة كأنّها وجه واحد في الأساس، وجه روحاني تحيط به هالة القداسة بجبين عريض يمثّل الحكمة وحضور الروح، وأنف دقيق بنبل بالكاد يتنفّس، وفم مغلق بشفتين رقيقتين لا اشتهاء فيهما، وعينان واسعتان هما مرآة للروح، تنظران مباشرة ومن دون مواربة إلى الناظر إليهما.
في الأيقونة الشرقية، يغيب المكان والزمان الماديان؛ لذا لا يوجد رسم للمنظور فيها. وإن اضطر صانعها إلى رسم مكان محدّد لضرورات تجسيد الحدث الذي يتناوله، فهو حينها يعتمد على تغيير وجهة المنظور، حتى لا يتطابق مع الواقع. فالمكان هنا مسطح وخفيف حتى بصخوره التي وإن رسمت تبدو وكأنها تحلق نحو الأعلى. وقد يصل تسطيح المكان إلى تحوّله بالكامل إلى ورقة من الذهب تجعل الضوء يعمّ في كامل أرجاء مساحة الأيقونة.
ومع غياب الزمان عن الأيقونة، يغيب عنها أي مصدر للضوء الخارجي الذي يحدد وقت النهار بحسب وقوعه على الأشياء. في الأيقونة لا نرى ظلالاً بل عالماً كاملاً من النور. مصدر النور في الأيقونة لا يحضر من خارجها، إنه نور داخلي يشع من باطن الأشخاص المرسومين فيها. وللحصول على هذا التأثير البصري، يبدأ رسام الأيقونة بتلوين الوجوه والأجساد بطبقة من اللون البني المحروق، تليها طبقات لونية شفافة يفتّحها تدريجياً، ليصل بعد ذلك إلى ضربات خفيفة من الأبيض يجسّد حضور الضوء والروح معاً، فيبدو الأشخاص مضاءين من الداخل.
حتى الألوان في الأيقونة الشرقية لا تتبع ذائقة الرسام ومزاجه الشخصي، فلكل لون رمزيته وطريق استعماله ومكانه المحدّد، فقميص المسيح أحمر قرمزي، والرداء الذي يلفه أزرق غامق، وتستعمل الألوان نفسها بطريقة معكوسة في تلوين ملابس مريم العذراء، فالأزرق هنا يرمز إلى ما هو إنساني، بينما يرمز الأحمر إلى ما هو إلهي. وملابس المسيح في "أيقونة القيامة" أو "أيقونة التجلّي" بيضاء مذهبة رمزاً للنور.
أما التنويعات بين الأزرق والأخضر الخفيفين فنراها في ملابس الملائكة، التي تتضارب مع الأسود الثقيل المستعمل في رسم الأفعى أو التنين، الرمزين الأكثر استعمالاً في تجسيد الشيطان مسحوقاً تحت أقدام المسيح أو العذراء أو القديسين.
حافظت الأيقونة الشرقية على المقدّس فيها لأنّها اعتُبرت نصاً بصرياً مقدساً يحلّ فيه الروح القدس، ومرادفاً للأناجيل المكتوبة، لأنّها بالنسبة لرسّامها صلاة وطقس روحي أكثر من كونها إنجازاً فنياً فردياً وخاصاً. لذا فغالبية رسامي الأيقونات قديماً ظلّوا مجهولين لا يوقّعون أسماءهم على أعمالهم؛ لأن فعل التوقيع يفترض الغرور الدنيوي والمادي، وإعطاء أهمية لشخص الفنان على حساب أهمية الأيقونة وقداستها غير المادية.