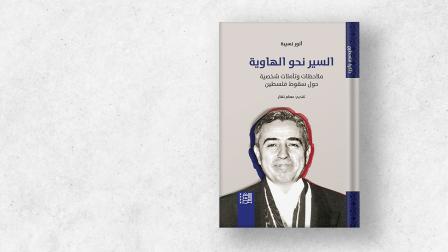ننشر على حلقات رواية "حدائق العاشق"، للشاعر والروائي والناقد الراحل محمد الأسعد الذي غادر عالمنا في سبتمبر/ أيلول 2021، وكان من طليعة كتّاب القسم الثقافي في "العربي الجديد"، وأحد أبرز كتّاب فلسطين والعالم العربي.
"لا شيء يدوم في الزمن اللانهائي"
(من قصيدة على جدار بيت في بومبي الرومانية)
موقفُ الترامفاي يُواجه "فندق الرودينا". العاشرةُ مساء. أصواتُ غناء تجيء من الطابق الأول المُضاء. على الرصيف فلبّيني بيدٍ معوجّة أمام محلّ تسجيلات. وعلى خطوط الترامفاي الحديدية تقف بلغارية عجوز ذاهلة لا تعرف إلى أين تذهب كما يبدو. ثمّ لا أحد. أو لا شيءَ يُضاف إلى المشهد. وسيتعمّق اللاشيءُ حين يعرف بعد ذلك أنّ الترامفاي الذي ينتظره وحيداً لن يجيء.
حين يقول.. "لا شيءَ"، جواباً على سؤالٍ عن الأحوال أو عن غاية ما، فإنه يقذف جوابَه كما يقول من عمق الصمت الكوني الأخير الماثل. من تلك اللحظة التي لا تسود فيها سوى ذكرى الإنسان. إنه لا يعتني بالعابر والزائل، بل يمضي مباشرةً إلى الماثِل الأبدي. فمنهُ تجيء الأجوبةُ. الإنسانُ لا يتذكّر بل الكواكبُ المهجورة والمجرّاتُ البعيدة. اللاشيءُ هو جواب الأزل أو اللانهائي أو الصفر في معادلة سوفوكليس:
"أيها البشرُ الفانون يا مَن تعيشون الآن، مَن حلّ به الفناء منكم ومن سيفنى، لقد حسبت مجموع حياتكم فكان يساوي صفراً".
ينهض عن سريره ليُعِدّ قهوته، ويتأكّد أنّ خزانة الجوز مُغلقة على أشيائها العزيزة
مرّة أُخرى خطر بباله هذا "اللاشيءُ" حين استوقفه مشهدُ رجل مُتعَب على مقعد عريض في آخر الليل أمام محطة باصات. كان الرجل ملتفّاً بمعطف سابغ. غافياً أو مستيقظاً، ولا شيءَ يُنبِئ بأن باصاً سيجيء. محطةٌ مهجورة في صحراء. لا طريقَ منها أو إليها. فما الذي ينتظره؟ أو ما الذي ننتظره بالأَحرى؟
يمرّ بالتماثيل البرونزية المخلوعة عن قواعدها، وتلك المُلقاة بين الأعشاب الرطبة وقطراتُ المطر تنزلق على معدنها الأخضر المُعتم، مهملةً في هذه الزاوية من العالَم. الأطفالُ يتزحلقون على أجسادها. يقفزون بوجوههم الساخنة ومعاطفهم الصوفية. الأمهاتُ منشغلاتٌ بالأحاديث على المقاعد الخشبية الخضراء.
النهارُ في أوّلهِ يُشيع الحنانَ في الجوّ، أو يُشيع شيئاً حاضراً وماثلاً. معنى. يستيقظ بافلوف، وهو مستيقظٌ الآن بالتأكيد في شقّته الصغيرة. ينهض عن سريره ليُعِدّ قهوته الصباحية، وليتأكّد أنّ خزانة الجوز لا تزال مُغلقةً على أشيائها العزيزة. تلك الشيوعية العنيدة التي تركتْ له المجلّات النسائية، الكتب، دفتر اليوميات ونظّاراتها الطبّية، وهذه العاصفة الغامضة التي حطّمتِ التماثيلَ وقوّضتِ الصروح الرخامية، وكسرتْ مصابيح الحدائق، ونثرت كافتريات الساندويشات والقهوة السريعة في كلّ مكان. انهيارٌ عصيٌّ على الفَهم لصرحٍ بدا أنه ينتمي للأزل.
لا يبدو بافلوف مُترنّحاً تحت هذا الثقل، بل خفيفاً إلى درجة لا تُصدق حتى هذه اللحظة التي بدأ يتخطّى فيها أعوامه الثمانين صامتاً.
وبدا الآن وراء زُجاج النافذة مثل شبحٍ طويل يُراقب النهارَ المُنتشر بين أوراق أشجار الحديقة المواجهة، وشعرِ النساء العائدات من السوق أو المكاتب الكابية، وعلى وجوهِ التلاميذ الصغار العائدين من المدرسة وحقائبهم على ظُهورهم وهم يتقافزون بين الأشجار المُشمسة.
النهارُ في أوّله حيث يمرّ النسيمُ على البوكنفيليا المُثقلة، وبين أوراق المندلينا، وعلى المقاعد البيضاء المتناثرة. لا زال النهارُ في أوله يحمل أشياءه إلى الحديقة الخالية. يتوقّف عند السور باحثاً عن شيء يلمسه. شيء يتعلّق بالإنسان. كوب شاي، أو قدحٍ، أو طائرٍ ملوّن من الفخّار ما زال ملقياً كما كان بالأمس بين الأعشاب.
النهارُ أيضاً يبحث عن الشيء. النهارُ يتخيّل نفسه أبديّاً، وهو يرتفع فوق جبال التيبت فتلقي ظلالها على الجانب الآخَر المُعتم، ويستقبله وجه جين الساهمة. يرفّ جفناها وتتعمّق خضرةُ عينيها ويلمع شعرُها الكستنائي القصير فوق تلك الصخرة الناتئة على سقف العالم.
النهارُ في أوله يشيع الحنانَ والمعنى، فيبدو اصطخابُ الموج على شاطئ هاواي نداءً للجسد.
ليندا تستلقي في حالتها الذهبية تحت شمس خطّ الاستواء. صحوٌ ومطرٌ، أو غيمٌ ونهارٌ في وقت واحد. تتساوى الأشياءُ، وتبدو العواصمُ في الذاكرة قريبةً من هذه الصخرة أو هذه الموجة، وهذه السماء المفتوحة على القارات. صورُ العشاق يأخذها الموجُ بعيداً، وليندا تتذكّر، تهتدي بالأمواج.
لا يبدو أنّ أحداً ظلّ في هذه الظهيرة غير عصافير الدُّوري، وآنيةٍ فخارية مُلقاة
ما إن تتطاير شفافيةُ الفجر، ويبدأ لغطُ الناس في أوائل النهار، حتى أراكِ تتقدّمين مُثقلةً إلى الحافة. حافة الضوء، ذلك اللاشيءُ الذي يتلبّس كلّ شيءٍ فجأة، ويأخذ بالامتداد من حافة الأريكة إلى أقصى الصالة إلى البوّابة. ويتوقّف دون الحديقة، دون البوكنفيليا المُثقلة، وشجيرة المندلينا، ودون كلّ ما كان.
السماءُ لا تزال عاليةً، فضاءٌ شاسع من البرتقال والتركواز. وبعيداً تتغيّر أشكالُ البيوت وملابسُ الناس. ترتفع المباني الإسمنتية بجوار البيوت الطينية الصغيرة. الجدرانُ تتغيّر، تتهدّم، وتنهض من جديد وخلفها الصحراءُ والغبار الدائم.
فيتوشا يُغطّيه الضباب. رماديّ وقاتم منذ أزمانٍ بعيدة. يواجهني في أيّ مكان أكون فيه. حاضرٌ إلى درجة معذّبة. بالكاد تظهر خلفه السماء. بالكاد ينفذ الخيالُ إلى ما بعده. أخاديد وأثلام تظهر تحت الغيوم البيضاء الطافية. أخاديد وأثلام حتى نهاية الأفق المُنخفض، واستدارة الأرض. لا أحدَ يتحرّك في هذا السكون. ولكن بعيداً، ربما يبدو النهار مُشرقاً، وتمتدّ ظلالُ البوابات: مدنٌ ومُغادرون وراحلون. تلتمع المنائرُ وبحيراتُ النخيل وخطوطُ الأنهار الساكنة، وتخترق الصحراء خطوطٌ بيضاء طويلة متعرّجة لا يبدو أنها تقود إلى مكان. وحيدةٌ تدور حول نفسها، نوعٌ من متاهة مهجورة.
يتوقّف العابرُ في طريقٍ تُرابي ضيّق تُضيء الشمسُ نصفه. جدرانُ بيوتٍ عالية بلا نوافذ. البابُ الخشبيّ، ثم الدهليز، فالحوش المظلّل بالنخيل والسدر ورطوبة المياه. لا يبدو أنّ أحداً ظلّ في هذه الظهيرة غير عصافير الدُّوري، وآنيةٍ فخارية مُلقاة حتى الفجر. لا أحدَ في الظلّ أو في النوافذ المُطلّة على الحوش. لا أحدَ على السطح حيث تسطع الشمس وتتوهّج. البيوتُ المجاورة سطوحٌ خالية، والفضاءُ البعيد بياضٌ ونخيلٌ نحيل. ضرباتُ فرشاة باهتة في أقصى النهار.
في صالةٍ واسعةٍ. أرى نفسي مُحتشداً بالمنطق والموسيقى وتاريخِ المُدن والديانات السرّية. أراكِ وراء البيانو تُضيء وجهكِ شمسُ أوائل النهار، وخلفكِ عتمةٌ أرجوانية. تتساقط نغماتُ الموسيقى. تنداح دوائرَ دوائرَ، تتّسعُ وتتّسعُ حولي وحولكِ.
حين كنّا صغاراً، أعني وراء الزمان، في أجمةٍ غابيّة تُحيط ببحيرةٍ مفتوحة على السماء، كنا نتطلّع دائماً إلى الفضاء، متوقّعين أن تظهر الطيور. الطيور الآتية من بلادٍ لاسمها طعمُ التفاح والياسمين، ومن غير أن تلاحظنا تحطّ واحدةً بعد أُخرى، تنزع الطيورُ ثيابها الريشيّة وتنقلب إلى نساءٍ يتراكضن إلى ماء البحيرة.