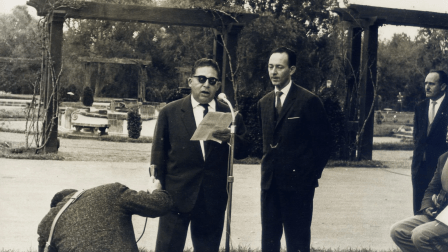عندما علِم أحد الأصدقاء أنّ ظروفاً مواتية ستسمح لي بالتفرّغ من مهنتي كمترجم لبضعة أشهر، كتب إليّ: "سيكون بمقدورك أن تعيش ذلك الجنون، جنونَ تكريس نفسِك ليلاً ونهاراً لعملك (هكذا يجب أن يعيش الرهبان، بصمتٍ، ذاك الجنون الآخر، جنون الرهبنة)". أصابتني هذه الجملة بالصدمة، كما لو أنّه كان ضرورياً توجيهُها إليّ لأُدركَ، فجأةً، وباستغراب، إلى أيّ مدىً كنتُ غريباً على هذا "الجنون". وبدأت أحلم بذلك وفيّ رغبةٌ غامضة بأن أعثر، في نهاية حلم يقظتي، على ما يضيء حيرتي.
أعترف، رغم شعوري بالحرج، أو الندم على أية حال، أنّني لا أعرف، ولم أعرف قط، حتّى في سنّ مبكرة، هذا "الجنون" (أمرٌ يبدو واضحاً، للأسف، في كتُبي). لم يسبق أن استحوذتْ على خيالي شخصيّاتٌ أو حكايةٌ، كما يجري مع الروائيين، ولا حتّى كما جرى مع شخص مثل جياكوميتي، المهووس بإنجاز "شيء ما"، والوصول إليه بأيّ ثمن، رغم كل الصّعاب. أدين لنفسي أنّني كنت دائماً ــ بسب الافتقار إلى ما هو أفضل ــ واضحاً بما يكفي لكي لا أتخيّل أنني بكتابتي أنجز عملاً هامّاً وحاسماً (عملاً لم أكن أعتبره، في المقابل، عديم الفائدة تماماً). في البداية، باشرت العمل من دون حتّى أن أفكّر في الأمر تقريباً، كما لو كنت أستجيب لحاجة، لكن من دون تحويلها إلى عالَمٍ في حدّ ذاته.
لم أكن لأكرّس ليلة واحدة لهذا العمل، فحسب، بل إنني، حين كنتُ أباشره، لم أكنْ أقضي أكثر من ساعات قليلة فيه، من دون تحبير كثيرٍ من الصفحات، أو شطب الكثير من الكلمات فيها. هل أجرؤ، إذاً، على الحديث عن عمل؟ كنتُ آمل أن أقول، بوضوح، كيف كانت الأمور تجري، في باريس، على سبيل المثال، بين عامي 1946 و1953، عندما كنت أشتغل على مجموعة "الجاهِل"؛ لكنّ الحال أنّ ذاكرتي ضعيفة، ولا أتذكّر تلك التفاصيل جيّداً. يمكنني، ببساطة، القول إنه باعتبار أنني كنت أعيش بمفردي، منعزلاً (لا ناسكاً ولا أناركيّاً، بل أشبه بشخص عاديّ، بالكاد موجود، تتملّكه خِشيةٌ مفرطة)، فإنّني ضمنت نوعاً من الصمت مِن حولي.
بفضل هذا الصمت (المتقطّع، على أيّة حال)، تكثّفت فيّ عواطف وأحلامُ يقظة وذكرياتٌ بدت، في لحظات معيّنة، وكأنّها تستقرّ مِن تلقاء ذاتها تقريباً ككلماتٍ على الصفحة. في الواقع، لم تكن تستقرّ فحسب، بل كانت تنتجز وتكتمل على الصفحة. أعتقد أنّ ما كان يحدّد هذه اللحظات هو درجةٌ معيّنة من التوتّر العاطفي يصبح معها عدم التعبير عن هذه الأحاسيس أمراً مؤلماً؛ أي، بعبارة أخرى، كثافة الحياة التي كنت أعيشها. كان يعني هذا، ببساطة، عيشَ تجربة "الإلهام"، لكن من دون إعطاء هذه الكلمة، حينها، قيمةً سحرية أو غامضة أو سامية.
إذا كان لنصوصي أن تمسّ غيري، فلأنها تمتح من مخزون مشترك
هل هو نوع من الكتابة التلقائية؟ أبداً، لأنّ ما كنت أنتجه ظلّ دائماً متماسكاً، منطقياً، وبعيداً عن تهويمات المخيّلة الحالمة، في نومها أو في يقظتها، عن قصد أو بشكل طبيعي. ومع ذلك، كان ثمة قاعدة عامة تقضي بالتالي: إمّا أن تُكتب القصيدة دفعةً واحدة وبسرعة (وهو ما كان يتيح لها فرصة الوصول إلى شكلٍ ما و"النجاح" نسبياً)، أو أن تفشل. لم يكن ثمة مجال إلّا لبعض التعديلات الطفيفة، المتفرّقة. كما لو أنّها شقّت طريقها بنفسها، أثناء نومي أو أعمالي اليومية، قبل أن يجري تدوينها على الورق. على كل حال، من المؤكّد أنّني، في ذلك الوقت، لم أكن قط أبحث عن شكل، جديد أم لا. كنت قد بدأت في سنّ مبكّرة، كغيري، بكتابة قصائد كانت مجرّد نسخ باهتة ــ لا فرادة فيها ــ من أعمال كنت منبهراً بها. وحتى لاحقاً، لا بدّ أن مقاطع القصائد المختلفة بقيت، من دون وعيٍ منّي، عالقةً في ذهني عندما كان يشكّل كتاباته الخاصّة؛ ولا بدّ أنّ آثاراً منها تسرّبت، بطبيعة الحال، إلى هذه الكتابات.
لكنْ مع نضوجي، كان لا بدّ من إجراء فرْزٍ بين الإيقاعات والصور والكلمات الغريبة التي ظلّت تشغل حيّزي الداخلي حتى لا يبقى إلّا أقلُّها غرابة، وأكثرها سرّيةً ونُدرة. هكذا، شيئاً فشيئاً، من دون تدخّل فعليّ منّي، ومن دون أن أفكّر في الأمر كثيراً، كان ما أكتبه بتلك الطريقة يستفيد من ازدياد خبرتي بالحياة ثراءً وقوّةً، ما جعله أقرب من فراد تجاربي وأعماقي، التي سمحت لي بعضُ لحظات العزلة والتركيز بمقاربتها.
ما معنى كل هذا؟ معناه أنه ساعدني قليلاً على العيش. فعبْر محافظتي على إمكانية الشروع بهذا العمل ــ الذي لم يكن عملاً فعلياً ــ استطعت أن أبقى على صِلةٍ بهذه الأعماق في داخلنا. وأعتقد أنّه إذا كان لهذه القصائد أن تمسّ شخصاً غريباً، فإنّها لا تستطيع فعل ذلك إلّا لأنها تمتح من هذا المخزون المشترك، الذي يعني الاستغناء عنه مشيَنا نحو حتفنا، كما يبدو.
لاحقاً، بلا شكّ، تغيّرت الأمور قليلاً، وأصبحت مثل الكتّاب الذين يعملون (لكنني ما زلت لا أعمل كأولئك الذين يمثّل العمل، بالنسبة إليهم، كفاحاً أو نشوة). ذلك أنّ مراجع التفكير، وأسئلة الفكر أصبحت أكثر إلحاحاً في ذهني. لذا، بين مجموعتين شعريّتين تخضعان للقوانين ذاتها، كانت النصوص النثرية تجد مكاناً مناسباً لها. وقد ذهبت في هذا الأمر ــ مدفوعاً بفخري بـ"العمل" أخيراً، وبتشجيع شخص مثل فرانسيس بونج ــ حدّ الكشف عن عوالم هذا العمل. كنت أحاول فهم اللغة المراوغة للمناظر الطبيعية قرب مكان سكني. هذه المرة، كان على وعيي اختيار المفردات التي لا تخون ما تقوله تلك المناظر الساحرة. ومع ذلك، حتّى في ذلك الوقت، كان عليّ الاعتراف بأنه لا ينبغي التدخّل كثيراً، وأن الانكباب ليس سبيلي إلى النجاح، وأنّه كان علي التخلي نهائياً عن مجد "الصراع مع العمل" (الذي يدهشني، بالمناسبة، لكنّه لا يستهويني).
المجموعة الوحيدة من أعمالي التي كانت موضوع عمل حقيقي، بل استغرقت وقتاً كثيراً، هي قصائد "دروس" أو "عِبَر"، لكنّها، في الوقت نفسه، المجموعة التي لطالما اعتبرتها الأقلّ كمالاً. وإذا كان عليّ العمل على هذه المجموعة، فلأنّها لم تحظَ، في تشكُّلها، بالتماسك الداخلي الذي انبثقت منه الأعمال السابقة. كنت حائراً. ولا يمكن لأيّ عمل، مهما كان متقناً، إظهار وحدةِ ما هو ممزّق من دون أن تظهر لنا، على الفور، آثار الترقيع فيه.
إمّا أن تُكتب القصيدة دفعةً واحدة وبسرعة، أو أن تفشل
هذه الحيرة في تصحيح وتنقيح النص تقترب من إيمانٍ ما بالخرافات. قبل فترة قصيرة، كنت قد عرضت مجموعة من القصائد التي لم أكن متأكداً منها على بعض القرّاء المقربين؛ أشار أحدهم بنزاهة شديدة إلى ما لم يحبّه في النص؛ وفي معظم الحالات، كنت متّفقاً معه. كان من الأفضل اتباع نصيحته. فكّرت في ذلك، حاولت تبنّي مقترحاته، لكنني تخلّيت عن الأمر بسرعة. من الصعب أن أقرّ بأنّ ذلك كان محضَ كسلٍ، وواصلت الاعتراف بالعيوب التي جرى توضيحها لي. لكنّني أعتقد، في المحصّلة، أنّ ما منعني من تغيير أيّ شيء هو، ببساطةٍ عبثيّة، ذلك الشعور بأن التصحيح سيكون مصطنعاً بعض الشيء، وبالتالي فهو غير أمين، مثل تدخّل شخص مزيّف. إنه ارتياب غير عقلانيّ حقاً، لكنّه قوي بما يكفي للانتصار على الوعي بوجود عيوبٍ في النص.
إذا حاولت اليوم أن أفهم بشكل أفضل ما كان يحدث في داخلي، بشكل واعٍ أو غير واعٍ، خلال فترة "الإبداع"، وفي تلك اللحظات النادرة جداً من التركيز والإنصات إلى الأعماق، فعندها سأقول لنفسي إن العمل لا يتمثّل في "البناء" و"الصياغة" و"التشييد" بقدر ما يتمثّل بالسماح لتيّارٍ ما بالمرور، أو بإزالة العوائق أمامه، أو محو الآثار. كما لو أنّ على القصيدة المثالية أن تُنْسِي ذاتها لصالح شيء آخر لا يمكن أن يتجلى، مع ذلك، إلّا من خلالها. منذ ذلك الحين، بات أقلّ إدهاشاً أن يصبح عملي مشابهاً لإدارة التدفّق في سرير النهر، حيث تظلّ قوّة التيار أكثر تأثيراً من تدخّل دفّة السفينة ــ مهما كان هذا التدخّل ضرورياً ــ ومن جهد المجاديف في بعض الأحيان. هل هو الصراع، بشكل مأساوي، مع العمل؟ لا. إنه الانمحاء، تقريباً، لصالح القوى المجهولة التي تخترقنا، ترفعنا، وتدفعنا جانباً.
يفهم المرء جيّداً، فجأةً، أنّه إذا تغلّفت لحظات الصمت، التي تسمح بتكثيف القصيدة، بالضجيج، خارجياً كان أم داخلياً، فلا يمكن لأيّ جهد أن يحلّ محلها، كما لا يمكن الصمت أن يكون منتِجاً إذا ما صار صمتاً ينمّ عن فراغ. في تجربة كهذه، لا يمكن أن تكون الكتابة فعلاً مجّانياً أو متعمّداً. إذا لم يكنْ لجلَبة النهر المتدفّق في الأعماق أن تصل إلى سمع الأذن المرهفة، فلا يمكن حينها لأيّ عمل أن يُنتِج إلا صنعةً خاصة يبقى الصمتُ، بلا أدنى شكّ، أفضل منها.
ربما أصبح الأمر أكثر وضوحاً الآن: إذا كان ثمة عمل، أو كفاحٌ، أو ربما جنون، فإن هذا العمل يجري في مكان آخر غير الصفحة، بعيداً عن طاولة الكتابة؛ أما موهبة الكاتب، فتبقى غير كافية، ليس فقط لضمان نتيجة هذا العمل، بل حتى لتعديلها.
* ترجمة من الفرنسية: ميشرافي عبد الودود