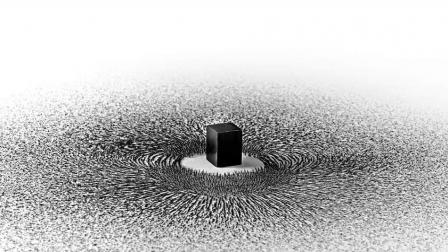لم يعد حريق الكتب استثناء، ولا يعبّر عنه بإضرام النار فقط، بل بمصادرتها ومنعها وإتلافها أيضًا، وقد يُحرق مؤلفوها معها، أو يُعدمون، أو يُسجنون ويطارَدون، لا ينجو منهم سوى الذين يغادرون بلدانهم، ولا يستبعد ملاحقتهم إلى بلدان المهاجر، فيغتالوا بضربة فأس، أو مسدس كاتم للصوت، أو بالسم، فالعالم يتقدّم.
في القرن الماضي، كان للنازية مأثرتها الكبرى في تنظيم أكبر عملية إعدام للكتب طاولت آلاف العناوين، استمرت ثمانية أشهر من عام 1933. غادر معظم كتّاب ألمانيا ومثقفيها وفنانيها البلاد ونجوا بأرواحهم، كانت أكبر هجرة شهدتها أوروبا، تفوّقت عليها في هذا القرن، بما لا يقاس هجرة السوريين التي بلغت نحو سبعة ملايين.
لم تقتصر مجزرة الحريق على الكتّاب الألمان، فهي لم توفر أبرز كتاب أوروبا وأميركا، وكل من انتقد الأيديولوجية النازية. اتهم مؤلفوها بأنهم بلاشفة أو أصولهم يهودية، فالكتب ليست بهذه البراءة التي نظنها، وإلا لم تُستهدف بالنار.
لا تحتاج الانقلابات إلى الجاحظ والتوحيدي أو أرسطو وسقراط
من جانب عمليّ، الدول الشمولية ليست بحاجة إلى كتب تتحدّث عن العقل والحرية، فالعقل مثل الحرية كلاهما لا لزوم له، ولا إلى كتاب يكتبون ما شاء لهم، فالكتابة ليست فوضى، والدولة مكتفية بما لديها من كتب وكتّاب ومثقفين وفنانين.
هذه الإجراءات لم تعد ابنة وقتها، باتت سارية، فعسكر الانقلابات لا يخفون استهتارهم بالكتب، فقد نشأوا على كراهيتها، ولا مزاج لهم للقراءة والكتابة. انتسبوا إلى الجيش كي يتخلصوا من رهاب الامتحانات، ما أورث لديهم عداوة للكتب، إنها أشبه بعقدة نفسية، لا تخفي اشمئزازها من الورق والحبر.
ولا شك في أن لهذه العقدة جانبًا واقعيًا، فالكتب لا تساعد على الاستيلاء على السلطة، والأصح أنها تضع العراقيل، من ناحية أنها تدعو إلى التفكير، ماذا يعني التفكير، ما دام المعوّل في التقدم على الدبابات والطائرات، وخطة الانقضاض على بناء الإذاعة والتلفزيون، لا تحتاج إلى الجاحظ والتوحيدي ولا أرسطو وسقراط. الجيوش تعرف طريقها الوحيد إلى المستقبل، وإن كان الادعاء حسب البلاغ رقم واحد، الدفاع عن الوطن. وحسب الواقع، تشييد دكتاتورية وطنية، محلية صرف، مع الوقت تصبح وراثية.
أما السياسيون والمثقفون والفنانون الملتحقون بالانقلاب، صانعو الخطابات والشعارات والاحتفالات والمهرجانات الوطنية والفنية، تلك التي تشكل ثقافة العامة، فهي تعمل على تزويدهم بالأفكار مع المتعة والتسلية. بينما رجال الأعمال صانعو الاقتصاد، الحريصون على الوقت، إذا قرأوا فلا أكثر من بيانات الاستيراد والتصدير، وحركة البيع والشراء، وعقود الصفقات، وأرقام البورصة، وصعود العملات الأجنبية وهبوط العملة المحلية، وتدقيق الميزانية السنوية.
لا يذهب بنا الظن، أن كبار رجال الدولة ليسوا مضطرين للقراءة. بالعكس، فمثلًا في فروع أجهزة الأمن، لا يمارسون التعذيب فقط، إنهم يقرأون أيضًا، تقارير الوشاة والمتنصتين والمتجسّسين، والاعترافات تحت التعذيب، أحيانًا لا يقرأونها، لأنها من بنات أفكارهم، مجرد أن المعتقلين يوقعون عليها.
اللافت في هذا الاستعراض، ويا للعجب أن كل هذا النشاط ، وهذا الطاقم من المسؤولين لا يعرفون الكتب، إذ لماذا الثقافة؟ وإذا كانوا لا يكتبون، فلأن لديهم موظفين يقومون بالأعمال الكتابية. أما كيف تسير أمور الدولة، فقطعاً ليس بالإلهام، خاصة أنهم ليسوا بالأشخاص الملهمين.
إذًا من الذي يقرأ الكتب؟
شخص واحد، يوفر متاعب القراءة على الآخرين، فهو الذي يصنع السياسة والثقافة والاقتصاد والفن، إنه الانقلابي الذي أصبح دكتاتوراً معترفاً به دولياً، لا يحيج هذا الطاقم إلى العودة إلى الكتب، وهو بالذات لا يقرأها، يطلع فقط على تقارير رؤساء الأجهزة الأمنية. وما يقوم به الموالون له، أنهم يسيرون على هدى خطاباته وإرشاداته وتعليماته وتنظيراته وأقواله... ينهلون منها مقالاتهم وتحليلاتهم وتمثيلياتهم وأدبهم وأشعارهم وأفلامهم وأغانيهم وموسيقاهم وأكاذيبهم.
ليست مهزلة، إنها حقيقة.
* روائي من سورية