في أكثر مكتبات فرانكفورت وباريس ولندن عراقة، وغير بعيد عن جناح الفلسفة، من المألوف أن نجد ركناً مخصّصاً لـ"علوم الأسرار" تُعرَضُ فيه أحدث كتب السحر والكهانة والتنجيم، موشّاةً بصور الوحوش والأشباح والكائنات الشرّيرة.
وإذا كان المتمسّكون بالعقلانية الغربية لا يأبهون بمثل هذه الإصدارات من منطلق كونها "عاميّة متهافتة"، فإن الباحثة صوفيا روز آريانا في عملها "المسلمون في المخيال الغربي" (منشورات جامعة أوكسفورد، 2015) قد أعادت لها الاعتبار ففحصتها واخترقت طبقاتها المتراكمة بحثاً عن "وحوش المسلمين" الذين سكنوا عبر العصور وعي الغرب وما زالوا يسكنون إلى اليوم لاوعيه.
منذ الفقرات الأولى للمقدّمة، تعلن آريانا أن كتابها يطرح سؤال الحاضر وينطلق من قضايا الراهن التي تميّز علاقة الغرب بالإسلام، وهي علاقة تتجلّى عبر مظاهر عديدة ومستويات متفاوتة الخطورة والدلالة؛ أدناها حظر ارتداء الحجاب وحجر تشييد المساجد ومنع إعلاء الآذان؛ وأقصاها ترحيل "المحاربين الأعداء" إلى الأماكن السريّة كمعتقلي غوانتانامو وأبو غريب والسماح بانتهاك حرمتهم الجسدية، خلافاً للقوانين المحليّة والأعراف الدولية.
ولكن مشاغل الحاضر وقضاياه لا تجد إجابتها - حسب الكاتبة - في الوقائع الأقرب إلينا زمانياً، أو تلك التي تعود إلى عشريّة أو عشريّتين، بل تضرب في أعماق التاريخ وفي جذور المخيال.
صحيح أن أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 كانت بكلّ المقاييس صادمة للوعي الغربي عموماً ولوعي الأميركان على وجه الخصوص؛ وصحيح أيضاً أن تفجيرات مدريد (2004) وتفجيرات لندن (2005) كانت دامية مثخنة بالمآسي والجراح، مثلها في ذلك مثل التفجيرات التي هزّت باريس في ثمانينيات القرن الماضي. لكنّ كل هذه الأحداث، إضافة إلى حرب أفغانستان والعراق، لا تعني الشيء الكثير.
التاريخ المعاصر الذي تميّز بالصدام الحاد المباشر بين الإسلام والغرب نجح فقط في بلورة ما أسمته الكاتبة بـ "المعضلة الإسلامية"، ولكن الدماء التي سالت وما زالت تسيل بسبب هذه المعضلة وعلى جنباتها أدّت إلى حجب الرؤية لدى الفريقيْن وجعلت الغرب متردّداً في طرح السؤال الذي كان عليه أن يطرحه منذ عقود، سؤال: كيف وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟ ونتيجة تردّده في طرح السؤال، ظلّ الغرب عاجزاً عن صياغة الإجابة وعن تحديد نقطة الانطلاق الأسلم التي يجدر به اعتمادها من أجل كتابة تاريخ هذه العلاقة الدامية الملغزة، تاريخ علاقته بالإسلام.
وفي تجاوزٍ منها للإشكاليات التي تجعل كتابة مثل هذا التاريخ محفوفة بسوء الفهم المتبادل، تقترح آريانا مسلكاً جديداً غير مطروق، تنطلق فيه من مادة لم يسبق للباحثين اعتمادها، فتدرس كيفيّة تَمثّل الغربيّين للوحوش وموقفهم منها وصيغ تعاملهم معها، وتضع ذلك كلّه في سياق علاقة الغرب بالإسلام.
ولأنّ مثل هذا التمشّي جديد وغير مألوف، خصّصت الباحثة الفصل الأول من عملها لضبط المفاهيم الأساسيّة التي تعتمدها ولبيان المجال الذي تشتغل ضمنه. ومن أبرز ما نبّهت إليه أنّ كل الثقافات دون استثناء تبتدع وحوشها على شاكلة كائنات متخيّلة هجينة تجمع بين عناصر يتداخل فيها البشري بالحيواني، والواقعي بالغرائبي، والمعقول باللامعقول، كالشياطين والعمالقة وأكلة لحوم البشر ومصّاصي الدماء والأموات الأحياء والغول والعنقاء، وما إلى ذلك من المخلوقات الخفيّة التي حُمِّلَت عبر التاريخ هواجس الإنسان ومخاوفه. وبالرغم من أنّ هذه الكائنات هي من صنع الخيالات والاستيهامات، فقد أَسند إليها مبتدعوها قوى خارقة تتيح لها أن تُجاوز حدود العالم الخفي المستور الذي يفترض أن تعيش ضمنه، من أجل أن تنتهك الواقع العياني المنظور وتوقع الأذى بالبشر.
وتكمن الأهميّة الأنثروبولوجيّة للوحوش في أنّها تمثّل محدّداً من محدّدات الهويّة. فالبشر يعرّفون آدميّتهم ويتعرّفون عليها ويعيّنون ذواتهم الفرديّة وكينونتهم الجماعيّة وسلوكهم وعاداتهم وسائر أحوالهم بالتضاد مع ما يعتبرونه "وحشاً" من الضروري إقصاؤه لأنّه لا ينتمي إلى حقل الإنسانية وليس جديراً بأن يُعترف به كذلك.
لكنّ صورة الوحش لا تتشكّل في المخيال اعتماداً على أنساق ذات طابع منتظم، بل هي تتغذّى من شتاتها ذاته، ومن تشظّيها ومن قدرتها على التسرّب في تضاعيف سائر الخطابات بما في ذلك الخطابات العقلانيّة. ومن هذا المنطلق، وجدت الكاتبة نفسها إزاء مدوّنة مترامية الأطراف، تمتدّ زمانيّاً على ألف وثلاثمائة سنة؛ بدءاً بالقرون الوسطى انتهاء إلى القرن الحادي والعشرين مروراً بعصر الأنوار وبالعصر الذهبي للحركة الاستشراقية وبالحقبة الاستعمارية.
وعلى قدر امتداد الزمان وشموله لمختلف هذه المراحل والحقب، كانت الخطابات المعتمدة متنوّعة. فمن بين ما اعتمدته الباحثة مجموعات الصور الواردة في المخطوطات القديمة، واللوحات الزيتية التي أنجزها الفنانون التشكيليون، والأعمال الشعرية والروائية التي خلّفها الأدباء، والنصوص التي صاغها الصحافيون، وكُتب الرحلات التي خطّها زوّار الشرق، والتقارير الحكومية التي تداولها السفراء، والأشرطة السينمائيّة التي يُقبل عليها عشاق الفن السابع.
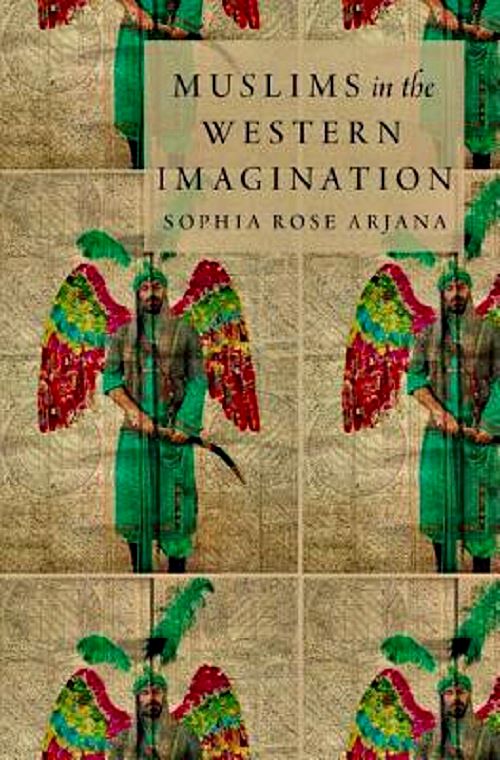 بمجال اشتغال على هذا القدر من الاتساع زمانا وعلى هذه الدرجة من التعدّد والتنوّع مادّة، يبدو جليّا أن صوفيا روز آريانا تسير على خطى إدوارد سعيد في كتابه الشهير عن "الاستشراق". ولكن ما يكسب عملها طابعه الفريد المخصوص وحدة "التيمة" أو الموضوع وتعيّن الهدف المتمثّل في تأمّل صور الوحوش كما رسمها المخيال الغربي في علاقته بالإسلام.
بمجال اشتغال على هذا القدر من الاتساع زمانا وعلى هذه الدرجة من التعدّد والتنوّع مادّة، يبدو جليّا أن صوفيا روز آريانا تسير على خطى إدوارد سعيد في كتابه الشهير عن "الاستشراق". ولكن ما يكسب عملها طابعه الفريد المخصوص وحدة "التيمة" أو الموضوع وتعيّن الهدف المتمثّل في تأمّل صور الوحوش كما رسمها المخيال الغربي في علاقته بالإسلام.
في مطلع القرون الوسطى، كان العالم -في وعي الأفراد والجماعات- ضيّقاً تماماً لا تكاد حدوده تتجاوز أطراف المدينة أو القرية. وكان كلّ ما يقع خارج هذه الحدود أو ما يأتي من ورائها مثيراً للمخاوف وباعثاً على الرفض. يكفي أن نرى على التخوم شخصاً يصفّف شعره بشكل مختلف عمّا ألفناه، أو يرتدي ملابس لا تدلّ على الهويّة الدينية المشتركة للجماعة، أو يغلب على وجهه الشحوب وعلى هيأته النحافة حتى نعتبره وحشاً فنرفضه وننزع عنه صفة الآدميّة.
وفي هذا السياق التاريخيّ، الذي تغلب عليه نوازع الانغلاق والريبة والتطيّر والشعوذة، اكتشف الغرب الإسلام وبنى عن أتباعه أساطير صوّرتهم في شكل وحوش ذوي قدرات جسمانية خارقة، وأعوان للشياطين لا تحكمهم إلاّ الشهوانية المفرطة التي تتعارض تماماً مع الطهرانيّة المسيحية. وقد وجدت هذه الأساطير الشفويّة طريقها إلى الكتابة، وجسّد الورّاقون بعض مشاهدها في مخطوطاتهم، وأضافوا إليها عناصر حيوانيّة ممزوجة بنوازع عنصرية ضد السود وضد اليهود حتى صار الوحش خليطاً مركّباً من هيئات شتى.
وقد مثّلت هذه الأفكار ذات الجذور القروسطية نواة صلبة تولّدت منها وعلى هامشها صورٌ لم تزدها إلا رسوخاً، رغم تغيّر السياقات التاريخيّة، وانقلاب موازين القوى في علاقة الشرق بالغرب، ورغم اختلاف المحامل الفنيّة والأدبيّة والفكريّة التي احتضنت الصورة وغذّت المخيال؛ لكأنّ قدرنا أن نظلّ دوماً حبيسي الإطار نفسه، وأن نبقى وحوشاً لكلّ الأزمنة.


