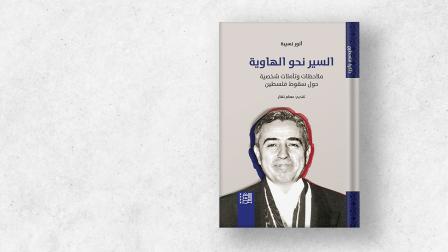لثنائية الدين والعلمانية حساسيتها في السياق العربي المعاصر. قد يكون هذا الأمر ذريعة لضرورة تفكيكها، غير أن عزمي بشارة وهو يتصدّى لذلك يتقصّى خبر هذه الثنائية فوق شعاب أوسع من التاريخ العربي.
إنه يفعل ذلك أينما التقى أو افترق المفهومان، ليمسح في إطار مشروعه هذا معظم تاريخ الأفكار، في تواصل لمشروع عام بتأسيس جاد للمفاهيم التي تخترق الحياة السياسية العربية بعد عمله "المجتمع المدني: دراسة نقدية" (2012).
في الجزء الأول من "الدين والعلمانية في سياق تاريخي" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، ينطلق المفكّر العربي من ملاحظة كون مسألة "الإسلام والديمقراطية" التي ينشغل بها العقل العربي تمثّل "إشكالية وهمية".
ويرى، في المقابل، أن ما يستحق البحث هو علاقة أنماط التديّن بالديمقراطية. التديّن، هنا، يفتح على كافة مفاهيم مشروع بشارة الضخم، فـ "الفرق بين أنماط التديّن في دول ومجتمعات معيّنة يتحدّد بنسبة كبيرة بأنماط العلمنة التي تعرّض لها المجتمع".
اشتغل المؤلف على تعريف وتحديد وتبيان فروقات وتمايزات عدد من المفاهيم المترابطة، يمكن أن نجملها في: الدّين، التديّن، الأخلاق، المقدّس، الأسطورة، السحر، العلم، الفلسفة، العلمنة، العلمانية.
تبدو لعبة التمايزات والتعريفات هذه ما يشبه جمبازاً عقلانياً دقيقاً وضرورياً قبل المرور لمعالجة الإشكاليات. فكأنها مجموعة محدودة من المتغيّرات الرياضية التي يحدّدها جيداً، ثم يبدأ في رسم العلاقات بينها وتفاعلاتها وصراعاتها في عالم الأفكار وفوق أرض التاريخ.
يشير بشارة إلى أن الدّين، كأحد أشكال التفاعل مع الطبيعة والجماعة، ينزع إلى المأسسة والتحوّل إلى عادات، وبالتالي يصبح أداة لإعادة إنتاج العقيدة والجماعة.
أما التديّن، على عكس النظرة السائدة، فتكمن أهميّته في العادي اليومي لا في الاستثنائي، إنه إمكانية تكرار التجربة الدينية عبر العبادات. بعباراته يقول "ليس التديّن التجربة الأولية للمقدّس بل هو أيضاً نفيها، ونفيها هذا هو الذي يصنع الدّين أي يُمأسسه باعتباره ظاهرة"، أي أن التديّن يصنع الدّين من جديد عبر التاريخ.
يلاحظ بشارة، عند هذه النقطة، أنه "لا دين بغير متديّنين". يقسّم الدّينُ ومؤسساته بعد ذلك كل شيء إلى مقدّس وغير مقدس، ومن ثم يُصاغ ويقوم بَشرٌ على تدبيره. في ختام هذا التطوّر، يصبح "الدّين ديناً في حدوده وإيديولوجيا خارجها".
 وهكذا لا يلبث أن يحصل انفصال بين جوهر الدّين (الإيمان) والتديّن، وقد يتطوّر الانفصال إلى درجة يصبح فيها المظهر هو جوهر الدّين، حسب رأيه. في لعبة التمايزات هذه، يلاحظ بشارة وهو يطرح مفهوم الأسطورة، أن العلم ينفي الأسطورة بينما العلمنة لا تنفيها بالضرورة، بل أنها قد تأتي بأساطير جديدة.
وهكذا لا يلبث أن يحصل انفصال بين جوهر الدّين (الإيمان) والتديّن، وقد يتطوّر الانفصال إلى درجة يصبح فيها المظهر هو جوهر الدّين، حسب رأيه. في لعبة التمايزات هذه، يلاحظ بشارة وهو يطرح مفهوم الأسطورة، أن العلم ينفي الأسطورة بينما العلمنة لا تنفيها بالضرورة، بل أنها قد تأتي بأساطير جديدة.
يشرح هذه الفكرة معتمداً على العلم الأقرب في بنيته إلى السرد والحكاية وفهم الظواهر وهو علم التاريخ، والذي كان الأكثر عرضة لزرع الأساطير عن وعي، بينما كانت الأساطير تعبيراً عمّا يكمن في اللاوعي الجماعي. يقول: "لقد وُلد علم التاريخ من الانفصال عن السردية الأسطورية للتاريخ، لكنه أنتج أساطير جديدة في إهاب الإستوغرافيا الحديثة، مثلما أنتجت العلمنة والقوميات والدولة أدياناً بديلة".
يكشف كل ذلك، "كم نحن مغروسون في الأسطورة، حتى حين ندّعي تفكيك الأساطير والانفصال عنها. إذ نَزعت الحداثة السحر عن العالم لكنها لم تنزعه من روح الإنسان"، كما يقول، خاصة وأنه حين يتطرّق إلى ثنائية العلم والسحر يشير إلى أن الثاني يشترك مع الأول في الغاية (من حيث هو تقنية للتأثير في العالم) ولهذا السبب بالذات يتناقض معه باعتبار تناقض المناهج.
السحر بهذا التناول علم زائف، وهو غير قابل للتعايش مع الدّين بينما يتعايش العلم مع الدّين. وإن التقاطعات والمفارقات بين الدّين والعلم والسحر تفضي إلى رسم أفضل لمفهوم العلمنة في التاريخ، على خلفية أن العلمنة قد وضعت في مبادئها نزع السحر من العالم، وهي من دون أن تقصد قد قامت أيضاً بتخليص الدين منه، فزاد تركيز المتديّنين على ما هو أساسي في الدّين، أي البعد الروحاني والإيماني والخلقي فيه.
بعد ذلك، ينتقل إلى مبحث آخر، هو ثنائية الدّين والأخلاق، بجدلية التحديد والتمايز نفسها، فيقول إن "الأخلاق والدّين تتقاطع في الأخلاق السائدة في المجتمع، وفي التمرّد عليها. وأن تحوّل الدّين إلى إيديولوجيا يحوّل الأخلاق إلى أداة ويبرّر ما هو غير أخلاقي باسم الدّين".
ومن الملاحظات الرشيقة في هذا الحديث، قوله "يبدو لأول وهلة التفكير بالأخلاق وبالدّين القائم بصفتهما أمرين منفصلين "أمراً جديداً". ولكنه "أمرٌ جديد" في كل عصر".
ببلوغ ثيمة "الأخلاق"، نقف مع المفكر العربي على عتبة ولوج عالم الفلاسفة، وقد انشغلوا طويلاً بالمسألة الأخلاقية. يتعرّض بشارة لأفكار كانط وهيغل وهوبس وماركس ودوركهايم وفرويد وبرغسون وآخرين، وهو ما يضعنا أيضاً عند مشارف مسار آخر هو التنوير بمختلف مستويات مفكريه من قضية الدّين، وعندها تبدأ عملية تأريخ الأفكار التي ستستمرّ بصفة أكثر توسّعاً في الجزء الثاني من الكتاب.
لعلّ بشارة يتابع هنا منهج دراسة الفروقات بين المواضيع والمفاهيم عند الفيلسوف سبينوزا، إذ يتبنّى بالخصوص مبدأه القائل بأن "كل تعريف نفي"، ومن هنا يقودنا أن ندرك أن كل تعريف للدّين هو تعريف علماني، أي يفترض مجالاً للدين ومجالاً خارجه، وهي فكرة تتطابق مع فكرة العلمنة الأولى بتحديد ممتلكات الكنيسة مقابل ممتلكات الدولة أو الرعية (أو العلمانيون في تعريف كنسي قديم، باعتبارهم ليسوا رجال دين).
يدرس بشارة مصطلحات العلمنة وتعريفاتها بما هي "سياقات اجتماعية وسياسية لخصخصة القرار الدّيني" أو بما هي "نموذج سوسيولوجي في فهم المراحل الحديثة وتفسيرها منذ وعي الدّين باعتباره ديناً"، أو بما هي "تطوّر تاريخي متعيّن منذ فجر الحداثة يتجلّى في انحسار الدّين من مجال فكري واجتماعي بعد آخر، وهي جزء من ظاهرة التخصّص وتوزيع العمل"، ليُبلور تعريفاً خاصّاً به بما هي "نتاج عملية تمايز اجتماعي بنيوي وتغيّر في أنماط الوعي كصيرورة تاريخية"، أو بمفردات طوّرها هذا الكتاب ذاته؛ كونها تواصلاً لعملية فصل متدرّجة للديني عن الدنيويّ وللمقدّس عن العادي، وطرد السحر من مجالات الحياة.
نبلغ هنا خاتمة الجزء الأول، والذي تظهر فيه فكرته الرئيسة، إذ أن واقع البشرية الحالي الذي أفضى إليه السياق التاريخي قد جعل أنه "ما عاد ممكناً في عصرنا بحث الدّين من دون الولوج إلى مفهوم العلمانية والعلمنة".
أكثر من ذلك يصل بشارة إلى "أن فهمنا للدين يتغيّر بحسب العلمنة". وإن امتلاك العلمانية لهذه القدرة على التأثير في فهمنا للدّين هو ما يتقصّاه في الجزء الثاني من العمل فوق مسارات التاريخ العيني للبشرية.