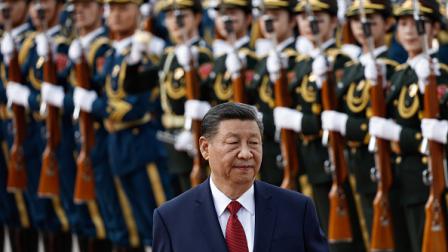أمام الجزائر الكثير لبناء المستقبل (بشير رمزي/الأناضول/Getty)
احتفلت الجزائر بالذكرى الـ52 لاستقلالها عن فرنسا، الذي تحقّق بعد ثماني سنوات من ثورة تحرير ضارية، دفع فيها الجزائريون ثمناً باهظاً: مليون ونصف المليون شهيد. لكن الجزائر ما تزال ترزح تحت نير عوامل سياسية - اجتماعية - اقتصادية متشابكة، تحرمها من إكمال المسيرة إلى المستقبل.
بدأ التخطيط للثورة في ديار الشمس في منطقة المدنية، بأعالي العاصمة الجزائرية، حين اجتمع 22 قائداً من قادة "العمل الوطني" في صيف العام 1954. هناك اتخذوا قراراً في إشعال الثورة وإطلاق العمل المسلح، في نوفمبر/تشرين الثاني 1954. في هذا الحي، بعد 52 عاماً، أشياء كثيرة لم تتغيّر، حياة السكان ما زالت قاسية، لغياب التحسّن على المساكن التي ورثتها منذ العام 1962، والتي كانت مخصصة أصلاً لإقامة جنود الاستعمار الفرنسي.
في هذا الحي كان جنود الاحتلال، يستعدون للقيام بحملات الدهم والاعتقال، ضد الناشطين والفدائيين وعناصر "جبهة التحرير الوطني"، وكانت الأحياء الشعبية كحي المدنية، معقلاً مهماً للثوار والفدائيين، تماماً كما كان حي القصبة العتيق.
ما زالت المباني في حي ديار الشمس، تحتفظ بذكرياتها من تلك الفترة الحرجة في تاريخ الجزائر. وما زال عدد قليل من السكان من كبار السن، في الحيّ، يتذكرون قصصاً مؤلمة عن الظلم والطغيان والحرمان، الذي كان يسيّج يوميات الجزائريين في تلك الحقبة الاستعمارية المظلمة، قبل أن تشرق شمس الحرية على ديار الشمس وكل ربوع الجزائر.
وبالرغم من مرور عقود على الحرية، غير أن الوضع لم يتغيّر، فقبل أسبوعين علّق سكان حي ديار الشمس، لافتات كبيرة، تطالب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بالوفاء بالتزاماته، في شأن ترحيلهم إلى مساكن لائقة. مع العلم أن الحيّ شهد انتفاضات عنيفة، أعنفها جرى في العام 2011، بين السكان وقوات الشرطة، بعد اعتصامهم للمطالبة بترحيلهم.
والملفت في هذا الصدد، أنه ليس سكان ديار الشمس وحدهم من يعانون من أزمة السكن، فأحياء الصفيح شاهدة على ذلك. هي التي نشأت في ضواحي العاصمة الجزائرية والمدن الكبرى، خصوصاً خلال المرحلة الدموية في التسعينات، وزادت من متاعب السلطات، التي عمدت في الفترة إلى ترحيل 25 ألف من سكان هذه الأحياء في العاصمة وحدها.
وبالرغم من وعود الحكومة وبوتفليقة، في ثلاث ولايات رئاسية، لمعالجة الأزمة، إلا أن ذلك لم يتحقق، والآلاف من العائلات ما زالت تقيم في ظروف لا تتطابق مع الوضع المالي والثراء الذي تتمتع به الجزائر، بفضل مداخيل النفط التي بلغت حالياً حوالى 200 مليار دولار أميركي.
بطالة وفساد
ليست أزمة السكن وحدها فقط ما ينغص حياة الجزائريين، فالبطالة، التي بلغت بحسب تقديرات غير رسمية 24 في المئة، في مجتمع يُشكّل الشباب نسبة 75 في المئة منه، تطرح مشكلة أخرى. ولا يبدو أن البرامج التي أطلقتها الحكومة لتشغيل الشباب، كبرنامج إنشاء المؤسسات المصغرة، والذي يتضمّن دعم الشباب بقروض دون فوائد من المصارف، لإنشاء مشاريع استثمارية مصغرة، ناجحاً.
كما أن الزيادات التي تقرّها الحكومة في الأجور، لم تتح للجزائريين العيش الكريم، إذ غالباً ما تُقابل بزيادات في أسعار السلع والمواد الغذائية، بسبب ضعف وتيرة الإنتاج المحلي، وتغلب الاستيراد على الإنتاج الداخلي، خصوصاً أن الجزائر تستورد ما قيمته 2 مليار دولار شهرياً من المواد الغذائية والأدوية.
وأوقع فخ الاستيراد الجزائر في قبضة الريع والمافيا المالية، التي باتت تتحكم في غذاء الجزائريين، وقضايا الفساد والتهرب الضريبي الكثيرة، وتسعى السلطات إلى محاربتها، بعدما حوّلت أربعة آلاف قضية إلى المحاكم. أتاح هذا الوضع بروز طبقة جديدة من الأثرياء الجدد، فيما تقلّص حجم الطبقة المتوسطة.
وتبقى أكثر الأزمات التي تعاني منها الجزائر، تلك المتعلقة بأزمة الشرعية السياسية المزمنة، منذ انقلاب الجيش على الحكومة المؤقتة في صيف 1962، بقيادة رئيس أركان الجيش، هواري بومدين، والذي دفع قسراً بأحمد بن بلة، إلى رئاسة الجمهورية، قبل أن ينقلب عليه في 19 يناير/كانون الثاني 1965.
وأفضى الانقلاب إلى استيلاد سلطة سياسية، عمدت إلى إبعاد كبار قادة ثورة التحرير والعمل الوطني التحرري عن السلطة، كمحمد بوضياف، كريم بلقاسم، محمد خيضر، حسين آيت أحمد، وأحمد محساس وغيرهم، وتفرّد الجيش بالحكم، بالرغم من الديكور الديموقراطي الذي حاولت السلطة عبره إضفاء الشرعية الشعبية على النظام القائم. غير أن كل شيء انتهى إلى انفجار داخلي وشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 1988، وشرّع الأبواب على مصراعيه نحو الديموقراطية.
تعثرت التجربة الديموقراطية تعثرت سريعاّ، بفعل بروز الاستقطاب الديني والمدني بين "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، التي حظر نشاطها في مارس/آذار 1992، والعلمانيين والسلطة. وانتهى بتدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي ودفع الرئيس، الشاذلي بن جديد، إلى الاستقالة، ليتولى الجيش السلطة، عبر مجلس رئاسي. وهو ما عمّق من أزمة الشرعية السياسية للنظام.
وتصرّ المعارضة على معالجة هذه الأزمة، وضرورة "إنشاء مجلس تأسيسي يعيد صياغة دستور توافقي"، وليس بالضرورة أن يكون الدستور عينه، الذي دعا إلى صياغته بوتفليقة، من خلال المشاورات السياسية التي تقوم بها الرئاسة منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي. قاطعت المعارضة، المشاورات، في انتظار ما ستنتهي إليه من أفق سياسي لتغيير الأوضاع، في بلد دفع ثمن الحرية غالياً، لكنه لم يحصل على الديموقراطية بعد.