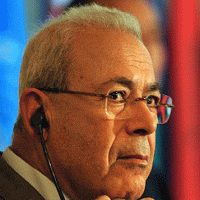11 نوفمبر 2024
لن تستطيع روسيا صنع السلام بعين واحدة
على الرغم من الإحباط العميق والشكوك التي بعثها إخفاق المبادرات العربية والدولية السابقة، بعث الاتفاق الأميركي الروسي الذي شهدته فيينا الشهر الماضي آمال السوريين المخيّبة منذ سنوات، بوضع حد قريب للقتل والدمار والخراب، يمهد الطريق لعودة المهجرين والمشرّدين واللاجئين، أو لقسم منهم، إلى ديارهم بأسرع وقت. ومما أحيا هذا الأمل مظهر التنسيق الكبير بين الروس والأميركيين، والوتيرة السريعة التي أخذتها الأمور، بدءاً بصدور القرار 2254 في مجلس الأمن، وانتهاءً بتحديد أجندة واضحة لتطبيقه والوصول، خلال 18 شهراً، إلى أول انتخابات ديمقراطية، بعد أكثر من نصف قرن من حكم الديكتاتورية ودولة الإرهاب.
لكن، قبل أيام فقط من بدء المفاوضات المعلن، يتساءل السوريون، في ما إذا كانت ستعقد فعلاً، وأن تكون، في حالة انعقادها، مفاوضات جدية أو مثمرة. وهذا هو السؤال الذي يطرحه على أنفسهم أيضاً السياسيون والمراقبون الذين أصبحوا يخشون أن لا يكون مصير هذه المبادرة أفضل من مصير سابقاتها، جامعة الدول العربية في أكتوبر/تشرين أول 2011 أو كوفي أنان في فبراير/ شباط 2012، أو مفاوضات جنيف الثانية بإشراف الأخضر الابراهيمي، والتي وصلت جميعها إلى طريق مسدود، اضطر فيه جميع المبعوثين الدوليين السابقين إلى الاعتراف بفشلهم وتقديم استقالاتهم.
ربما بدت المبادرة الجديدة المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 2254 أكثر حظاً في النجاح من سابقاتها لعدة أسباب. الأول، الإنهاك الذي أصاب الأطراف جميعاً. والثاني، تفاهم روسيا وأميركا لأول مرة على خريطة طريق للحل، وهما الدولتان الأكثر تأثيراً في مسارها. والثالث تراجع أمل الأطراف في تحقيق أهدافها، ونشوء حافز لديها للقبول بجزء منها، بدل المغامرة بإضاعتها جميعاً.
لكن، على الرغم من وجاهتها، لا تبدو هذه الأسباب متطابقة مع الواقع، أو كافية لتحقيق الحل المنشود، فالتفاهم الروسي الأميركي حقيقي، إلا أنه خاضع أيضاً لضغوط الحلفاء، واحتمال التردد والتبدل والمساومة. كما أن الإنهاك ليس عامّاً، فموسكو مستعدة للاستمرار في القتال، طالما استمرت طهران والأسد في تقديم الضحايا على الأرض. وجميع الأطراف تعتقد أنها في المرحلة الأخيرة، وعليها الصمود حتى لا تخسر رهاناتها. وقد أثبتت أحداث الشهرين الماضيين أن أطرافاً عديدة، سورية وإقليمية، ليست مستعدة للقبول بالتسوية المقترحة من الدولتين الكبريين، إذا لم تجد فيها ضماناً لحفظ مصالحها، وهي مستعدة لعرقلتها، وأن لديها وسائل كثيرة لذلك. كما أنه ليس من مصلحة الدول الكبرى نفسها أن تعقد صفقةً تفقد فيها تضامن حلفائها المحليين والإقليميين ودعمهم واستمرارهم في المراهنة عليها. وهنا تكمن، في نظري، نقاط الضعف والثغرات الرئيسية التي تحول دون تطور التوافق الروسي الأميركي إلى تسويةٍ تقنع الجميع بالجلوس على طاولة مفاوضات واحدة.
فحتى تضمن الولايات المتحدة تعاون موسكو التي أصبحت لديها اليد الطولى اليوم في سورية،
تنازلت لها عن الدور القيادي الذي كانت واشنطن تلعبه في حفظ التوازنات الإقليمية والإشراف على استمرار التفاهم والاستقرار، وهو ما نطلق عليه اسم الهيمنة. وهذا ما طمأن روسيا، وشجعها على لعب دور إيجابي في البحث عن حلٍّ، بعد أن كانت تستخدم نفوذها في إعاقة أي حل، بهدف إفشال الغرب وتحطيم صدقيته السياسية والاستراتيجية. وفي المقابل، حتى تضمن موسكو قبول طهران بالمشاركة في حل سياسي، بدل الرهان على القتال حتى آخر سوري، عملت المستحيل لاستبعاد مصير الأسد من أي مناقشات، وتعليق الحديث فيه. وبالتالي، تأمين حضوره في المرحلة الانتقالية التي سيحدد فيها مصير سورية ومستقبل نظام حكمها، بعد أن تحوّل إلى حصان رهان طهران الرئيسي، إن لم يكن الوحيد لخدمة مصالحها، والدفاع عن استثماراتها، وضمان عقودها واتفاقاتها المجحفة.
لكن روسيا نسيت، ومن ورائها الولايات المتحدة، أن تطمئن دول الخليج، وأولها المملكة العربية السعودية التي تقاتل في هذه الحرب دفاعاً عن أمنها القومي، ووجودها كدول، وليس فقط عن استقرار أنظمتها. والحال أسوأ بكثير بالنسبة لتركيا التي تعمل موسكو كل ما تستطيع من أجل إقصائها من الحل، وتهديد وحدتها واستقرارها بتشجيع قيام كيان كردي مستقل في شمال سورية، يتابع منه حزب العمال الكردستاني التركي حربه المعلنة على الحكومة التركية. بل إن موسكو، بدل أن تطمئن أنقرة، تشن حرباً حقيقية، عسكرية وإعلامية، من أجل طردها من سورية، وتأجيج النزاعات القومية فيها.
والأمر أخطر من ذلك بالنسبة للأغلبية الساحقة من السوريين الذين لا يبدو أن موسكو مهتمة بطمأنتهم، وتشجيعهم على الدخول في المفاوضات. وربما تريد، بالفعل، إثارة شكوكهم بشكل متعمد، لتبرير استمرارها في الحرب ضدهم.
لا شك في أن التطورات التي شهدتها الحرب، في السنوات الخمس الأخيرة، قد همشت السوريين، وأضعفت دورهم في تقرير مصير بلدهم، سواء أكانوا من الحكم أو المعارضة. وهذا ما أمدّ بأجل الحرب، وحولها إلى حرب تدمير وقتل، من دون ضوابط ولا حدود، في سياق بحث الدول والقوى الأجنبية عن مصالحها، وربح رهاناتها، بصرف النظر عن مصير السوريين ومصير بلادهم. لكن، إذا كان من الممكن الاستمرار في الحرب، مع تهميش السوريين، وجعل مسألة تغيير نظام حكمهم ثانوية، بالمقارنة مع الرهانات الإقليمية والدولية، فإن التوصل إلى سلام لن يكون ممكناً من دون استعادة السوريين دورهم، بل من دون أن تنقلب الآية، ليكون ضمان حقوق السوريين، والرد على تطلعاتهم، بعد خمس سنوات من الحرب الدامية، هدفاً رئيسياً للمفاوضات، وأن يكون من الواضح أنها تسير في هذا الاتجاه.
ما يعيق تقدم المفاوضات الراهنة، وربما يقضي على أي أمل لها بالانطلاق، هو أن رعاتها الأميركيين، ووكلاءهم الجدد من الروس، لاعتقادهم أن السوريين خرجوا من "اللعبة"، وصاروا طرفاً ثانوياً، لم يلحظوا تسوية سوى على أساس تقاسم المصالح الإقليمية. وفي هذا التقاسم، لم تلحظ موسكو أيضاً إلا مصالح حليفتها الإيرانية.
تستمر موسكو في قصف مواقع الثوار السوريين، وترفض تمثيلهم في أي وفد تفاوضي للمعارضة، وتفرض على المعارضة القبول بحلفاء النظام داخل صفوف وفد مفاوضاتها، وتغض الطرف عن سياسات القتل المنظم والتجويع والحصار، وتشارك فيها، ولا تكف عن التأكيد على أن التسوية ينبغي أن تأخذ بالاعتبار ميزان القوى العسكري على الأرض، في وقتٍ تعلن فيه عن رغبتها في استعادة جميع المناطق التي يسيطر عليها الثوار لصالح النظام، وتعد لشن معركة احتلال حلب وريفها، وإغلاق الحدود التركية السورية.
بدل تطمين المعارضة، وكسب ثقتها، تعلن موسكو، منذ بداية المفاوضات، انحيازها، وتطلب من المعارضة المسلحة والسياسية أن تطلق رصاصة الرحمة بيدها على نفسها. فهي لا تكف عن تأكيد هدفها المعلن في سحب البساط من تحتهم، وإخضاعهم من جديد لسلطة نظامٍ لم يكفّ، منذ خمس سنوات متواصلة، عن ملاحقتهم وقتلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بل إن موسكو لا تخفي هي نفسها، بموازاة دعوتها إلى الحل السياسي والمفاوضات، إرادتها في متابعة الحسم العسكري، وتهديدها لهم في الميدان العسكري، وفي الميدان السياسي أيضاً.
لا أحد يشك في أن روسيا قادرة على شن الحرب، والاستمرار فيها، وربما تحقيق بعض المكاسب على الأرض، لكنها لن تستطيع أن تكسب صدقيتها وسيط سلام، ما لم تكسب ثقة السوريين الذين ضحوا بكل ما لديهم، ليتخلصوا من حكم الأسد ونظامه الدموي. ولن تكسب ثقتهم، إذا استمرت في التمييز بينهم، وفرض الاستسلام على الأغلبية الثائرة منهم، وإجبارهم على الإذعان للقوة العسكرية الغاشمة والحصار وتنظيم الاغتيالات الفردية والجماعية بحقهم وقادتهم. حتى تنجح موسكو في ربح رهانها في الشرق الأوسط بوصفها قوة أمن واستقرار، كما تزعم، عليها أن تبرهن أنها قادرة على صنع السلام. ولا سلام من دون تسوية متوازنة، تضمن حقوق الجميع، وتطمئنهم وتنال ثقتهم، في سورية كما هو الحال في أي مكان آخر. والحال أن موسكو لا تزال تنظر، أو لا تريد أن تنظر، إلى السوريين إلا بعين واحدة، ولا ترى منهم سوى حلفائها ومحظييها.
لكن، قبل أيام فقط من بدء المفاوضات المعلن، يتساءل السوريون، في ما إذا كانت ستعقد فعلاً، وأن تكون، في حالة انعقادها، مفاوضات جدية أو مثمرة. وهذا هو السؤال الذي يطرحه على أنفسهم أيضاً السياسيون والمراقبون الذين أصبحوا يخشون أن لا يكون مصير هذه المبادرة أفضل من مصير سابقاتها، جامعة الدول العربية في أكتوبر/تشرين أول 2011 أو كوفي أنان في فبراير/ شباط 2012، أو مفاوضات جنيف الثانية بإشراف الأخضر الابراهيمي، والتي وصلت جميعها إلى طريق مسدود، اضطر فيه جميع المبعوثين الدوليين السابقين إلى الاعتراف بفشلهم وتقديم استقالاتهم.
ربما بدت المبادرة الجديدة المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 2254 أكثر حظاً في النجاح من سابقاتها لعدة أسباب. الأول، الإنهاك الذي أصاب الأطراف جميعاً. والثاني، تفاهم روسيا وأميركا لأول مرة على خريطة طريق للحل، وهما الدولتان الأكثر تأثيراً في مسارها. والثالث تراجع أمل الأطراف في تحقيق أهدافها، ونشوء حافز لديها للقبول بجزء منها، بدل المغامرة بإضاعتها جميعاً.
لكن، على الرغم من وجاهتها، لا تبدو هذه الأسباب متطابقة مع الواقع، أو كافية لتحقيق الحل المنشود، فالتفاهم الروسي الأميركي حقيقي، إلا أنه خاضع أيضاً لضغوط الحلفاء، واحتمال التردد والتبدل والمساومة. كما أن الإنهاك ليس عامّاً، فموسكو مستعدة للاستمرار في القتال، طالما استمرت طهران والأسد في تقديم الضحايا على الأرض. وجميع الأطراف تعتقد أنها في المرحلة الأخيرة، وعليها الصمود حتى لا تخسر رهاناتها. وقد أثبتت أحداث الشهرين الماضيين أن أطرافاً عديدة، سورية وإقليمية، ليست مستعدة للقبول بالتسوية المقترحة من الدولتين الكبريين، إذا لم تجد فيها ضماناً لحفظ مصالحها، وهي مستعدة لعرقلتها، وأن لديها وسائل كثيرة لذلك. كما أنه ليس من مصلحة الدول الكبرى نفسها أن تعقد صفقةً تفقد فيها تضامن حلفائها المحليين والإقليميين ودعمهم واستمرارهم في المراهنة عليها. وهنا تكمن، في نظري، نقاط الضعف والثغرات الرئيسية التي تحول دون تطور التوافق الروسي الأميركي إلى تسويةٍ تقنع الجميع بالجلوس على طاولة مفاوضات واحدة.
فحتى تضمن الولايات المتحدة تعاون موسكو التي أصبحت لديها اليد الطولى اليوم في سورية،
لكن روسيا نسيت، ومن ورائها الولايات المتحدة، أن تطمئن دول الخليج، وأولها المملكة العربية السعودية التي تقاتل في هذه الحرب دفاعاً عن أمنها القومي، ووجودها كدول، وليس فقط عن استقرار أنظمتها. والحال أسوأ بكثير بالنسبة لتركيا التي تعمل موسكو كل ما تستطيع من أجل إقصائها من الحل، وتهديد وحدتها واستقرارها بتشجيع قيام كيان كردي مستقل في شمال سورية، يتابع منه حزب العمال الكردستاني التركي حربه المعلنة على الحكومة التركية. بل إن موسكو، بدل أن تطمئن أنقرة، تشن حرباً حقيقية، عسكرية وإعلامية، من أجل طردها من سورية، وتأجيج النزاعات القومية فيها.
والأمر أخطر من ذلك بالنسبة للأغلبية الساحقة من السوريين الذين لا يبدو أن موسكو مهتمة بطمأنتهم، وتشجيعهم على الدخول في المفاوضات. وربما تريد، بالفعل، إثارة شكوكهم بشكل متعمد، لتبرير استمرارها في الحرب ضدهم.
لا شك في أن التطورات التي شهدتها الحرب، في السنوات الخمس الأخيرة، قد همشت السوريين، وأضعفت دورهم في تقرير مصير بلدهم، سواء أكانوا من الحكم أو المعارضة. وهذا ما أمدّ بأجل الحرب، وحولها إلى حرب تدمير وقتل، من دون ضوابط ولا حدود، في سياق بحث الدول والقوى الأجنبية عن مصالحها، وربح رهاناتها، بصرف النظر عن مصير السوريين ومصير بلادهم. لكن، إذا كان من الممكن الاستمرار في الحرب، مع تهميش السوريين، وجعل مسألة تغيير نظام حكمهم ثانوية، بالمقارنة مع الرهانات الإقليمية والدولية، فإن التوصل إلى سلام لن يكون ممكناً من دون استعادة السوريين دورهم، بل من دون أن تنقلب الآية، ليكون ضمان حقوق السوريين، والرد على تطلعاتهم، بعد خمس سنوات من الحرب الدامية، هدفاً رئيسياً للمفاوضات، وأن يكون من الواضح أنها تسير في هذا الاتجاه.
ما يعيق تقدم المفاوضات الراهنة، وربما يقضي على أي أمل لها بالانطلاق، هو أن رعاتها الأميركيين، ووكلاءهم الجدد من الروس، لاعتقادهم أن السوريين خرجوا من "اللعبة"، وصاروا طرفاً ثانوياً، لم يلحظوا تسوية سوى على أساس تقاسم المصالح الإقليمية. وفي هذا التقاسم، لم تلحظ موسكو أيضاً إلا مصالح حليفتها الإيرانية.
تستمر موسكو في قصف مواقع الثوار السوريين، وترفض تمثيلهم في أي وفد تفاوضي للمعارضة، وتفرض على المعارضة القبول بحلفاء النظام داخل صفوف وفد مفاوضاتها، وتغض الطرف عن سياسات القتل المنظم والتجويع والحصار، وتشارك فيها، ولا تكف عن التأكيد على أن التسوية ينبغي أن تأخذ بالاعتبار ميزان القوى العسكري على الأرض، في وقتٍ تعلن فيه عن رغبتها في استعادة جميع المناطق التي يسيطر عليها الثوار لصالح النظام، وتعد لشن معركة احتلال حلب وريفها، وإغلاق الحدود التركية السورية.
بدل تطمين المعارضة، وكسب ثقتها، تعلن موسكو، منذ بداية المفاوضات، انحيازها، وتطلب من المعارضة المسلحة والسياسية أن تطلق رصاصة الرحمة بيدها على نفسها. فهي لا تكف عن تأكيد هدفها المعلن في سحب البساط من تحتهم، وإخضاعهم من جديد لسلطة نظامٍ لم يكفّ، منذ خمس سنوات متواصلة، عن ملاحقتهم وقتلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بل إن موسكو لا تخفي هي نفسها، بموازاة دعوتها إلى الحل السياسي والمفاوضات، إرادتها في متابعة الحسم العسكري، وتهديدها لهم في الميدان العسكري، وفي الميدان السياسي أيضاً.
لا أحد يشك في أن روسيا قادرة على شن الحرب، والاستمرار فيها، وربما تحقيق بعض المكاسب على الأرض، لكنها لن تستطيع أن تكسب صدقيتها وسيط سلام، ما لم تكسب ثقة السوريين الذين ضحوا بكل ما لديهم، ليتخلصوا من حكم الأسد ونظامه الدموي. ولن تكسب ثقتهم، إذا استمرت في التمييز بينهم، وفرض الاستسلام على الأغلبية الثائرة منهم، وإجبارهم على الإذعان للقوة العسكرية الغاشمة والحصار وتنظيم الاغتيالات الفردية والجماعية بحقهم وقادتهم. حتى تنجح موسكو في ربح رهانها في الشرق الأوسط بوصفها قوة أمن واستقرار، كما تزعم، عليها أن تبرهن أنها قادرة على صنع السلام. ولا سلام من دون تسوية متوازنة، تضمن حقوق الجميع، وتطمئنهم وتنال ثقتهم، في سورية كما هو الحال في أي مكان آخر. والحال أن موسكو لا تزال تنظر، أو لا تريد أن تنظر، إلى السوريين إلا بعين واحدة، ولا ترى منهم سوى حلفائها ومحظييها.