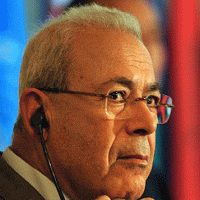17 أكتوبر 2024
لئلا تكون الحرب على الإرهاب مناسبة لتعميمه
على الرغم من الصدى الكبير الذي لاقته، لم تثر استراتيجية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التي أعلن عنها في خطابه، (الخميس 11 /9) لوقف تدهور الوضع في الشرق الأوسط المتفجر، حماساً كثيراً، حتى لا أقول التفاؤل، على الأقل في المرحلة الراهنة التي لم تتبلور فيها بعد خطة عمل التحالف الدولي، ومستوى أدائه. لكن، ترى جميع الأطراف المعنية بالأمر أن علينا أن نبني على ما حصل، حتى لو لم يكن على حجم التهديدات والمخاطر التي تواجه شعوب المنطقة، لأنه أفضل من لا شيء، وأقرب إلى المنطق من سياسة النأي بالنفس التي مارستها الولايات المتحدة، وجرّت معها العالم، منذ نحو أربع سنوات. ولأن لهذا الإعلان، رغماً عن ضعفه وتردده، بعض الإيجابيات، في مقدمها، تأكيد مسؤولية نظام الأسد عن إطلاق الإرهاب، بسبب سياسته الوحشية تجاه السوريين، ورفض أي تنسيق معه على الأرض، واعتباره جزءاً من المشكلة، لا جزءاً من الحل، وهو، بالتالي، خارج التحالف، ما يعني نهاية دوره السياسي.
ومن هذه الإيجابيات، أيضاً، الإعلان عن عدم التعاون مع إيران التي كانت، ولا تزال، الراعية الأكبر لميليشيات مذهبية متطرفة، وهي التي فتحت الباب أمام تعميم الإرهاب والقتل، من حزب الله إلى عصائب أهل الحق وأبو الفضل العباس والحوثيين، وغيرهم من الميليشيات التي زعزعت استقرار منطقة بكاملها.
ومن هذه الإيجابيات، أيضاً، التمسك بدعم المعارضة السورية، حتى لو جاء ذلك تحت مسمى المعارضة المعتدلة الذي يحتاج إلى تفكير وتدقيق كثيريْن. لكن، المثير للقلق أكثر في كل هذه العملية، والاستراتيجية التي يعدنا بها الرئيس الأميركي، هو أولاً اختصار التحالف مشكلة المنطقة بتحدي الإرهاب. وثانياً اختصار الإرهاب بتنظيم داعش، وثالثاً اقتصار الحرب ضد الإرهاب على الأعمال العسكرية، بصرف النظر عن القوى التي ستقوم بها، وتوزيع المهمات المختلفة في الجو وعلى الأرض. ما يعني أن باراك أوباما اختار أن يقصر تدخل الولايات المتحدة على الحد الأدنى، وبوسائل محدودة، تهدف إلى إضعاف قوة داعش، والحد من مخاطر توسعها، من دون معالجة الأوضاع السياسية والاستراتيجية للمنطقة، والتي قادت إلى تعميم الإرهاب ودخول داعش. في هذه الحالة، يُخشى أن تكون النتائج، أيضاً، محدودة، وربما سلبية، تكرر ما حصل في أفغانستان، والتي لم تقض على الإرهاب، وإنما حدّت من انتشاره، من دون أن تنجح في إعادة بناء الدولة التي كانت ضحية الإرهاب وسياسة مكافحته في الوقت نفسه.
مثل هذه الاستراتيجية ستكون كارثة إضافية في منطقةٍ، لم تعد تحتمل مزيداً من الكوارث. وقد تتحمل سورية العبء الأكبر فيها، فوق ما تعانيه من الإرهاب الأسدي والإيراني واللبناني. وهذا ما يظهر من الخطة الأميركية التي تركز، بوضوح، على تأمين استقرار العراق ودعم حكومة حيدر العبادي، وحماية آبار النفط والمنطقة الكردية، وذلك كله مصالح أميركية واضحة، كما أنها تأتي متأخرة بمرحلة كاملة، ذلك أن ما نواجهه، اليوم، في المنطقة لم يعد مشكلة الإرهاب الذي لعبت به الدبلوماسية الدولية، منذ أكثر من عقدين، فحسب، وإنما الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وليست داعش التنظيم الوحيد المنخرط فيها، وليست هي التي أطلقتها، بمقدار ما كانت المستفيدة الرئيسية من الفراغ والدمار النفسي والسياسي والفكري والمادي الذي تتسبب به في منطقةٍ، تكاد تغطي المشرق العربي بأكمله.
من دون توسيع رؤية مكافحة الإرهاب، لتشمل الأبعاد السياسية والاستراتيجية، وتفتح الباب واسعاً، بالتالي، أمام مراجعة شاملة من جميع الأطراف لسياساتها التي قادت إلى الكارثة: الولايات المتحدة والقوى الغربية التي تلاعبت بالمنطقة، حتى فجّرت كل توازناتها، والنظم العربية التي لا تزال تقاوم أي محاولة لتوسيع هامش الحريات والحقوق الأساسية، وتتمسك بأشكال الحكم الإقطاعية البالية، والمعارضات العربية، والسورية منها خصوصاً، التي لم تنجح في تجاوز خلافاتها وحساسياتها الشخصية، ولم ترتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية، يخشى أن تفضي، بشكل مقصود أو غير مقصود، إلى دفع السوريين من مختلف التيارات إلى مزيد من الاقتتال في ما بينهم، خصوصاً مع استقطاب داعش شباباً عديدين وكتائب عدة تركتها السياسات الدولية على قارعة الطريق، من دون موارد ولا خيار سوى الموت على يد داعش والنظام، أو الانضمام إلى أحدهما، ومع غياب أي قيادة سياسية سورية معارضة قادرة على أن تفرض نفسها، وتدافع عن المصالح الوطنية السورية. وبالتأكيد، ستكون الحرب ضد الإرهاب أكثر إيلاماً وإيذاءً من الإرهاب، ومناسبة لتوسيع نطاقه، وتعميق الانقسام والتمزق في صفوف الشعب السوري، إذا كان الهدف منها تحويل الكتائب السورية المقاتلة إلى صحوات جديدة، وتفجير مزيد من الألغام في قلب المجتمع السوري، بدل العمل على إخراج البلاد من أتون الحرب المشتعلة منذ سنوات.
والنتيجة أنه لن يكون للحرب ضد الإرهاب في الشرق الأوسط أي أمل في النجاح، ما لم يرافقها العمل مع السوريين والدول الإقليمية على إنهاء الحرب السورية التي أصبحت المنتج الأول للتطرف، والجاذب الأول لقوى التشدد والإرهاب.
ومن هذه الإيجابيات، أيضاً، الإعلان عن عدم التعاون مع إيران التي كانت، ولا تزال، الراعية الأكبر لميليشيات مذهبية متطرفة، وهي التي فتحت الباب أمام تعميم الإرهاب والقتل، من حزب الله إلى عصائب أهل الحق وأبو الفضل العباس والحوثيين، وغيرهم من الميليشيات التي زعزعت استقرار منطقة بكاملها.
ومن هذه الإيجابيات، أيضاً، التمسك بدعم المعارضة السورية، حتى لو جاء ذلك تحت مسمى المعارضة المعتدلة الذي يحتاج إلى تفكير وتدقيق كثيريْن. لكن، المثير للقلق أكثر في كل هذه العملية، والاستراتيجية التي يعدنا بها الرئيس الأميركي، هو أولاً اختصار التحالف مشكلة المنطقة بتحدي الإرهاب. وثانياً اختصار الإرهاب بتنظيم داعش، وثالثاً اقتصار الحرب ضد الإرهاب على الأعمال العسكرية، بصرف النظر عن القوى التي ستقوم بها، وتوزيع المهمات المختلفة في الجو وعلى الأرض. ما يعني أن باراك أوباما اختار أن يقصر تدخل الولايات المتحدة على الحد الأدنى، وبوسائل محدودة، تهدف إلى إضعاف قوة داعش، والحد من مخاطر توسعها، من دون معالجة الأوضاع السياسية والاستراتيجية للمنطقة، والتي قادت إلى تعميم الإرهاب ودخول داعش. في هذه الحالة، يُخشى أن تكون النتائج، أيضاً، محدودة، وربما سلبية، تكرر ما حصل في أفغانستان، والتي لم تقض على الإرهاب، وإنما حدّت من انتشاره، من دون أن تنجح في إعادة بناء الدولة التي كانت ضحية الإرهاب وسياسة مكافحته في الوقت نفسه.
مثل هذه الاستراتيجية ستكون كارثة إضافية في منطقةٍ، لم تعد تحتمل مزيداً من الكوارث. وقد تتحمل سورية العبء الأكبر فيها، فوق ما تعانيه من الإرهاب الأسدي والإيراني واللبناني. وهذا ما يظهر من الخطة الأميركية التي تركز، بوضوح، على تأمين استقرار العراق ودعم حكومة حيدر العبادي، وحماية آبار النفط والمنطقة الكردية، وذلك كله مصالح أميركية واضحة، كما أنها تأتي متأخرة بمرحلة كاملة، ذلك أن ما نواجهه، اليوم، في المنطقة لم يعد مشكلة الإرهاب الذي لعبت به الدبلوماسية الدولية، منذ أكثر من عقدين، فحسب، وإنما الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وليست داعش التنظيم الوحيد المنخرط فيها، وليست هي التي أطلقتها، بمقدار ما كانت المستفيدة الرئيسية من الفراغ والدمار النفسي والسياسي والفكري والمادي الذي تتسبب به في منطقةٍ، تكاد تغطي المشرق العربي بأكمله.
من دون توسيع رؤية مكافحة الإرهاب، لتشمل الأبعاد السياسية والاستراتيجية، وتفتح الباب واسعاً، بالتالي، أمام مراجعة شاملة من جميع الأطراف لسياساتها التي قادت إلى الكارثة: الولايات المتحدة والقوى الغربية التي تلاعبت بالمنطقة، حتى فجّرت كل توازناتها، والنظم العربية التي لا تزال تقاوم أي محاولة لتوسيع هامش الحريات والحقوق الأساسية، وتتمسك بأشكال الحكم الإقطاعية البالية، والمعارضات العربية، والسورية منها خصوصاً، التي لم تنجح في تجاوز خلافاتها وحساسياتها الشخصية، ولم ترتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية، يخشى أن تفضي، بشكل مقصود أو غير مقصود، إلى دفع السوريين من مختلف التيارات إلى مزيد من الاقتتال في ما بينهم، خصوصاً مع استقطاب داعش شباباً عديدين وكتائب عدة تركتها السياسات الدولية على قارعة الطريق، من دون موارد ولا خيار سوى الموت على يد داعش والنظام، أو الانضمام إلى أحدهما، ومع غياب أي قيادة سياسية سورية معارضة قادرة على أن تفرض نفسها، وتدافع عن المصالح الوطنية السورية. وبالتأكيد، ستكون الحرب ضد الإرهاب أكثر إيلاماً وإيذاءً من الإرهاب، ومناسبة لتوسيع نطاقه، وتعميق الانقسام والتمزق في صفوف الشعب السوري، إذا كان الهدف منها تحويل الكتائب السورية المقاتلة إلى صحوات جديدة، وتفجير مزيد من الألغام في قلب المجتمع السوري، بدل العمل على إخراج البلاد من أتون الحرب المشتعلة منذ سنوات.
والنتيجة أنه لن يكون للحرب ضد الإرهاب في الشرق الأوسط أي أمل في النجاح، ما لم يرافقها العمل مع السوريين والدول الإقليمية على إنهاء الحرب السورية التي أصبحت المنتج الأول للتطرف، والجاذب الأول لقوى التشدد والإرهاب.