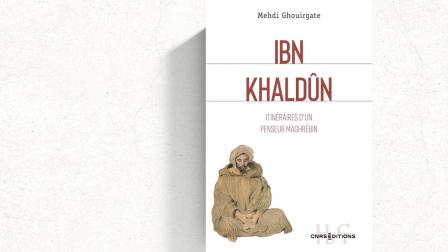حلّت مؤخراً الذكرى العاشِرة لوفاة الفيلسوف الفرنسي ذي الأصل الجزائري جاك دريدا (1930- 2004)، ولعلّ الفيلم الذي أنجزه كاتب سيرته بونوا بيترز (دريدا؛ سيرة 2010/ منشورات فلاماريون) المختصّ بكتابة السلاسل المصوّرة، مع مخرجة الأفلام الوثائقية فيرجيني لينهارت: "جاك دريدا؛ شجاعة الفكر" يتفرّد في مقاربته، إذ يلقي الضوء على تقاطع حياة دريدا الشخصيّة غير المعروفة مع حياته الفكريّة. وكانت صداقةٌ من نوع خاصّ قد جمعت بين دريدا وبونوا منذ كان هذا الأخير طالباً في قسم الفلسفة في الـ Ecole Normal Superieure. الأمر الذي أتاح له الاقتراب أكثر من حياة الفيلسوف، والاطلاع على أرشيفه، فكوّن وجهة نظره الخاصّة التي ترى أن فكر دريدا لم يُولد من مكان لا على التعيين، بل من حقلٍ فكري متنوّع، فيه مؤثّرات ونزاعات وشخصيّات مؤثّرة. فالفكرة الرئيسة للفيلم تدور حول المقابلة ما بين الحياة الشخصية لدريدا وفكره، على نحوٍ تبدو فيه المصادفات التي حكمت حياته مؤثّرة بشكلٍ عميق في طريقة تفكيره. إذ تبدو حادثة طرده من المدرسة وهو في الثانية عشرة، نتيجة تطبيق قوانين حكومة فيشي المناهضة للساميّة، حدثًا مفصليًا، حيث قال له ناظر المدرسة: "عد إلى المنزل، وسيشرح لك أهلك السبب". يقول دريدا :"لم أفهم شيئًا". وتضيف شهادة رفيق طفولته جان طواسون، صدقيّة أخرى على أثر هذه المصادفة في تكوين دريدا وعلاقته بالهويّة، التي لا يظنّها إلا هويّة لغوية: "أنا يهودي فرنسي جزائري تمّ بتره عن كلّ ما له علاقة باللغتين العربية والعبرية، ولا يتكلّم إلا اللغة الفرنسية التي تبهره".
كان انقطاعه عن وطنه الأمّ الجزائر، ورحيله بحراً صوب فرنسا من أجل الدراسة، بمثابةِ بترٍ آخر. فهذا المسار الذي يبدو "طبيعيًا" للكثير من الجزائريين، ظهرت آثاره لاحقًا، فشكّل جرحاً شخصيّاً لدريدا إلى آخر أيام حياته وفق ما تقول زوجته مارغريت، ولعلّه كان وراء ابتكاره لمفهوم "الحنينيّة"، وربما أيضًا وراء شغفه بـ "الضيافة" الذي كرّس له أوّلا مقالًا في مجلة "Communication"، قبل أن يُعاد نشره مع مقالٍ ثانٍ ضمن حوار غير مباشر مع الفيلسوفة الفرنسيّة والمحللة النفسيّة آن ديفور مانتيل، وصدر ضمن كتاب "De l’hospitalite"( ت. منذر عيّاشي، المركز القومي للترجمة).
في باريس لم ينجح دريدا في البداية في امتحان الدخول إلى Ecole Normal Superieure، لكنه نجح في إقامة صداقة مع أستاذه آنذاك لويس ألتوسير، ويبدو أن الفارق الضئيل في العمر بينهما أدّى دوراً في ذلك، فألتوسير وجد دريدا أكثر طلّابه إثارةً للاهتمام، ولم يكفّ عن تشجيعه ليصير أستاذاً مثله، من خلال التقدّم إلى مسابقة الأستذة، رغم هلع دريدا المزمن من الامتحانات، يقول معلّقًا على الأمر: "أنا أتّهم نظام الامتحانات هذا، هو بمثابة تهديد بالمقصلة. كانت سنوات جهنميّة بالنسبة لي". وفي الفيلم صورة لرسالة من ألتوسير إلى دريدا، يوجّهه فيها: "علينا أن ننظر معًا في هذه الوظيفة: لا أشكّ في قدراتك الاستثنائية، لكن عليك أن تجري تغييرًا جذريًا في ما يخصّ العرض والتعبير".
بيد أن بلوغ دريدا عامه الثاني والثلاثين كان حاسمًا في مسيرته؛ " استمرّت مراهقتي حتّى بلوغي الثانية والثلاثين"، ففي عام 1962، نشر كتابه الأوّل: "مقدّمة لأصل الهندسة الفراغية"، وغيّر اسمه من جاكي إلى جاك. ولاقى كتابه منذ صدوره استحسانًا في الأوساط الأدبيّة والفلسفيّة الفرنسيّة، يشهد عليها الكاتب الفرنسي فيليب سولرز الذي كان رئيس تحرير الدوريّة الطليعيّة، Tel Quel، فدعاه إلى التعاون معه، فكتب مقالًا عن أنطونان آرتو.
علاقة دريدا بالصورة كانت بدورها ذات أهميّة حاسمة، فمن الرفض المطلق والسخرية من صور الكتّاب على أغلفة كتبهم، إلى تلك اللحظة التي اقتنصته فيها الكاميرا عائداً من براغ بعد سجن لثلاثة أيام واتهام بتهريب المخدرات، عقابًا على إلقائه محاضرات سرًّا. ستشكّل هذه اللحظة منعطفًا في حياته، فيقبل بعدها التصوير بإسراف، خاصّة بعد الشهرة الفائقة لـ "التفكيكية" خصوصاً في أميركا. ففي مؤتمر في بالتيمور كان دريدا جنباً إلى جنب مع رولان بارت وجاك لاكان وجيل دولوز وميشيل فوكو، أي أن البنيوية الفرنسيّة كانت كلّها حاضرة، ودشّن هذا المؤتمر دخول "النظرية الفرنسية" إلى المنهاج الأميركي. وهناك التقى دريدا بالأستاذ الجامعي في جامعة يال، والناقد بول دو مان الذي عمل على بثّ أفكار دريدا وكتاباته في صلب الأكاديميا الأميركية. وهذه الصداقة التي جمعت بين الرجلين تشكّل أيضًا جرحًا مُحرجًا لدريدا، فقد تمّ اتهام دو مان بالتعاون مع النازية خلال الحرب العالميّة الثانية بالاستناد إلى مجموعة مقالات كتبها في تلك الفترة، وكان أشهرها مقال بعنوان :"اليهود في الأدب المعاصر". وأرجع بعض الكتّاب سبب الهجوم على دو مان إلى تبنيّه لمفهوم "التفكيكية"، ودافع دريدا عنه في مقال نشر في دورية أميركية.
يركّز الفيلم على صورة دريدا نجمًا في أميركا، يتحلّق حوله المعجبون، ويكون حاضرًا في السلاسل المصورة، فضلًا عن استلهام المخرج الشهير وودي آلن لـ "التفكيكيّة" في عنوان أحد أفلامه "تفكيك هاري". بيد أن الاحتفاء الأميركي بدريدا، قابله نوع من التحفظ والبرود تجاه الفيلسوف من قبل الأكاديميّة الفرنسية الصارمة، التي لم تتقبّل بسلاسة امحاء الحدود بين الأدب والفلسفة الذي قام به. وتتأسّف الباحثة والفيلسوفة هيلين سيكسوس التي كرّست كثير من المؤلّفات والمقالات عن دريدا لذلك، وترى الأمر مخجِلًا.
كان انقطاعه عن وطنه الأمّ الجزائر، ورحيله بحراً صوب فرنسا من أجل الدراسة، بمثابةِ بترٍ آخر. فهذا المسار الذي يبدو "طبيعيًا" للكثير من الجزائريين، ظهرت آثاره لاحقًا، فشكّل جرحاً شخصيّاً لدريدا إلى آخر أيام حياته وفق ما تقول زوجته مارغريت، ولعلّه كان وراء ابتكاره لمفهوم "الحنينيّة"، وربما أيضًا وراء شغفه بـ "الضيافة" الذي كرّس له أوّلا مقالًا في مجلة "Communication"، قبل أن يُعاد نشره مع مقالٍ ثانٍ ضمن حوار غير مباشر مع الفيلسوفة الفرنسيّة والمحللة النفسيّة آن ديفور مانتيل، وصدر ضمن كتاب "De l’hospitalite"( ت. منذر عيّاشي، المركز القومي للترجمة).
في باريس لم ينجح دريدا في البداية في امتحان الدخول إلى Ecole Normal Superieure، لكنه نجح في إقامة صداقة مع أستاذه آنذاك لويس ألتوسير، ويبدو أن الفارق الضئيل في العمر بينهما أدّى دوراً في ذلك، فألتوسير وجد دريدا أكثر طلّابه إثارةً للاهتمام، ولم يكفّ عن تشجيعه ليصير أستاذاً مثله، من خلال التقدّم إلى مسابقة الأستذة، رغم هلع دريدا المزمن من الامتحانات، يقول معلّقًا على الأمر: "أنا أتّهم نظام الامتحانات هذا، هو بمثابة تهديد بالمقصلة. كانت سنوات جهنميّة بالنسبة لي". وفي الفيلم صورة لرسالة من ألتوسير إلى دريدا، يوجّهه فيها: "علينا أن ننظر معًا في هذه الوظيفة: لا أشكّ في قدراتك الاستثنائية، لكن عليك أن تجري تغييرًا جذريًا في ما يخصّ العرض والتعبير".
بيد أن بلوغ دريدا عامه الثاني والثلاثين كان حاسمًا في مسيرته؛ " استمرّت مراهقتي حتّى بلوغي الثانية والثلاثين"، ففي عام 1962، نشر كتابه الأوّل: "مقدّمة لأصل الهندسة الفراغية"، وغيّر اسمه من جاكي إلى جاك. ولاقى كتابه منذ صدوره استحسانًا في الأوساط الأدبيّة والفلسفيّة الفرنسيّة، يشهد عليها الكاتب الفرنسي فيليب سولرز الذي كان رئيس تحرير الدوريّة الطليعيّة، Tel Quel، فدعاه إلى التعاون معه، فكتب مقالًا عن أنطونان آرتو.
علاقة دريدا بالصورة كانت بدورها ذات أهميّة حاسمة، فمن الرفض المطلق والسخرية من صور الكتّاب على أغلفة كتبهم، إلى تلك اللحظة التي اقتنصته فيها الكاميرا عائداً من براغ بعد سجن لثلاثة أيام واتهام بتهريب المخدرات، عقابًا على إلقائه محاضرات سرًّا. ستشكّل هذه اللحظة منعطفًا في حياته، فيقبل بعدها التصوير بإسراف، خاصّة بعد الشهرة الفائقة لـ "التفكيكية" خصوصاً في أميركا. ففي مؤتمر في بالتيمور كان دريدا جنباً إلى جنب مع رولان بارت وجاك لاكان وجيل دولوز وميشيل فوكو، أي أن البنيوية الفرنسيّة كانت كلّها حاضرة، ودشّن هذا المؤتمر دخول "النظرية الفرنسية" إلى المنهاج الأميركي. وهناك التقى دريدا بالأستاذ الجامعي في جامعة يال، والناقد بول دو مان الذي عمل على بثّ أفكار دريدا وكتاباته في صلب الأكاديميا الأميركية. وهذه الصداقة التي جمعت بين الرجلين تشكّل أيضًا جرحًا مُحرجًا لدريدا، فقد تمّ اتهام دو مان بالتعاون مع النازية خلال الحرب العالميّة الثانية بالاستناد إلى مجموعة مقالات كتبها في تلك الفترة، وكان أشهرها مقال بعنوان :"اليهود في الأدب المعاصر". وأرجع بعض الكتّاب سبب الهجوم على دو مان إلى تبنيّه لمفهوم "التفكيكية"، ودافع دريدا عنه في مقال نشر في دورية أميركية.
يركّز الفيلم على صورة دريدا نجمًا في أميركا، يتحلّق حوله المعجبون، ويكون حاضرًا في السلاسل المصورة، فضلًا عن استلهام المخرج الشهير وودي آلن لـ "التفكيكيّة" في عنوان أحد أفلامه "تفكيك هاري". بيد أن الاحتفاء الأميركي بدريدا، قابله نوع من التحفظ والبرود تجاه الفيلسوف من قبل الأكاديميّة الفرنسية الصارمة، التي لم تتقبّل بسلاسة امحاء الحدود بين الأدب والفلسفة الذي قام به. وتتأسّف الباحثة والفيلسوفة هيلين سيكسوس التي كرّست كثير من المؤلّفات والمقالات عن دريدا لذلك، وترى الأمر مخجِلًا.