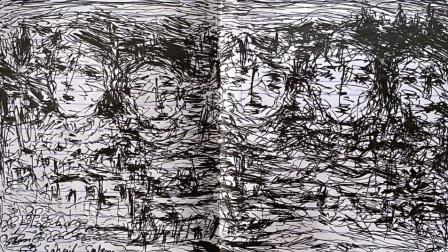الفيلسوف التونسي فتحي التريكي (العربي الجديد)
للفيلسوف فتحي التريكي مكانة مميزة في الفكر التونسي المعاصر، فهو أستاذ الفلسفة ورئيس كرسي اليونسكو للفلسفة في جامعة تونس حاليًا. كان في العشرين من عمره، طالبًا لدى ميشيل فوكو إبان السنتين الللتين قضاهما في تدريس الفلسفة بتونس (1966- 1968). وفي محاضرة مشتركة مع الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، اقترح مفهوم "العيش معًا". وله مؤلفات عديدة باللغتين العربية والفرنسية
* عندما انفجر "الربيع العربي" حضر الجميع : سياسيون ونشطاء ورجال أعمال، الحقيقيون منهم والمزيفون، ولكن اللافت هو الغياب الملحوظ للفيلسوف العربي كما يفترض أن يكون دوره. ألقيتم المسؤولية على الآخرين، أيعني ذلك أن الفيلسوف العربي غير مطالب بأن يراجع أدوات عمله لكي يكون أكثر قدرة على التأثير في واقعه، وكي يجسر العلاقة بينه وبين مواطنيه؟
سؤال وجيه لا بد من محاولة تفكيكه، ويضم أطروحة كاملة حول الفلسفة وعلاقتها بما يقع في العالم العربي، وهل حقيقةً توجد فلسفة في العالم العربي؟ وهل هناك فلاسفة يستطيعون بحق التدخل في ميدان النقاش في الساحات العربية؟. سأبدأ أولًا وبالذات بإعطاء ملامح الفيلسوف، من هو الفيلسوف؟ هناك برأيي ثلاثة أنواع من الفلاسفة : أولًا الفيلسوف الأكاديمي الذي درس في الجامعات التونسية والعربية والعالمية، ثم تخرج وأصبح يدرس في الجامعات، ويشارك في النقاش العمومي ولكن من داخل الهياكل الأكاديمية ووفق المناهج والمدارس الكبرى. ثانيًا، هناك ما نسميه بالفيلسوف العفوي، أي هذا الفيلسوف الذي لم يتكون داخل الاختصاص بالذات، ولكنه درس اختصاصًا آخر كالتاريخ أو الآداب أو غير ذلك، وبحكم تعامله اليومي داخل اختصاصه اضطر إلى الاطلاع على المفاهيم والتصورات الفلسفية، فكوّن لنفسه أرضية تسمح له بأن يكون فيلسوفًا، مثل المؤرخ عبد الله العروي الذي جاء إلى الفلسفة من خارج الفلسفة.
هذا النمط نطلق عليه الفلسفة العفوية، وليس ذلك انتقاصًا من قيمتها، بل لأنها لم تكن وليدة الاختصاصات الضيقة. هناك نوع ثالث من الفلاسفة الذين خرجوا عن الجدار الذي يحيط بالأكاديمية، ويسميه بعض الفلاسفة بالفيلسوف الرحّالة الذي يقتات من المجتمع ومن الأحداث والمحيط، ثم يعود ببعض الأفكار والنظريات، مساهمةً منه في تحريك سواكن المجتمع.
اقــرأ أيضاً
للأسف في العالم العربي المهيمن على الفلسفة هو النوع الثاني، أي الأكاديمي البحت. صحيح هو يحافظ على آليات الفكر الفلسفي، ولكنه يحبسها داخل بوتقات يصعب الخروج منها، بحيث يصبح الفيلسوف هو الذي يولد الفيلسوف، فندخل في دوامة من الصعب الخروج منها. في حين أن الفلاسفة العفويين أمثال العروي وهشام جعيط وعبد المجيد الشرفي، وفي الشرق العربي هناك الكثير من هذا الصنف، هؤلاء لا يستطيعون الذهاب إلى أقصى حد للأسف، لأنهم يجدون أنفسهم مضطرين للعودة إلى اختصاصاتهم الأولى. يبقى النوع الثالث من الفلاسفة، وهو الذي نحتاجه اليوم حقيقة في العالم العربي، الذين يهتمون بالشأن العام. يمكن القول بأنه توجد بدايات في هذا الاتجاه بالعالم العربي، شخصيًا أصدرت كتابًا بعنوان "الفلسفة والحياة اليومية". وهناك بعض الفلاسفة يحاولون الخروج من هذه البوتقة. ورأيي، هو وجوب أن تخرج الفلسفة من دائرة الأكاديميات وأن تختلط بالمجتمع. كيف ذلك؟ أولًا أن يهتم الفيلسوف بالشأن العام، ولنا في تونس قضية كبرى هي ما نسميه بالوفاق، وهي قضية حصلت بموجبها تونس على جائزة نوبل للسلام، لكن الكثير في الأوساط الاجتماعية يعتبرون الوفاق نفاقًا، لماذا؟ لأن فكرة الوفاق هذه لم تأخذ حظها من الدرس الفلسفي. إذ عندما نقول وفاقاً، نقول بالتالي حواراً. وإذا قلتُ حوارًا فإني اعترفت ضمنيًا بحق التنوع وحق الاختلاف داخل المجتمع، وإذا قمت بذلك فإن فكرة الاختلاف، ولأول مرة تقريبًا في العالم العربي، تصبح فكرة أوليةً وليس فكرة الوحدة.
إذن، هناك عمل كبير على الفلسفة أن تقوم به في ما يخص الوفاق، وشخصيًا لم أجد فيلسوفًا أو مفكرًا عربيًا قد قام بهذا العمل. بينما بعد سقوط جدار برلين ودخول المعسكر الاشتراكي في حوارات كبرى ومهمة جدًا، جاءت فكرة ما يسميه هيبرماس "التواصل الحواري". نحن علينا الآن في تونس أن نؤسس لفكرة التوافق من حيث هي فكرة فلسفية كمفهوم وتصور عام لنمط الحياة، وهذا أمر ممكن.
اقــرأ أيضاً
* لكن الحاصل حاليًا، أننا عدنا إلى الصراع حول السلطة كأداة لإدارة المجتمع، رغم أن الشعار المرفوع هو إعادة السيادة إلى الشعب، هل إن بناء منظومة ديمقراطية شعبية يمكن أن تتعرض إلى تهديد حقيقي من قبل قوى قد تكون اقتصادية واجتماعية وكذلك ثقافية، تفرغ مسألة الانتقال الديمقراطي من مضامينه الحقيقية، في هذا السياق هل يمكن للفيلسوف أن يقوم بدوره حتى يمنع حصول انقلاب نظري على الديمقراطية ذاتها؟
من الصعب جدًا في رأيي أن يحصل انقلاب نظري بهذا الوضوح على مسار التحولات الديمقراطية، فهذا الاحتمال حسب رأيي غير مقبول في تونس. ولكن السؤال مهم جدًا، إذ بواسطة ما نسميه بالفهم الخاطئ لدور الثقافة في المجتمع، يمكن أن تكون هناك انتكاسات وعودة إلى الوراء. لهذا دعوت إلى الاهتمام في كل مرة بدور الثقافة في الثورة التونسية، وهذا الدور كان ولا يزال ضعيفًا إلى أقصى حد. حتى الأحزاب السياسية لم تعر اهتمامًا للثقافة. أنا الآن بصدد إنجاز كتاب حول الثقافة، خاصة في تونس. فأنا قلق جدًا مما يقع الآن في تونس، فوزارة الثقافة لم يكن لديها منذ الثورة وإلى يومنا هذا رؤية واضحة، وقد لا يهمها ذلك أساسًا. فما وقع في المحيط التونسي تدخلت فيه عوامل كثيرة : السفارات الأجنبية والمال الفاسد، تدخل كل شيء في الساحة الثقافية ما عدا الدولة، وهذا خطر كبير جدًا. لا بد من أن يتدخل الفيلسوف، لا أقول لتصحيح المسار لأنه لا سلطة للفيلسوف، ولكن السلطة التي له هي سلطة فكرية قد تجد لها مجالًا في الحاضر وأيضًا في المستقبل.
نعم، لا نستطيع أن نبني منظومة ديمقراطية قابلة للدوام والصمود بدون حفر ووضع أسس لرؤيا ثقافية جديدة، قلت إن غياب الفيلسوف خطير جدًا، هل نجد الآن في المكتبات مثلًا وحتى على الساحة العامة وفي الجرائد والمجلات، نقاشًا حول التصورات الجديدة للديمقراطية؟. وقد كتبت في العشرية الأولى من هذا القرن، الكثير حول الديمقراطية مع فلاسفة ألمان وفرنسيين، وشرحنا ماذا تعني الآن الديمقراطية في عصر التثاقف، لأن العصر الذي نعيش فيه ليس عصر الثقافات المحلية. نعم الثقافة المحلية مهمة، ولكننا الآن نعيش عصرًا آخر، هو عصر تلاقح الثقافات أحببنا هذا أم كرهناه. فالتلاقح الثقافي الكبير الموجود الآن في العالم، قد غيّر الكثير من المعطيات في الفكر الديمقراطي. كانت الديمقراطية متوجهة نحو مفهوم الصندوق، في حين أصبح الصندوق الآن، وهذا ما لم يفهمه الكثيرون، ثانويًا، وأن الحراك الاجتماعي هو الذي هيمن وسيهيمن في المستقبل، وتلك هي الديمقراطية الجديدة.
* منذ 5 سنوات ونصف السنة، وقضية الهوية مطروحة بحدة، وبدلًا من أن تكون عنصرًا من عناصر بناء المنظومة الديمقراطية الجديدة وبالتالي خلق نوع من التضامن الداخلي، أصبحت عنصر تقسيم وتأزم مستمر للوضع مما هدد عملية الانتقال الديمقراطي. هل الهوية إشكالية حقيقية أم مسألة مغلوطة، وخاصة في سياق انتقال من هذا النوع؟
كتبت دائمًا في أعمالي أو أبحاثي أننا إلى حد الآن لم نفهم معنى الهوية، وذلك منذ فلاسفة النهضة العربية. لقد اعتبرنا أن الهوية هي التأصيل وهي حركية تعيد للماضي إشعاعه. هذا الفهم للهوية هو الذي سيطر ولا يزال. وما دام هذا التصور هو المهيمن ستبقى دائمًا الهوية عائقًا من عوائق التقدم.
لو قمنا بدراسة الهوية من وجهة نظر فلسفية عريقة كما قام بها الفلاسفة ابتداء من أفلاطون وأرسطو إلى هايدغر، مرورًا بابن سينا والفارابي وابن رشد، نجد أن الهوية ليس فيها عنصر ثابت في حد ذاته. أي أن الثبات الموجود في الهوية هو ثبات للذات وليس ثباتاً في الذات، بمعنى أن ما أعتبره عناصر ثابتة كونها ثابتة كما أراها أنا، لا كما يراها غيري، أي أن هويتي يجب أن تتضمن كل التغيرات التي تحدث لي منذ أن نشأت إلى أن أموت. ويسميها هايدغر "بتمطي الحياة بين الولادة والموت". إذا اعتبرت الهوية بهذه الطريقة، فإن كل ما يحدث لي حتى عندما أتعلم الأنترنت مثلًا، فهذه التكنولوجيا الحديثة تصبح عنصرًا من عناصر ذاتي ومن هويتي، ولا يقتصر الأمر فقط على ما اكتسبته من الماضي، بل أيضًا ما أكتسبه من الحاضر وفي المستقبل، عندئذ تصبح الهوية ليست فعالة فقط، بل أيضًا استراتيجية ودافعًا للتطور لا عائقًا للتقدم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كما يقول بول ريكور، "إن هويتي لا يمكن أن تكون وحدها في العالم" لأن الآخر له هوية وهو آخر بالنسبة لي وأنا آخر بالنسبة إليه، بحيث لا مكان للتقوقع الهووي. كل هوية مجبرة على أن تعترف للآخر بهويته. كيف تريد أن يعترف الآخر بهويتك وأنت لا تعترف للآخر بهويته، ولهذا بالتعبير الفلسفي، الهوية تفرض عليك الغيرية بمعنى أنني لا بد، وحفاظًا على هويتي، أن أحافظ على هوية غيري. يقول القائل ما العمل وكيف السبيل إلى ذلك؟
اقــرأ أيضاً
ألقيت في سنة 1998 محاضرة مشتركة مع جاك دريدا في تونس، اقترحت خلالها مفهوم العيش معًا أو العيش سويًا، وأنا أفضل "العيش معًا" لأنه يعتمد أساسًا على الحق في التنوع داخل مجتمع ما، فإذا اعترفت بهذه الغيرية والتنوع، فأنا مجبر أن أعيش معك. العيش معًا هي فترة أولى تعتمد الاعتراف بالآخر. أما الفترة الثانية، هي ما سميته في ما بعد بـ"العيش معًا في كنف الكرامة"، حيث أضفنا كلمة الكرامة سنة 2000، لماذا؟ لأن الكرامة ستكون هي المرحلة الثانية في العيش المشترك. إذا استطعنا أن نحترم هويتنا ونحترم هوية الآخر ونعيش معًا بتعقل، فعندئذ أستطيع أن أمر إلى احترام الآخر في مأكله وملبسه وعقائده ونمط عيشه، وأحافظ أيضًا على كرامتي بالمحافظة على كرامته.
المرحلة الثالثة والأخيرة التي يمكن أن نمر فيها، وليس كل المجتمعات بوسعها أن تفعل ذلك، هي ما سميته "بالتآنس" أي أن يصبح الإنسان شيئًا فشيئًا بعد أن يصل إلى مرحلة العيش معًا، في السعادة وليس في الكرامة فقط. أي أن أكون سعيدًا بحضورك وأنت ليس لديك الهوية نفسها التي لي، وأنت تعتقد بشيء آخر غير اعتقادي.
أنا بصدد الاشتغال على "التآنس"، وهي كلمة من نحتي شخصيًا، لأن الكلمتين المعروفتين هما "المآنسة" و"التأنس" التي تفيد تحولًا من البداوة إلى الحضارة، وتفيد "المآنسة" الاشتراك في الأنس، ولكن من جانب واحد كالمثقفين الذين يأنسون الوزير عند أبي حيان التوحيدي. أما كلمة التآنس فهي تعني المشاركة من الجانبين، مني ومن الآخر، لكي نصل إلى مرحلة قصوى من السعادة تتمثل في هذا التآنس، وهي مرحلة صعبة لا محالة وأكاد أقول إنها طوباوية ولكنها ضرورية.
اقــرأ أيضاً
فمسألة الهوية في نهاية المطاف، إذا أردنا أن نتجاوزها بصفة نهائية، يجب أن نترك كل ما كتب حولها جانبًا، وأن نعود إلى الفكر الفلسفي الموجود بيننا : فكرة الذات عند ابن سينا، وأيضًا عند ابن رشد، ونعود إلى ما جاءت به الفلسفة في اليونان وفي الغرب، وسنجد أن الهوية فيها إشكال بسيط يعبّر عن الذات وهي الذات التي تتطور. ومن المستحيل أن يقول أي أحد في العالم بأن الذات لا تتطور. إذا بنيت هويتي على ما أسميه تحولات هايدغر التي توحي بالتحول، مثال ذلك أن تلقم شجرة من تفاحة إلى شكل آخر من التفاح، هي في الحقيقة لم تفقد هويتها لأنها بقيت تفاحة، ولكن بشكل آخر بفضل حصول تحول بيولوجي في الهوية. أنا لا أفقد هويتي الأصلية عندما تتحول إلى شيء آخر، فأنا دائمًا أبقى أنا ولكن بمعطيات أخرى وفي ظرفية مختلفة.
* بما أنك تحدثت عن التفاحة التي تتحول إلى شيء إضافي لكن بنهاية الأمر تبقى نوعًا من أنواع التفاح، أيعني هذا أن في الهوية حد أدنى من الثبات؟
كما قلت لك، هناك حد أدنى من الثبات، ولكن هذا الثبات لا يجب ألا يتحول إلى اللازمني "أبدي"، هو ثبات ولكن داخل الزمن.
* هل أن الدين عنصر من عناصر التشكيل والهوية، وهل يخضع إلى الديناميكية نفسها التي تخضع لها الهوية حسب تعريفك السابق، ثم هل يمكن أن يكون الدين عنصرًا داعمًا لبناء نظام ديمقراطي أو أنه يمكن أن يكون عنصرًا معرقلًا لعملية البناء؟
أنا أفرق بين ما نسميه الدين وبين الاستعمال السيئ للدين. هما شيئان يختلفان بالإطلاق. الدين في حد ذاته كما يقول الفيلسوف إيمانويل كانط، أساسي لبناء التحضر، لماذا؟ لأن التحضر ليس فقط اقتناء التكنولوجيا أو التحولات العلمية، ولكن هو أيضًا، وهذه الفكرة كانطية، استنبات القيم الأخلاقية والقيم الثقافية القصوى في المجتمع. لن يستطيع مجتمع ما أن يصبح متحضرًا ومثقفًا إذا حصر تقدمه في الميدان العلمي والميدان التكنولوجي. فالدين هنا، إذا أخذناه في استعماله الطيب والمهم، يمكن أن يساعد على هذا الانتقال إلى الحضارة لأنه دافع مهم لتقبل القيم الأخلاقية أولًا والقيم الإنسانية الكبرى.
الآن إذا استعملنا الدين استعمالا سيئًا ورأينا فيه عنصرًا يشجع على الانقسامات بدعوى أنه سيقضي على الآخر، عندئذ سيصبح الدين من أكبر العوائق في سبيل التحضر والتقدم. تعودت دائمًا وأبدًا في كتاباتي، لأن يكون الدين هو ولا سيما الإسلام، لأن الإسلام هو في الحقيقة ملخص حسب رأيي للأديان السماوية الكبرى، هو إيمان وإحسان. وبهذا المعنى لن يكون إلا سلامًا، وكل ما خالف السلام فهو ليس من الدين ولا علاقة له بالدين.
ولكي يكون الدين إيمانًا وإحسانًا يجب أن يكون فردانيًا يخص أولًا وأساسًا الفرد الذي سيصبح، إن شئنا مؤمنًا، فهو المؤمن في هذا السياق وليس المجتمع، وبالتالي سيصبح هو المحسن وليس المجتمع، لأن المجتمع لن يكون محسنًا، إذ فيه كل التناقضات الكبرى. كذلك لن يكون مؤمنًا لأن المجتمع فيه كل العقائد الخيرة والشريرة. بحيث إذا وافقنا على هذه الفكرة فسوف يصبح الدين عنصرًا من عناصر بناء الديمقراطية باعتباره هو الذي سيحرض، كما يقول كانط، إلى جانب القيم الكونية والثقافية والقيم الدينية، على استيعاب الديمقراطية ودعمها، بشرط أن تتضافر الجهود كلها لتجعل من المجتمع مجتمعًا متحضرًا.
سؤال وجيه لا بد من محاولة تفكيكه، ويضم أطروحة كاملة حول الفلسفة وعلاقتها بما يقع في العالم العربي، وهل حقيقةً توجد فلسفة في العالم العربي؟ وهل هناك فلاسفة يستطيعون بحق التدخل في ميدان النقاش في الساحات العربية؟. سأبدأ أولًا وبالذات بإعطاء ملامح الفيلسوف، من هو الفيلسوف؟ هناك برأيي ثلاثة أنواع من الفلاسفة : أولًا الفيلسوف الأكاديمي الذي درس في الجامعات التونسية والعربية والعالمية، ثم تخرج وأصبح يدرس في الجامعات، ويشارك في النقاش العمومي ولكن من داخل الهياكل الأكاديمية ووفق المناهج والمدارس الكبرى. ثانيًا، هناك ما نسميه بالفيلسوف العفوي، أي هذا الفيلسوف الذي لم يتكون داخل الاختصاص بالذات، ولكنه درس اختصاصًا آخر كالتاريخ أو الآداب أو غير ذلك، وبحكم تعامله اليومي داخل اختصاصه اضطر إلى الاطلاع على المفاهيم والتصورات الفلسفية، فكوّن لنفسه أرضية تسمح له بأن يكون فيلسوفًا، مثل المؤرخ عبد الله العروي الذي جاء إلى الفلسفة من خارج الفلسفة.
هذا النمط نطلق عليه الفلسفة العفوية، وليس ذلك انتقاصًا من قيمتها، بل لأنها لم تكن وليدة الاختصاصات الضيقة. هناك نوع ثالث من الفلاسفة الذين خرجوا عن الجدار الذي يحيط بالأكاديمية، ويسميه بعض الفلاسفة بالفيلسوف الرحّالة الذي يقتات من المجتمع ومن الأحداث والمحيط، ثم يعود ببعض الأفكار والنظريات، مساهمةً منه في تحريك سواكن المجتمع.
للأسف في العالم العربي المهيمن على الفلسفة هو النوع الثاني، أي الأكاديمي البحت. صحيح هو يحافظ على آليات الفكر الفلسفي، ولكنه يحبسها داخل بوتقات يصعب الخروج منها، بحيث يصبح الفيلسوف هو الذي يولد الفيلسوف، فندخل في دوامة من الصعب الخروج منها. في حين أن الفلاسفة العفويين أمثال العروي وهشام جعيط وعبد المجيد الشرفي، وفي الشرق العربي هناك الكثير من هذا الصنف، هؤلاء لا يستطيعون الذهاب إلى أقصى حد للأسف، لأنهم يجدون أنفسهم مضطرين للعودة إلى اختصاصاتهم الأولى. يبقى النوع الثالث من الفلاسفة، وهو الذي نحتاجه اليوم حقيقة في العالم العربي، الذين يهتمون بالشأن العام. يمكن القول بأنه توجد بدايات في هذا الاتجاه بالعالم العربي، شخصيًا أصدرت كتابًا بعنوان "الفلسفة والحياة اليومية". وهناك بعض الفلاسفة يحاولون الخروج من هذه البوتقة. ورأيي، هو وجوب أن تخرج الفلسفة من دائرة الأكاديميات وأن تختلط بالمجتمع. كيف ذلك؟ أولًا أن يهتم الفيلسوف بالشأن العام، ولنا في تونس قضية كبرى هي ما نسميه بالوفاق، وهي قضية حصلت بموجبها تونس على جائزة نوبل للسلام، لكن الكثير في الأوساط الاجتماعية يعتبرون الوفاق نفاقًا، لماذا؟ لأن فكرة الوفاق هذه لم تأخذ حظها من الدرس الفلسفي. إذ عندما نقول وفاقاً، نقول بالتالي حواراً. وإذا قلتُ حوارًا فإني اعترفت ضمنيًا بحق التنوع وحق الاختلاف داخل المجتمع، وإذا قمت بذلك فإن فكرة الاختلاف، ولأول مرة تقريبًا في العالم العربي، تصبح فكرة أوليةً وليس فكرة الوحدة.
إذن، هناك عمل كبير على الفلسفة أن تقوم به في ما يخص الوفاق، وشخصيًا لم أجد فيلسوفًا أو مفكرًا عربيًا قد قام بهذا العمل. بينما بعد سقوط جدار برلين ودخول المعسكر الاشتراكي في حوارات كبرى ومهمة جدًا، جاءت فكرة ما يسميه هيبرماس "التواصل الحواري". نحن علينا الآن في تونس أن نؤسس لفكرة التوافق من حيث هي فكرة فلسفية كمفهوم وتصور عام لنمط الحياة، وهذا أمر ممكن.
من الصعب جدًا في رأيي أن يحصل انقلاب نظري بهذا الوضوح على مسار التحولات الديمقراطية، فهذا الاحتمال حسب رأيي غير مقبول في تونس. ولكن السؤال مهم جدًا، إذ بواسطة ما نسميه بالفهم الخاطئ لدور الثقافة في المجتمع، يمكن أن تكون هناك انتكاسات وعودة إلى الوراء. لهذا دعوت إلى الاهتمام في كل مرة بدور الثقافة في الثورة التونسية، وهذا الدور كان ولا يزال ضعيفًا إلى أقصى حد. حتى الأحزاب السياسية لم تعر اهتمامًا للثقافة. أنا الآن بصدد إنجاز كتاب حول الثقافة، خاصة في تونس. فأنا قلق جدًا مما يقع الآن في تونس، فوزارة الثقافة لم يكن لديها منذ الثورة وإلى يومنا هذا رؤية واضحة، وقد لا يهمها ذلك أساسًا. فما وقع في المحيط التونسي تدخلت فيه عوامل كثيرة : السفارات الأجنبية والمال الفاسد، تدخل كل شيء في الساحة الثقافية ما عدا الدولة، وهذا خطر كبير جدًا. لا بد من أن يتدخل الفيلسوف، لا أقول لتصحيح المسار لأنه لا سلطة للفيلسوف، ولكن السلطة التي له هي سلطة فكرية قد تجد لها مجالًا في الحاضر وأيضًا في المستقبل.
نعم، لا نستطيع أن نبني منظومة ديمقراطية قابلة للدوام والصمود بدون حفر ووضع أسس لرؤيا ثقافية جديدة، قلت إن غياب الفيلسوف خطير جدًا، هل نجد الآن في المكتبات مثلًا وحتى على الساحة العامة وفي الجرائد والمجلات، نقاشًا حول التصورات الجديدة للديمقراطية؟. وقد كتبت في العشرية الأولى من هذا القرن، الكثير حول الديمقراطية مع فلاسفة ألمان وفرنسيين، وشرحنا ماذا تعني الآن الديمقراطية في عصر التثاقف، لأن العصر الذي نعيش فيه ليس عصر الثقافات المحلية. نعم الثقافة المحلية مهمة، ولكننا الآن نعيش عصرًا آخر، هو عصر تلاقح الثقافات أحببنا هذا أم كرهناه. فالتلاقح الثقافي الكبير الموجود الآن في العالم، قد غيّر الكثير من المعطيات في الفكر الديمقراطي. كانت الديمقراطية متوجهة نحو مفهوم الصندوق، في حين أصبح الصندوق الآن، وهذا ما لم يفهمه الكثيرون، ثانويًا، وأن الحراك الاجتماعي هو الذي هيمن وسيهيمن في المستقبل، وتلك هي الديمقراطية الجديدة.
كان الشارع في بدايات الديمقراطية بالغرب أساسيًا، ثم تحولت الديمقراطية شيئًا فشيئًا إلى ما نسميه بواسطة الحقوقيين واستعمال الدستور والتنظيم المحكم للمجتمع إلى صندوق انتخاب بين حزبين أو شكلين أو نظريتين، وعندما يشارك الفرد بالانتخابات تخرج النتيجة، ثم يترقب ثلاث أو أربع سنوات ليعيد القيام بنفس العملية. الآن، وليس عندنا فقط، وإنما أيضًا في أوروبا، مثل حركة Le mouvement indignez-vous، (حركة اغضبوا)، وكذلك Les ruines debouts. وفي بلاد شرق أوروبا وأميركا اللاتينية أصبحت الديمقراطية تحوم حول نوع جديد La démocratie active "الديمقراطية النشيطة"، التي ليست هي "الديمقراطية التشاركية" La démocratie participative، بمعنى أن تتشارك الجمعيات والمجتمع المدني والكل في تنظيم المجتمع ديمقراطيًا. بينما الديمقراطية النشيطة هي التي تستعمل الإجراءات التشريعية وكل ما هو قانوني، لكنها في الآن نفسه تستعمل أيضًا الشارع والاحتجاجات وتستعمل أيضًا حراك المجتمع المدني. هذه الديمقراطية الجديدة التي لم ننتبه إليها ولم نؤسس لها نظريات تقوم عليها لتنظيمها، لأنه لا يعقل أن يعيش المجتمع دائمًا وأبدًا في حراك اجتماعي، ولكن يمكن أن ينظم هذا الحراك الاجتماعي ويصبح وسيلة من وسائل التعبير الديمقراطي. قمت في هذا الشأن بكتابة بعض الأعمال باللغة الفرنسية، وساهمت في كتب ألمانية لكنها لم تأخذ حظها في العالم العربي. فالثقافة الديمقراطية ثقافة أساسية، ولا يعقل أن يعيش بلد تحولًا ديمقراطيًا بدون وجود نقاش حول الثقافة الديمقراطية. هل فتحت يومًا جريدة أو مجلة تونسية ووجدت هذا النوع من النقاش؟ لا. أنا من الذين يعتبرون أن التفكير في الثقافة وفي علاقتها بالديمقراطية، أمر أساسي لسببين: لأن الثقافة لم تعد ثقافة محلية وأصبحت تثاقفًا، ولأن الثقافة الديمقراطية تلعب دورًا حاضرًا ومستقبلًا، وما علينا إلا أن نفككها حسب تعبير جاك دريدا.
* منذ 5 سنوات ونصف السنة، وقضية الهوية مطروحة بحدة، وبدلًا من أن تكون عنصرًا من عناصر بناء المنظومة الديمقراطية الجديدة وبالتالي خلق نوع من التضامن الداخلي، أصبحت عنصر تقسيم وتأزم مستمر للوضع مما هدد عملية الانتقال الديمقراطي. هل الهوية إشكالية حقيقية أم مسألة مغلوطة، وخاصة في سياق انتقال من هذا النوع؟
كتبت دائمًا في أعمالي أو أبحاثي أننا إلى حد الآن لم نفهم معنى الهوية، وذلك منذ فلاسفة النهضة العربية. لقد اعتبرنا أن الهوية هي التأصيل وهي حركية تعيد للماضي إشعاعه. هذا الفهم للهوية هو الذي سيطر ولا يزال. وما دام هذا التصور هو المهيمن ستبقى دائمًا الهوية عائقًا من عوائق التقدم.
لو قمنا بدراسة الهوية من وجهة نظر فلسفية عريقة كما قام بها الفلاسفة ابتداء من أفلاطون وأرسطو إلى هايدغر، مرورًا بابن سينا والفارابي وابن رشد، نجد أن الهوية ليس فيها عنصر ثابت في حد ذاته. أي أن الثبات الموجود في الهوية هو ثبات للذات وليس ثباتاً في الذات، بمعنى أن ما أعتبره عناصر ثابتة كونها ثابتة كما أراها أنا، لا كما يراها غيري، أي أن هويتي يجب أن تتضمن كل التغيرات التي تحدث لي منذ أن نشأت إلى أن أموت. ويسميها هايدغر "بتمطي الحياة بين الولادة والموت". إذا اعتبرت الهوية بهذه الطريقة، فإن كل ما يحدث لي حتى عندما أتعلم الأنترنت مثلًا، فهذه التكنولوجيا الحديثة تصبح عنصرًا من عناصر ذاتي ومن هويتي، ولا يقتصر الأمر فقط على ما اكتسبته من الماضي، بل أيضًا ما أكتسبه من الحاضر وفي المستقبل، عندئذ تصبح الهوية ليست فعالة فقط، بل أيضًا استراتيجية ودافعًا للتطور لا عائقًا للتقدم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، كما يقول بول ريكور، "إن هويتي لا يمكن أن تكون وحدها في العالم" لأن الآخر له هوية وهو آخر بالنسبة لي وأنا آخر بالنسبة إليه، بحيث لا مكان للتقوقع الهووي. كل هوية مجبرة على أن تعترف للآخر بهويته. كيف تريد أن يعترف الآخر بهويتك وأنت لا تعترف للآخر بهويته، ولهذا بالتعبير الفلسفي، الهوية تفرض عليك الغيرية بمعنى أنني لا بد، وحفاظًا على هويتي، أن أحافظ على هوية غيري. يقول القائل ما العمل وكيف السبيل إلى ذلك؟
المرحلة الثالثة والأخيرة التي يمكن أن نمر فيها، وليس كل المجتمعات بوسعها أن تفعل ذلك، هي ما سميته "بالتآنس" أي أن يصبح الإنسان شيئًا فشيئًا بعد أن يصل إلى مرحلة العيش معًا، في السعادة وليس في الكرامة فقط. أي أن أكون سعيدًا بحضورك وأنت ليس لديك الهوية نفسها التي لي، وأنت تعتقد بشيء آخر غير اعتقادي.
أنا بصدد الاشتغال على "التآنس"، وهي كلمة من نحتي شخصيًا، لأن الكلمتين المعروفتين هما "المآنسة" و"التأنس" التي تفيد تحولًا من البداوة إلى الحضارة، وتفيد "المآنسة" الاشتراك في الأنس، ولكن من جانب واحد كالمثقفين الذين يأنسون الوزير عند أبي حيان التوحيدي. أما كلمة التآنس فهي تعني المشاركة من الجانبين، مني ومن الآخر، لكي نصل إلى مرحلة قصوى من السعادة تتمثل في هذا التآنس، وهي مرحلة صعبة لا محالة وأكاد أقول إنها طوباوية ولكنها ضرورية.
فمسألة الهوية في نهاية المطاف، إذا أردنا أن نتجاوزها بصفة نهائية، يجب أن نترك كل ما كتب حولها جانبًا، وأن نعود إلى الفكر الفلسفي الموجود بيننا : فكرة الذات عند ابن سينا، وأيضًا عند ابن رشد، ونعود إلى ما جاءت به الفلسفة في اليونان وفي الغرب، وسنجد أن الهوية فيها إشكال بسيط يعبّر عن الذات وهي الذات التي تتطور. ومن المستحيل أن يقول أي أحد في العالم بأن الذات لا تتطور. إذا بنيت هويتي على ما أسميه تحولات هايدغر التي توحي بالتحول، مثال ذلك أن تلقم شجرة من تفاحة إلى شكل آخر من التفاح، هي في الحقيقة لم تفقد هويتها لأنها بقيت تفاحة، ولكن بشكل آخر بفضل حصول تحول بيولوجي في الهوية. أنا لا أفقد هويتي الأصلية عندما تتحول إلى شيء آخر، فأنا دائمًا أبقى أنا ولكن بمعطيات أخرى وفي ظرفية مختلفة.
* بما أنك تحدثت عن التفاحة التي تتحول إلى شيء إضافي لكن بنهاية الأمر تبقى نوعًا من أنواع التفاح، أيعني هذا أن في الهوية حد أدنى من الثبات؟
كما قلت لك، هناك حد أدنى من الثبات، ولكن هذا الثبات لا يجب ألا يتحول إلى اللازمني "أبدي"، هو ثبات ولكن داخل الزمن.
* هل أن الدين عنصر من عناصر التشكيل والهوية، وهل يخضع إلى الديناميكية نفسها التي تخضع لها الهوية حسب تعريفك السابق، ثم هل يمكن أن يكون الدين عنصرًا داعمًا لبناء نظام ديمقراطي أو أنه يمكن أن يكون عنصرًا معرقلًا لعملية البناء؟
أنا أفرق بين ما نسميه الدين وبين الاستعمال السيئ للدين. هما شيئان يختلفان بالإطلاق. الدين في حد ذاته كما يقول الفيلسوف إيمانويل كانط، أساسي لبناء التحضر، لماذا؟ لأن التحضر ليس فقط اقتناء التكنولوجيا أو التحولات العلمية، ولكن هو أيضًا، وهذه الفكرة كانطية، استنبات القيم الأخلاقية والقيم الثقافية القصوى في المجتمع. لن يستطيع مجتمع ما أن يصبح متحضرًا ومثقفًا إذا حصر تقدمه في الميدان العلمي والميدان التكنولوجي. فالدين هنا، إذا أخذناه في استعماله الطيب والمهم، يمكن أن يساعد على هذا الانتقال إلى الحضارة لأنه دافع مهم لتقبل القيم الأخلاقية أولًا والقيم الإنسانية الكبرى.
الآن إذا استعملنا الدين استعمالا سيئًا ورأينا فيه عنصرًا يشجع على الانقسامات بدعوى أنه سيقضي على الآخر، عندئذ سيصبح الدين من أكبر العوائق في سبيل التحضر والتقدم. تعودت دائمًا وأبدًا في كتاباتي، لأن يكون الدين هو ولا سيما الإسلام، لأن الإسلام هو في الحقيقة ملخص حسب رأيي للأديان السماوية الكبرى، هو إيمان وإحسان. وبهذا المعنى لن يكون إلا سلامًا، وكل ما خالف السلام فهو ليس من الدين ولا علاقة له بالدين.
ولكي يكون الدين إيمانًا وإحسانًا يجب أن يكون فردانيًا يخص أولًا وأساسًا الفرد الذي سيصبح، إن شئنا مؤمنًا، فهو المؤمن في هذا السياق وليس المجتمع، وبالتالي سيصبح هو المحسن وليس المجتمع، لأن المجتمع لن يكون محسنًا، إذ فيه كل التناقضات الكبرى. كذلك لن يكون مؤمنًا لأن المجتمع فيه كل العقائد الخيرة والشريرة. بحيث إذا وافقنا على هذه الفكرة فسوف يصبح الدين عنصرًا من عناصر بناء الديمقراطية باعتباره هو الذي سيحرض، كما يقول كانط، إلى جانب القيم الكونية والثقافية والقيم الدينية، على استيعاب الديمقراطية ودعمها، بشرط أن تتضافر الجهود كلها لتجعل من المجتمع مجتمعًا متحضرًا.