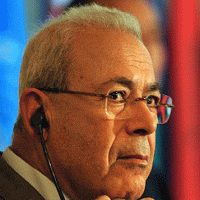.. عن صحوة السوريين العلويين
أثارت التفجيرات التي ذهب ضحيتها، قبل أيام، عشرات من المدنيين السوريين، معظمهم من أطفال المدارس الصغار، موجة من الاحتجاجات والتساؤلات التي تجاوزت حي عكرمة الحمصي، ولا تزال تفاعلاتها مستمرة في أوساط الموالاة والمعارضة، وما حصل من مظاهرات، وما تردد في المناسبة من شعارات وتوجيه اتهامات وإدانة مباشرة للنظام في معسكر الموالاة نفسه، يشكل إرهاصات مهمة من زاويتين:
الأولى لما يظهره من التوتر العميق الذي تعيشه قطاعاتٌ متزايدة من السوريين العلويين الذين استمالهم النظام إلى صفّه، سواء بتغذية مخاوفهم على وجودهم، من جراء أي تغييرٍ، يمكن أن يطرأ على توازن السلطة وصيغة الحكم، أو من خلال وعدهم المضمر بأن تحقيق النصر على الثائرين يعني أخذ الدولة السورية والبلاد ومواردها جميعا غنيمة حرب، وإلحاق أغلبية العلويين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف صعبة بـ "إخوتهم" من أعضاء المافيا التي تسيطر على البلاد منذ عقود وبزبانيتها ومحاسيبها المقربين. هكذا يتحولون، جميعاً، إلى أسياد ومتمولين، بعد كسر إرادة الثائرين "الخونة والطائفيين والتكفيريين"، الخارجين على إرادة سادتهم، وبعد إعادة وضع أيدي هؤلاء العبيد المتمردين وأرجلهم في القيود والأغلال.
والحال، بعد مرور ما يقارب السنوات الأربع على الحرب الأكثر وحشية في تاريخ البلاد، لم يبق في سورية ما يمكن تقاسمه من موارد أو امتيازات، حتى لو تحقق الانتصار، وقد أصبح من حكم المستحيل. وإذا استمرت الحرب سنوات مقبلة، لن يبقى، أصلاً، سوريون علويون ليرثوا شيئاً. أما كابوس الموت والإبادة الذي حذرهم منه النظام، إذا ترددوا في وضع أنفسهم في خدمته لدحر أعداء الوطن والدين، فلم يعد تهديداً محتملاً، أو خطراً جاثماً، بعد نجاح الثورة، لكنه تحول إلى واقع يومي، وحصاد مر لحربٍ لا تبقي ولا تذر، فهي لم تترك أسرة سورية علوية من دون أن تُفقدها واحداً أو أكثر من أبنائها، ولا يزال باب الخروج منها أو إنهائها بعيد المنال.
لم تحصل الإبادة التي حذروا منها نتيجة التنازل عن حماية عرش الأسد ونظامه، وإنما ثمناً لهذه الحماية نفسها، في الوقت الذي لم تبق في سورية المدمرة بالبراميل المتفجرة، وما أضيف إليها من قذائف التوماهوك أخيراً، أي غنيمة لمغتنم. ويدرك الجميع أنه لن يمضي وقت طويل، قبل أن يتسابق رجال النظام على الهرب من الجحيم الذي حولوا سورية إليه بأيديهم، باستثناء أولئك الذين تقتضي مصلحة إيران بقاءهم، ولو في مربع من كيلومتر واحد، لتأكيد وجود النظام واستمراره، وأعني بشار الأسد وحلقته الضيقة بالذات.
والزاوية الثانية التي تبدو منها الاحتجاجات الأخيرة ذات أهمية كبيرة، هي أن هذا التوتر، والخوف المتزايد من انفكاك القاعدة الاجتماعية العلوية الرئيسية لمعسكر الولاء، لا يترك للقطاعات الأكثر تطرفاً وتمسكاً بالنصر النهائي والإلهي في النظام، وعلى قمتها طهران وحزب الله وقادة الأجهزة الأمنية، خياراً آخر للجم مشاعر الخوف المعاكس عند العلويين من عواقب الاستمرار في القتال، حتى آخر قطرة دم من أبنائهم، سوى تنفيذ برنامج تفجيرات مروعة، تستهدف الأطفال والمدنيين، على أمل إحياء مشاعر الخوف والهلع عندهم، في سبيل استعادتهم إلى حظيرة النظام. كان الخوف من هذه الحرب الاستباقية التي تشنها الأطراف الأكثر تشدداً من ميليشيات النظام الداخلية والخارجية على السوريين العلويين، المنهكين والحالمين بالعودة إلى السلام، هو الذي جعلهم يكتشفون، بخبرتهم وغريزة البقاء، أو هكذا يظنون، أن أطرافا من معسكر النظام هي المسؤولة عن وضع المفخخات التي راح ضحيتها عشرات الأطفال الأبرياء.
لم تكن سورية أكثر ضياعاً، ولم يكن السوريون أكثر إنهاكاً، وخوفاً على مصيرهم، ويأساً من تدخل العالم الخارجي لصالحهم. وبالتالي، استعدادا لوقف القتال، والعودة إلى لغة الحوار والتسويات مما يبدون عليه الآن، بعد أن خبرت كل الأطراف أن العالم غير معني بمأساتهم، وأن أي حسم عسكري، حتى لو حصل، لن يعني أي انتصار، وأن وطنهم في طريقه إلى الذوبان كالملح بين أيديهم ليتركهم، في الداخل والخارج، ميتمين وشهداء وجرحى ومعاقين ومشردين ومهزومين، في وقت تكاد جميع الدول التي وضعت يدها على النزاع تتفق على شيء واحد، هو تحويل سورية، الوطن المغدور، إلى مسرح تصفية حساباتها وحسابات خصومها التي لا تزال مجمدة منذ سنوات، وبعضها منذ عقود، مستخدمةً ما تبقى من شباب سورية على قيد الحياة، لخوض آخر حروب تقاسم الهيمنة والنفوذ الاستعماريين في المنطقة والعالم.
لكن، طهران التي ترى في سورية واسطة العقد في الهلال الجيوستراتيجي الذي لا تزال تسهر على بنائه منذ عقود، لاحتواء المشرق العربي وإحكام قبضتها على المنطقة، والضغط على الغرب لانتزاع اعترافه بما تسميه حقوقها القومية المشروعة في التقنية النووية والقيادة الإقليمية، طهران هذه تقتل في المهد، وسوف تقتل كل حركة في اتجاه أي حوار أو تفاهم سوريين يمهدان لخروج البلاد من تحت نفوذها وسيطرتها الكاملة. وقد كانت سورية، بما لا يقاس، الاستثمار الأكبر لطهران في معركة صراعها على النفوذين، الإقليمي والدولي، في العقود الثلاثة الماضية، وثمن التنازل عنها ووقف نزيف الدم فيها لا يمكن أن يكون أقل من تخلي الغرب عن شروطه القاسية في الملف النووي الإيراني، وتسليم العرب لها بالدور القيادي الإقليمي.
سورية رهينة ثمينة في يد طهران، والسوريون العلويون رهينة أثمن في يد نظام الأسد المافيوزي، وكلاهما أداة في خدمة رئاسة بشار التي تضمن وحدها، في نظر طهران، "حقوق" إيران، أي قدرتها على الاستمرار في ممارسة سياسة الضغط والابتزاز للمنطقة والعالم. ولا يعني موت الرهينتين شيئاً كبيراً لقادة الجمهورية الإسلامية الذين استخدموا أطفال إيران وسائل لتفجير حقول الألغام التي زرعها صدام حسين في الحرب العراقية الإيرانية في التسعينيات. بالعكس، إن هذا الموت يمكن أن يوجه رسالة أساسية يعتقد قادة إيران من القوميين الدينيين المتشددين أن من المهم إرسالها إلى القريب والبعيد، وخصوصاً للإيرانيين أنفسهم، ولأهل الإقليم، وللغرب الرافض الاعتراف بمطامحهم، عن تصميمهم الأسطوري واستعدادهم للذهاب إلى الخيارات القصوى، لإنقاذ نظامٍ مدان، غارق في الوحول والدماء، ولم تعد لديه خيارات سوى الانتصار أو الانتحار.
بعد ضياع طويل، واكتشاف السوريين من علويي الموالاة إلى أي حد لا يعني مصيرُهم أحداً، لا طهران ولا الأسد الذي لم يعد، هو نفسه، ولي أمر نفسه والمتحكم بمصيره. حان الوقت كي تأخذ النخبة السورية العلوية الصامتة دورها، وتتحمل مسؤوليتها في المشاركة في إنقاذ سورية، وتقريب ساعة الحقيقة والخلاص من نظام المافيا التي لا تعرف ديناً ولا مذهباً ولا ملةً ولا وطناً غير عبادة السلطة وجمع المال، على حساب كل المبادئ والقيم والتطلعات السياسية والإنسانية لسورية وجميع السوريين من دون تمييز.