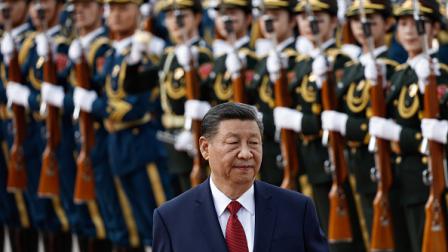ثمّة سؤال جدليّ وشائك يواجهنا اليوم، قبل الكتابة عن النكبة، وبعد 69 عامًا من التذكّر والنسيان؛ وهو كيف نستحضر هذا الحدث المؤسس، عميق الأثر والألم في التاريخ الفلسطيني، بعد كلّ تلك السنين وتقلّباتها؟ كيف نتذكره نحن أبناء الجيل الثالث (والرابع ربّما)؛ من أبصرنا النور على مشروع "وطني" جديد، بدأ بعد أوسلو، وأخذ يتجذّر وينتج سياقًا سياسيًّا واجتماعيًّا مختلفًا؛ سياق امتدّ ليمسّ عمليّة التذكر نفسها أيضًا. يبدو السؤال صعبًا بالنسبة لنا، لكنه يبدو أكثر صعوبة بالنسبة لجيل النكبة الأوّل؛ بعد 69 عامًا من الخيبات والآمال، النكسات و"الانتصارات"، الوفاء والتواطئ، المنافي والحنين، السلام والحرب، "التحرير" و"الدولة". وما بين السياسي والاجتماعي؛ تبدو كتابة التاريخ الشفوي للنكبة اليوم أكثر حساسية وتفرّدًا عن أي وقت مضى.
في كل الأحوال؛ تسعى هذه المقالة إلى كتابة تاريخ شفوي لقرية قالونيا المهجّرة، جارةِ دير ياسين والقسطل، من خلال تجربة أبو سليمان (محمد سليمان عثمان) وهو من مواليد عام 1931، وزوجته أم سليمان، التي لم ترغب بنشر اسمها، وهي من مواليد عام 1936. ما يميّز الشّخصين المذكورين، على الرغم من مشاكل السمع لدى الحاجة أم سليمان، هو أنّهما أكبر من تبقى من قرية قالونيا داخل فلسطين (ثمّة شخص في الخارج يفوقهما عمراً)، وهم ضمن فئة قليلة تبقّت من مخيم عسكر القديم من هذا الجيل، ربّما لا تتجاوز الخمسة أفراد، حسب شهادتهما.
جدير أن أشير إلى كلا الراويين كانا يتذكران الأحداث جيّداً، ويتذكران التواريخ والأسماء والمناطق، غير أن روايتيهما للأحداث كانت عفويّة وغير خاضعة لتسلسل منطقي أو زماني. وعلى أيّة حال، فإن هذه الورقة هل محاولة للإضاءة على فترات النكبة الثلاث: فلسطين التاريخية، والهجرة، واللجوء، من خلال روايات المبحوثين، وقد آثرت عرضها على شكل شذرات Fragments، تماماً مثل أسلوب روايتهما للأحداث.
النكبة: معنى الخسارة
السؤال الذي يُطرح عادة لدى إجراء مقابلة تاريخ شفوي يكون مفتوحًا؛ هو سؤال عن التجربة الشخصية بشكل عام، ومحاولة لاختبار الذاكرة؛ إلى أين تعود؟ ومن أي نقطة في الماضي الزاخر بالأحداث تنطلق؟ غير أنّ أيًّا من الإجابتين لم يبدأ بمرحلة الهجرة، بل إن كلا الراويين استعاد اللحظات الأخيرة لما قبل اللجوء. ورغم حديثهما بضمير الجمع، "نحن"، في معظم فترات السرد، فإن بداية الحديث كانت منبثقة من تجربة شخصية، وكأن ما يُستشعر من كلامهما هو أن النكبة كانت خسارة ذاتية لهما على وجه الخصوص، قبل أن تتجسّد في الوعي صورةً للخسارة الوطنية الجامعة. رغم ذلك، تظلّ هذه التجربة الشخصية المميزة، رغم خصوصيّتها الشديدة، تحمل رموزاً ودلالات تحيل إلى الخسارة الكلّية، بل يمكن القول إن تلك الخصوصية، على شدّة اختزالها، هي ما تعطي معنىً مميزاً وعميقاً لفداحة الفقد الذي ذاقه شعب منكوب بأكمله: فقد الرزق والمسكن، وفقد البلاد.
أبو سليمان، الذي أمضى طفولته كلّها يرعى أبقار والده ويتاجر بحليبها، بدا وكأنه يسرد حكاية النكبة من البلاد إلى اللجوء من خلال تلك الأبقار، بعفويّة تامّة ودون تكلّف، دون أن ينتبه إلى أن بعض التفاصيل يمكن إسقاطها على التاريخ الاجتماعي لتلك الحقبة. يشرح في البداية كيف أقنع أحدُ التجار اليهود والدَه بأن يبيع بقراته الخمس، وأن من الأفضل له أن يكسب بعض القروش الآن ثمنًا لها (بلاش تروح عليه). كان ذلك اليهودي يشير، بشكل مباشر، إلى عملية تهجير محتملة، ويستثمر مشاعر القلق السائدة بعد تواتر الأخبار عن عمليّات تهجير أخرى جرت في مناطق مختلفة، من ضمنها القرية المجاورة، دير ياسين.
يعتقد أبو سليمان أن ذلك التاجر اليهودي لم يكن إلا وكيلًا لأبو روزا، الرجلِ اليهودي الذي أوقف أبو سليمان مرة وهو في طريقه لبيع الحليب عند باب الخليل في القدس، وعرض عليه شراء البضاعة كاملة منه، واختصار هذه المسافة الطويلة التي يقطعها. كان أبو روزا هذا، بحسب الرواية، يهوديًّا فلسطينيًاً من أبناء المنطقة، وكان يمثّل دور "الرّجل الجيّد" بين مجموعة من الجيران اليهود السيئين، وعادةً ما يتكفّل بمنع وقوع صدامات بينهم وبين المستوطنين القادمين من الخارج. ظلّ أبو روزا يشتري الحليب من العائلة حتّى الأيام الأخيرة التي سبقت الهجرة. يقول أبو سليمان إن أبو روزا علّمهم رمزًا سرّيًّأ بالعبرية؛ كلّ صباح حينما يحضرون إليه الحليب كان يطلّ ببندقيّته من الشباك وينادي: "مي شام" (من هنا)، فيجيبون "خيفري"، أي (أصدقاء). لكن في أحد أيام حرب النكبة، جاؤوا إليه بالبضاعة، فلم يطلّ عليهم أحد، وتحت أضواء الكشافات التي سُلّطت عليهم فجأة، كادوا أن يقتلوا أمام بيت تاجر الحليب. حينها طلب أبو روزا من أبو سليمان عدم العودة مجددًا، وقال له: "إذا قتلوك شو بدو يقنع أهلك انو مليش خص". كانت تلك آخر مهمّة إيصال حليب يقوم بها أبو سليمان، وبعد هذه الحادثة تماماً، جاء إليهم الرجل اليهودي طالباً شراء البقرات. باع سليمان (والد أبو سليمان) بقراته "للتاجر اليهودي" بأقل من سعرها الحقيقي، واحتفظ له ببقرة واحدة، "لأن العيال تعودوا على الحليب". باعوا البقرات وقرروا الهجرة. أما أبو روزا، فلم يعد بحاجة لشراء الحليب بعد اليوم؛ كلّ البقرات (إلّا واحدة) أصبحت لديه الآن. يمكن القول إن هجرة القرية كانت تمثّل "لرجل العصابات" ذاك، كما يصفه أبو سليمان، مصلحةً مادّية قبل كل شيء. يتذكر الأخير كيف أن بقرتهم التي شحنوها من قالونيا إلى نابلس سُرقت بعد فترة قصيرة من الهجرة، وهكذا، لم يبق لهم شيء من أثر البلاد.
"الحكاية" الثانية التي يسردها أبو سليمان، بعد هذه الأولى مباشرة، تحمل الإجابة على الطرح ذاته: ماذا مثّلت النكبة من خسارة؟ والرّبط بين هاتين الحكايتين، ولو كان بشكل لا واعٍ، يحمل دلالة ما. يروي أبو سليمان كيف أخذته أمه معها إلى يافا ليبيعا محصول الخوخ في حسبة المدينة، كانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها يافا: "شو كانت يافا، عروس.. عروس فلسطين، كانت الدنيا رمضان، وهالمطاعم فاردة الطاولات وناشرة الأباريق"؛ يستطرد أبو سليمان في لحظة حنين. باتا تلك الليلة في يافا، وفي اليوم التالي باعا الخوخ لرجل من أهل المدينة، وأخبرهما ألا يبيعا الخوح إلا عنده في العام القادم، وهو ما لم يحدث، يقول أبو سليمان مع ضحكة مجبولة بالحسرة: "في السنة الجاي راحت البلاد وراح الخوخ".
أما أم سليمان، التي كانت في سن الثانية عشرة حينها، فمن اللافت استهلالها السردَ بالحديث عن زواجها. قصتها تحمل خسارة من نوع خاص جداً، فأهلها زوّروا ميلادها بعد أن سجّلوا اسمها في شهادة ميلاد أختها التي توفّيت قبل سنتين، تقول: "عمّي وخالي من هبلهم وفصاحتهم كبروني سنتين، وهالاشي كان بيأثر على تعليمي وعلى وظيفتي". خُطبت أم سليمان وهي في سن الثانية عشرة (الرابعة عشرة بعد التزوير) أيام البلاد. قد يبدو هذا الأمر شخصيّاً للغاية في البداية، لكن عند سؤالها عنه مجدّداً في نهاية المقابلة، اتّضح أن له علاقة مباشرة بالنكبة.
أخبار الاغتصاب التي كانت تتوارد إلى المسامع، لا سيما في دير ياسين، دفعت الناس إلى أن يزوجوا بناتهم بسرعة. تقول أم سليمان: "كان الناس يقولو تروح لابن دينها ولا تروح اليهودي". ما اتّضح في نهاية المقابلة هو أن عملية التزوير كانت مدفوعة بمشاعر الخوف تلك، والتي ظلّت سائدة بعد النكبة. حينها أصبح عمر أم سليمان 15 عاماً، ورغم ذلك؛ كان السن القانوني للزواج لا يزال 18 عاماً. تتذكر أم سليمان كيف نظر إليها قاضي المحكمة، ثم أدار نظره لخالها قائلا: "صغيرة"، وكيف قدّم خالها "برطيلاً" قدره خمسة ليرات للقاضي قائلًا له: "مشيها".
كانت أم سليمان، وقد قطعت 81 حولًا من عمرها الآن، تروي الأحداث بنبرة طفولية، وكثيرًا ما كانت تجيب على الأسئلة التي تتطلب تفسيراً أو موقفاً شخصيّاً بالقول: "كنت طفلة بفهمش إشي". كأنها كانت وهي تستعيد ذكريات قالونيا؛ تستعيد طفولة ما فقدتها. تروي، مثلاً، قصة خطوبتها مستعيدة ذكرى الثوب الأول الذي اشترته لها أمها: "النسوان عنا كانو يلبسو ثوب طول اليوم، أما البنات الصغار يلبسو فساتين.. خالتي قالت لإمي بنتك صارت كبيرة هسا لازم تلبسيها ثوب". كان عمرها آنذاك 11 عاماً، لبست الثوب وراحت تلعب فيه، وحينما رأتها أمها ضربتها، مشت في الطريق باكية، وهناك قابلت حماتها (المستقبلية)، أمسكت بيديها وقالت: "شعرك اشقر وحلو، وايديكي كبار بنفعن لخبز الطابون". هكذا؛ في اليوم الذي لم تعد فيه أم سليمان طفلة، وصارت عروساً محتملة، كانت قد وسّخت ثوبها الأول وهي تلعب.
الظاهر للوهلة الأولى هو أن أم سليمان كانت تتحدث عن فقد معنوي، بينما يتحدّث أبو سليمان عن ثروة ملموسة: "البقرات، الخوخ". لكن في الواقع، لا يمكن القول إنه كان ينظر إلى أشياء كتلك بمادّية مطلقة، قد يكون عفويّاً حينما يقول: "راحت البلاد وراح الخوخ"، لكنّ رمزيّة ذلك هو أن قالونيا كانت خوخاً وبرقوقاً ومشمشاً وماشية، تلك هي "البلاد" التي نكبت، وتلك هي الخسارات التي لا تقدّر بثمن.