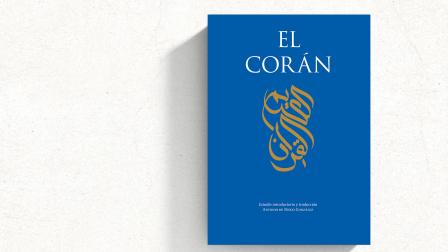ليست هذه المرة الأولى التي يُمنح فيها المترجم خالد المطاوع جائزة أو تكريماً على مسيرته. قبل أن يحصل على "منحة العباقرة" التي منحته إياها، أخيراً، "مؤسسة ماك آرثر"؛ كان الشاعر الليبي المقيم في أميركا قد حاز ست جوائز أخرى في حقلَي الترجمة والأدب.
على أي حال، فإن العودة إلى الجوائز والمنح، هنا، ليست غاية في حد ذاتها، بل باب يقود إلى عالم صاحب "خسوف الإسماعيلية" (2005) و"فلك الأصداء" (2010)، وإلى إعادة قراءة إنتاجه وأثره في ترجمة الشعر العربي إلى الإنجليزية، هو الذي قدّم شعراء مثل أدونيس وفاضل العزاوي وهاتف الجنابي وإيمان مرسال إلى القارئ الغربي، الأميركي بشكل خاص.
يصف المطاوع تسميته كأحد حائزي "منحة العباقرة" بالمفاجئة. "لم أتوقعها، خصوصاً وأنها منحة لا نسعى إليها، بل نُرشّح سرّاً للحصول عليها. الحقيقة أنني ما زلتُ مذهولاً بهذا التكريم حتى الآن، لا سيما وأنه قد سبق أن حصل عليه أدباء وشعراء كبار منحوني الكثير".
وتقضي المنحة، أو الزمالة التي تقدمها المؤسسة الأميركية لواحد وعشرين شخصاً من المبدعين في مجالات متعددة، بحصول المطاوع على مبلغ 625 ألف دولار أميركي، يتلقاها على مدار السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشاريعه الثقافية.
المطاوع، كما يقول، لديه كثير من هذه المشاريع. "لدي ما يكفيني لسنين طويلة. هناك دائماً أفكارٌ جديدة". لكنه يشير، في المقابل، إلى أن المشاريع المقبلة لن تتضمّن كثيراً من الترجمة: "رغم أن الترجمة كان لها دور كبير في هذا التكريم، إلا أنها أخذت من وقتي الكثير على حساب كتابة الشعر والنثر وحتى النقد".
الاهتمام بتجربة المطاوع (1964) يجيء غالباً من المؤسسات الغربية. وهذا لم يعد جديداً، في حالته وحال كثير من الشعراء والمترجمين، إذ لا يوجد الكثير من منح الزمالة في البلاد العربية، وغالباً ما لا تلتفت المؤسسات الكبرى إلى جهود المترجم إلاّ حين يصل إلى الشيخوخة.
هنا، يشير المطاوع إلى أن "هناك كثيرين يعملون أكثر مني وبفعالية وهمّة أكبر، ولديهم مواهب إدارية وفنية تفوقني، ولم يحصلوا على أي جوائز تكافئ تلك الجهود. قد نقول إن هذا هو حال المنطقة العربية عامةً".
الحديث عن وضع المنطقة يقود بالضرورة إلى حديث عن بلده، ليبيا. يقول: "ليس هذا الوقت المناسب للتفكير في حال الأدب والجوائز في ليبيا. كل ما نفكر به ونريده، في هذا الوقت، حينما نفكر في ليبيا، هو الأمان وحرية العمل. أتمنى أن يستغل المثقفون والمثقفات في المناطق الليبية الآمنة الوقت للقيام ببعض النشاطات الثقافية. أنا متأكد أن هذا يبعث الأمل في تلك المناطق، لأن العمل الثقافي مبني أساساً على التسامح واحترام الاختلاف ونبذ العنف. لا بد أن تبقى شعلة هذه القيم متّقدة، ومن استطاع القيام بذلك فهو يعيد الحياة إلينا جميعاً".
الشاعر الذي يمكن وصف علاقته بلغته الأم بالملتبسة، له مجموعتان شعريتان غير منقولتين إلى العربية بعد، هما "أموريسكو" (2008)، و"تاكوفيل" (2010). يتحدث عن ذلك بالقول: "كوني شاعراً لا يحظى بالاهتمام في بلادنا، فأنا واحدٌ من كُثر. الشعر الجاد والجيد الذي عادة ما يقدّم نظرةً مختلفةً ومنفردةً حول الحياة، يبقى غالباً على الهامش، حتى في الدول المتقدمة. وليس مستغرباً إذاً أن يُوضع الشعراء الجادون على الهامش في مجتمعاتنا، التي باتت تصارع تخلّفها وأعداءها بنبذ الاختلاف وفرض النمطية في كل شيء. علاقتي باللغة العربية توطّدت في السنوات الأخيرة، إذ بدأتُ أكتب بعض المقالات، كما ترجمتُ إليها بعض الشعر الإنجليزي، لكن لغة الكتابة بالنسبة لي ما زالت الإنجليزية".
تعيش ليبيا، وكذلك العالم العربي، أزمة ثقافية كبرى، أدت إلى صعود تيارات متطرفة، في وقت أرادت فيه الشعوب التخلص من الدكتاتورية والطغيان. كيف يمكننا التعاطي فكريّاً مع هذا الصعود؟ وهل بمقدور الثقافة أن تفعل شيئاً في هذه اللحظة؟
يجيب المطاوع: "لا شك أن الثقافة التي تنمّي حساسية الفرد تجاه الآخرين واحترامهم، وتنمّي ثقة الإنسان بحقه في الانفراد، والمرأة بحقها في العمل والحركة والكسب؛ مهمة جدّاً. لكن هذا لم يكن، بالطبع، جزءاً من ثقافة ليبيا في الأساس، وكذلك الحال في كثير من الدول العربية، لأسباب عدة، منها افتقارنا لثقافة الديمقراطية والتعدّدية. أغلبنا ما زال قبليّاً أو طائفيّاً. لسنا مواطني دولة. القذافي زاد من حدة هذا التوجّه، وعندما انهار نظامه، رجعت الانقسامات والمنازعات التي كانت تجري قبل قرنٍ، يؤجّجها في بعض الأحيان أشخاص متعلمون وأصحاب شهادات عليا. هذا يعني أن التعليم لم يزرع إحساساً بالمصلحة العامة والكبرى التي هي أساس المواطنة. أضف إلى ذلك أن دولنا ومجتمعاتنا شبه مستعمَرة؛ إذ أن هناك استعماراً عنيفاً ودائماً في المنطقة هو الاستعمار الإسرائيلي، أضف إلى ذلك الرغبة الغربية المستمرّة في الهيمنة على مصادر النفط. هذه الظروف هي عوامل الاحتقان وعدم الاستقرار الدائمة في المنطقة".
وفي ما يخص التطرف الذي باتت تعرفه المنطقة في الآونة الأخيرة، يقول: "أظن أنّ هناك وعياً لدى مجتمعاتنا، فالتقوقع العنيف أصبح لا يطاق. المتطرفون باتوا يقتلون غيرهم من المسلمين، وأباحوا قتل كل من يختلف معهم، حتى في الشكليّات. المشكلة هي طبعاً في ما نسمّيه بالتعليم الديني المتنوّر، وهذا شبه مفقود. الحقيقة أننا لا نعرف ما سيكون محتوى هذا التعليم، لأن هذا سيجبرنا أن نعود ونفكّر في مقاصد الدين والشرع. عندما كنت صبيّاً، كانت مقاصد الدين تتمثل في أن يكون الفرد صاحب ضمير، مهتمّاً بالضعيف والفقير، وأن التقوى أمرٌ شخصيّ مبني على أساس "لا ضرر ولا ضِرار". أما الآن، فقد أصبحت التقوى شاغلة كل الناس. أصبحت نظرتنا، وحتى تطبيقنا للدين، يفتقدان الرحمة والتسامح ويشوبهما إصرار على النمطية وكراهية كل أوجه التنوّع".
رغم ذلك، يرى المطاوع أن "في إمكان الثقافة الجيدة ضخّ القيم الإيجابية الموجودة في الدين أساساً، وكذلك منح المسلمين الشعور بأنهم جزء من الإنسانية، لا أقل ولا أكثر. الآداب والفنون المتينة، القديم منها والجديد، تساعد في التقليل من الانفصام الثقافي الذي نشعر به في منطقتنا. الحوار هو ليس نبذ التطرف فقط، بل أن نتحدّث عن المبادئ الإنسانية العميقة في تراثنا، التي تربطنا بباقي البشر المسالمين في العالم، والتعرّف إلى تطلعاتهم التي لا شك أنها تتقارب مع آمالنا وتطلعاتنا".