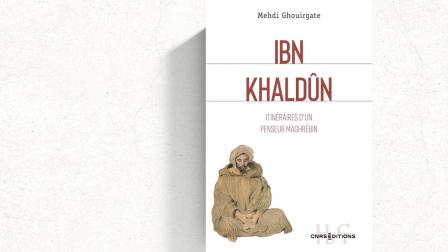اعتُبر تحديث الخطاب الفلسفي العربي من أولويات الفكر النهضوي ورهاناته الرئيسة، فقد نُظر إليه كشرطٍ لتحرير العقل/الكلمة من رواسب الوهم والزيف. فارتبط التحديث وقتها بالترجمة والتعريب، وهو ما اقتضى من رُوّاده التبحر من جهةٍ في أمهات النصوص الفلسفية التراثية، واستيعاب مسائلها ومرجعياتها الإغريقية، ومن جهةٍ ثانية التمكن من آليات التوليد المعجمي وقواعده.
وقد أتيح للمفكر الشامي جميل صليبا (1902-1976) التصدي لهذه المهمة المزدوجة لنشر خطابٍ فلسفي معاصر، يستسيغه الجمهور، ضمن المشروع المزدوج: عصرنة الفلسفة ونشرها بلغة الضاد، مع مراعاة سلامة البناء ووضوح عبارته. وقد مكنه اطلاعه الواسع على نصوص الفلسفة الغربية الكلاسيكية، وكذلك تبحره في قواعد العربية، بحكم مساهماته في أعمال "مجمع اللغة العربية" بدمشق، من إنجاز أول معجم فلسفي حديث تضمَّن أهم التعريفات والحدود، رفعاً لأحد أكبر تحديات الاصطلاح العربي: توحيد المصطلح الفلسفي في أقطار الوطن العربي الخارجة للتو من نير الاستعمار، وإشاعة المعارف الذهنية في الأوساط الجامعية، مع التمسّك بمبدأ التنصيص على إسهام الفلاسفة العرب والمسلمين في تطوير تاريخ العلوم، لا سيما أنَّ الاستشراق الأوروبي قد غَمط هؤلاء الفلاسفة حقهم، وقصر دورهم على مجرد النقل والتكرار للمقولات اليونانية.
وهكذا، اندرجت آثار صليبا ضمن مجهودات تطوير التعريب، بفضل أعمال "المجمع العلمي"، وقد انتخب لعضويته سنة 1942، وأعمال "دار المعلمين العليا" التي ترأسها، فضلاً عن إصلاحاته لـ"لجنة التربية والتعليم" في وزارة المعارف، وإصدار العديد من النشريات التربوية مثل "المعلّم العربي"، ومشاركاته في لجان ومؤتمرات عربية ودولية.
ولم يحد خلال هذه الواجهات العديدة عن التزامه بقضية التعريب واجباً معرفياً، اعتمده بشكلٍ خاص في تأليفه: "المعجم الفلسفي"، الواقع في جزأين (دار الكتاب اللبناني، 1971). وفيه استنَّ أربع قواعد متكاملة لتجسيد هذا الالتزام: أولاها العودة إلى "الكتب والمعاجم القديمة للبحث عن اصطلاح مستعمل للدلالة على المعنى المراد ترجمته"، وهي قاعدة تقوم على إرادةٍ منه ثابتة في تأصيل المفردات، واستمدادها من نصوص التراث العربي-الإسلامي، لا سيّما إذا كان المفهوم وارداً في نصوصه، مستخدماً في فضائه المعرفي.
وتتمثل القاعدة الثانية في توسيع معنى لفظ فلسفيٍّ قديم "حتى يشمل المعنى الجديد ويدل عليه"، بعد إجراء تحوير خفيف في دلالته. وتتصل القاعدة الموالية - وهي الأهم لوثيق علاقتها بالتوليد الاصطلاحي - بالبحث عن "لفظٍ جديد لمعنى جديد مع مراعاة قواعد الاشتقاق العربي"، لما يوفره من إمكانات تصورية في تنويع المعاني وتفريعها بالاعتماد على نفس المادة. وأما القاعدة الأخيرة، ونظّنه أقرَّها على مضضٍ ولم يطبقها إلا استثناءً، فهي التعريب أي: "اقتباس اللفظ الأجنبي بحروفه على أن يصاغ صياغة عربية".
وقد التزم جميل صليبا بهذه القواعد والوسائل التوليديّة في تسمية المفاهيم الفلسفية، ومن خلالها تصدّى إلى متنٍ مزدوج، قوامه من جهة أولى المعاجم العربية القديمة، ومن أشهرها موسوعة محمد علي التهانوي (ت. 1745)، "كشف اصطلاح الفنون"، و"كتاب التعريفات"، للشريف علي الجُرجاني (1339-1413)، وقاموس "الكليات" لأبي البقاء الكفوي (ت. 1683). وقد تبحّر فيها وأعاد صياغة ما ورد في مكامنها من التصورات التي تتصل بتساؤلات الفلسفة الحديثة، مُبعداً ما تجاوزه النظام المعرفي المعاصر.
ويبدو أنَّ صاحب "المعجم الفلسفي" تساهل في إيراد بعض المفهومات، وتوسّع في ذكر مسائل أعلق منها بالأخلاق واللاهوت من الفلسفة، ولا يمكن أن تدخل في نطاق المباحث العقلية المحضة، إلا بتسامحٍ كبير، كما زجَّ ببعض المفاهيم التي لا صلة مباشرة لها بالقول الفلسفي مثل مداخل: "زواج"، "زي"، "ذهول" "خسران"... كما لم يتناولها من زوايا إشكالية أو نقدية، بل إنَّ قلمه، وفي غير ما مناسبة، يختط عباراتٍ معيارية وترتسم فيها آثار الذاتية.
واعتمد صاحب "مستقبل التربية في العالم العربي" الكتابات الفرنسية والإنكليزية مصدراً ثانياً، بحكم تضلّعه من هذين اللسانين، وإنجازه أطروحة الدكتوراه بـ"جامعة السوربون" سنة 1927، فقد استفاد حينها من الثروات المعرفية التي توفرها المعاجم والموسوعات الكبرى في الغرب، مثل أعمال آن-ماري غواشون (1894-1977)، ولويس ماسينيون (1883-1962) ووظفها جميعاً لإثراء المعجم الفلسفي العربي. فكان من مزايا هذا العمل ذكرُه المقابلات الفرنسية والإنكليزية واللاتينية، وتخصيص ملاحق اصطلاحية كاملة لها، مما يضفي عليه قيمة أخرى، تتجلى في جهوده لتبيئة الكلمات الأجنبية، ونقلها إلى اللسان العربي، بعد أن لم تَكن فيه. وكل مفهوم جديد هو رؤية تطوِّر اللغة وتفتح أفق الذهن.
وأما منهجه في التعريف فتوليفٌ لطيفٌ بين الشرح اللغوي والفنِّي، فيذكر الدلالةَ الأصلية للكلمة، ثم يردفه بالتعريف التراثي الذي اقترحه فلاسفة الإسلام ومعجميوه. وقد يذكر مختلف الدلالات الاصطلاحية التي أخذها اللفظ في مجالات المعرفة، لينتهي إلى تقديم فحواه في الفلسفة الغربية المعاصرة. وقد سعى صليبا، بهذا المنهج المتوازن، إلى تقديم ما يشبه السياق الكامل للمفهوم الذي يتقصاه، ويتعقب اتساعه في سائر حقول المعرفة، نظراً إلى شمول الفلسفة - بمعناها الكلاسيكي - مجالات خرجت اليوم من دائرة سلطانها: مثل الموسيقى والهندسة والمنطق... وغالباً، ما كان يحلل الطبقات والفروقات الدلالية حسب الاختصاص، فوردت تعاريفُه، كما يقول القدماء، جامعةً مانعةً. وقد يكون هذا هو مكمن العلّة فيها، فما ينقصها هو البعد الإشكالي الذي يجعل من كل حدٍ، لا مفهوماً واضحاً، فهذه مهمة المعاجم العامة، بل مدخلاً إشكالياً ونقدياً، يُبرز مواطن الإشكال، ويضع اليد على مظان الشبهة.
ومن مكامن العلّة أيضاً أن اقتصر هذا القاموس على المتن الفلسفي العربي-الإسلامي القديم، وعلى نصوص الفلسفة الإغريقية والأوروبية التي سبقت الحداثة بعقودٍ. فأغلب مفاهيمه مأخوذة من ذاكرة الخطاب الفلسفي، مثل البرهان، والسفسطة والخطابة...، مع إغفال كبير لمئات المصطلحات التي عمرت بها الكتب الحديثة، وهي ناشئة عن امتزاج الفلسفة بالعلوم الإنسانية كاللسانيات والأنثروبولوجيا والسيميائيات وعلوم تحليل الخطاب. وهو ما يطرح على الباحثين مهمّتيْن عاجلتيْن: إنجاز معجم للفلسفة جديدٍ، يأخذ بعين الاعتبار مقولات ما بعد الحداثة، والتمييز بين المفاهيم التراثية، ومجالها معجم تاريخي للفلسفة، والمفاهيم الراهنة التي لا تنفك عن الظهور. وهو ما يقتضي وضع آلية لتحيين التعريفات وتوحيدها، بعد التوافق على أدوات واضحة لانتقاء المصطلحات وتحديد المعايير التي تجعل من مفردة ما مصطلحاً.
على أن ما يشدّ قارئ اليوم، في تجربة جميل صليبا، الذي مرت ذكرى وفاته الـ41 يوم أمس، (12 أكتوبر/ تشرين الأول)، هو ضرورة تحديد "عقد معرفي" بين مجامع اللغة العربية المعاصرة - وقد تكاثرت وتشتتت مجهوداتها بسبب صراعات السياسة - مع السلك الفلسفي، بأساتذته ومفكّريه، من أجل الوصول إلى "عقد اجتماعي" يصبح فيه للخطاب الفلسفي حق المواطنة، كاملةً، ضمن جمهوريات التطرف والالتباس.