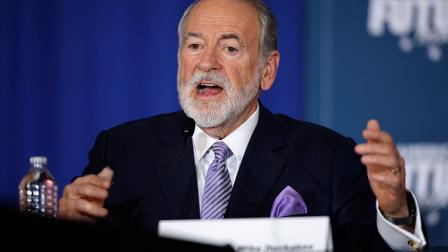ما إن انطلقت حكومة هشام المشيشي التونسية في عملها، حتى فاجأتها العملية الإرهابية بمدينة سوسة، وأسفرت عن سقوط ضحية من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح بالغة. لكن على الرغم من خطورة هذه العملية، يوجد احتمال كبير لأن تتمكّن الحكومة الجديدة من العمل في ظروف سياسية أفضل، ولن تتأثر كثيراً بعودة نشاط الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات المتشددة؛ سواء أكان ولاؤها لتنظيم "القاعدة" أم تنظيم "داعش" الذي تبنى العملية. تستند هذه الفرضية إلى عاملين، إذ من جهة، الخبرة التي امتلكتها الأجهزة الأمنية جعلتها جاهزة للردّ والقضاء على هذه الخلية خلال وقت قياسي، حيث قُتل "الإرهابيون" الثلاثة بعد مطاردتهم ومحاصرتهم في مدرسة احتموا بها، كما ألقي القبض على بقية العناصر التي تنتمي إلى المجموعة المهاجمة، والذين لعبوا أدواراً متفاوتة في الإعداد وتوفير الدعم والإسناد للعناصر المنفذة للجريمة. تضاف إلى ذلك العمليات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وهو ما جعلها تجهض عمليات عديدة تمّ التخطيط لها من قبل هذه الجماعات. لكن عملية سوسة تؤشر إلى أنّ خطر الإرهاب لا يزال يطرق بعنف أسوار تونس، وهو ما يفرض على حكومة المشيشي أعباء إضافية أمنية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الصحية بعد الموجة الثانية من جائحة كورونا.
أمّا العامل الثاني الذي يبرر القول إنّ حكومة المشيشي ستعمل في مناخ أفضل، مقارنةً بالحكومات السابقة، فهو أنّ كل الأحزاب تقريباً، بما في ذلك الأحزاب الكبرى، قبلت إلى حدّ الآن بأن تواصل نشاطها تحت سقف حكومة كفاءات. هذا يعني أنها "استسلمت للأمر الواقع" و"قبلت" بأن تبقى كأحزاب بعيدة عن السلطة التنفيذية، على الرغم من مشاركتها في الانتخابات، وحصولها على عدد متفاوت من مقاعد البرلمان.
يُستبعد الضغط على المشيشي لتغيير بعض الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية
لا يعني ذلك أنّ جميع الأحزاب قبلت بإخراجها من دائرة الحكم من خلال عدم استناد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى نتائج الانتخابات التشريعية، وإنما سعت بعض الأطراف نحو تشكيل تحالف برلماني قادته أحزاب رئيسية هي حركة "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة". وقد وفر هذا الائتلاف فرصة لتمرير حكومة المشيشي عند التصويت عليها. كما أنّ هذه الأطراف تنوي التعاون مع هذه الحكومة وتقديم الدعم لها حتى تحافظ على استقرارها، وتوفر لها الحزام السياسي الضروري الذي تحتاجه لتمرير مشاريع القوانين التي تنوي عرضها على البرلمان. ويستبعد في هذا السياق الضغط على المشيشي لتغيير بعض الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية.
كما أنّ هذا الائتلاف الذي جمع أطرافاً متناقضة، ينوي أصحابه التنسيق بين مكوناته من أجل تركيز المحكمة الدستورية التي ستصبح المؤسسة الوحيدة التي تتولى تأويل فصول الدستور عند حصول أي خلاف أو تجاوز لأحكامه. بذلك ستتمكن هذه الأحزاب من سحب البساط من تحت رئيس الجمهورية الذي يتولى اليوم بحكم غياب هذه المحكمة، الانفراد بتفسير الدستور وفق قناعاته وقراءته له، وذلك على الرغم من اعتراض الأحزاب والعديد من فقهاء القانون الدستوري على ذلك.
كذلك، فإنّ أطراف هذا الائتلاف ستعمل على تقريب وجهات النظر في ما بينها، من أجل التوصل إلى وضع مشروع قانون جديد للانتخابات. لن يكون ذلك أمراً هيناً، لكن ستقود هذه الخطوة الهامة نحو تغيير الخارطة السياسية المقبلة بعد أن اتضح للجميع أنّ القانون الحالي هو المسؤول بدرجة واسعة عن حالة التشرذم التي يعاني منها البرلمان، من دون أن تتوفر أغلبية مريحة تستطيع أن تحكم من خلال تشكيل حكومات مستقرة وفاعلة. وإذا ما تحقق ذلك، سيتم البناء عليه لإنجاز خطوة أخرى نحو تضييق مجال المناورة أمام رئيس الدولة قيس سعيد، والتقليل من احتمال تدخله في تشكيل الحكومات وتعيين رؤسائها. فالحزب الذي سيفوز مستقبلاً بالمرتبة الأولى في البرلمان ويتمكن من توفير الأغلبية، عليه أن يتحمّل المسؤولية ويتولى إدارة الحكم، وعليه أيضاً أن يتحمّل مسؤولية سياساته واختياراته.
يمكن لهذا الائتلاف الثلاثي أيضاً أن يدفع نحو مناقشة النظام السياسي الحالي، وذلك بعد أن اتسعت رقعة الجدل حول تعدد ثغراته بعد ست سنوات من العمل به. وتعتبر هذه المسألة مصدر خلاف واضحا بين عموم الأحزاب والرئيس قيس سعيد. لهذا، آن الأوان لكي يتعمق النقاش حول هذه القضية المفصلية، وأن يتم حسمها خلال الأشهر المقبلة.
فقد "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب" المبادرة بعد انتقالهما إلى المعارضة
هذا ما يدور في كواليس الأحزاب الثلاثة قبل نهاية العطلة البرلمانية (تنتهي بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل)، في حين فقدت بقية الأحزاب مثل "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب" المبادرة بعد انتقالها إلى المعارضة، على أثر سقوط حكومة إلياس الفخفاخ. ما يخشاه أنصار الحزبين هو التداعيات المحتملة لاستقالة محمد عبو من رئاسة حزبه (التيار الديمقراطي) ومن الحياة السياسية، على الأوضاع الداخلية لـ"التيار الديمقراطي"، وقد تمتد تلك التداعيات لتمسّ أيضاً العلاقة التي توطدت بين الحزبين، فتتفكك بسبب ذلك الكتلة الديمقراطية. هذا الاحتمال من شأنه أن يضعف كثيراً من وزن المعارضة داخل البرلمان، وهو ما يجعل صوت "الحزب الدستوري الحرّ" أعلى خلال المرحلة المقبلة.
المؤكد أنّ حكومة المشيشي قد توفر فرصة نقاهة للأحزاب التونسية، وهي أحزاب مريضة، تعاني من أزمات مختلفة، وتحتاج إلى القيام بمراجعات متنوعة وعميقة حتى تتمكن من إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، وأن تهيئ نفسها لخوض مرحلة صاخبة مليئة بالصعوبات والمخاطر.