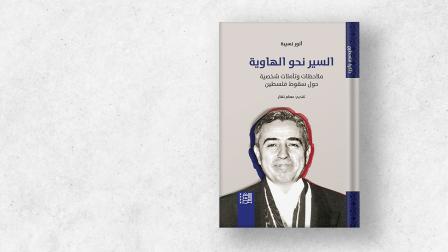تخيلّ أن تحفر قبراً بيديك العاريتين... أن تترك جزءاً من جسدك (ذراعك) لغريب (لاجئ) يرسم عليها وأنت لا تراه... كيف ستتصرّف لو كنت رجلاً وأُعطيت، لنصف ساعة، إمكانية أنْ تتحكّم في تصرّفات امرأة تقف في مكان عام دون أن تراك أو تعرف من أنت؟ أيّةَ أوامر ستعطيها عبر سمّاعة الأذن؟ هذه بعض المواضيع التي تتمحور حولها أعمال ومشاريع الفنّانة اللبنانية تانيا الخوري.
في عملها المُعنوَن "أبعد ما تحملني البصمة"، الذي انطلق عرضه في لندن ثمّ انتقل إلى عدّة مدن قبل أن يحلّ بمدينة نيويورك مؤخّراً، تتناول الخوري (1982) قضية اللجوء التي قاربتها في أعمالها غير ما مرّة. وكما في عروضها السابقة، تأخذ الفنّانة المشارك عبر لعبة الحواس، مركّزةً هذه المرّة على حاستَي اللمس والسمع؛ حيث تحجب النظر عنه بطريقة ما.
إنه عرضٌ فردي يستمرّ لمدة ربع ساعة تقريباً، وقد نفّذت فكرته مع مغنّي الراب وفنّان الغرافيتي الفلسطيني باسل الزراع. وعن ذلك تقول: "دُعيت في لندن إلى إقامة عرض حول موضوع الهجرة. لكنّني قرّرت تطوير الفكرة لتكون عن اللجوء، وأن أذهب أبعد من الحديث عن موجات اللجوء الأخيرة من سورية وغيرها، والتي شغلت الأوروبيين، وذلك بالحديث عن ملايين الفلسطينيّين الذي وُلدوا أباً عن جدّ، ومنذ سبعة عقود، كلاجئين، وما زالوا محرومين من العودة إلى بلادهم".
تضيف: "أعرف باسل الزراع شخصياً حيث انتقل إلى العيش في لندن، وبدأنا المشروع قبل سنتَين، وكان من المفترض أن يُقام لمدّة محدّدة في لندن، لكن صادف أن حصل الفنّان على الجنسية البريطانية، وهو ما ساعدنا على الانتقال بالعرض بين دول عديدة، وقد قُدّم منذ ذلك الوقت في أكثر من ثلاثين مدينة".
تنتمي أعمال الخوري إلى الفنّ التفاعلي أو الحي، وقد حقّقت من خلالها نجاحات محلّية ودولية. إنها أعمال يمكن الاشتراك فيها ولا يمكن، غالباً، اقتناؤها أو جمعها وتكديسها في بيوت الأغنياء أو المتاحف. في هذا السياق، تقول في حديثها إلى "العربي الجديد"، إنها تحرص على أن يكون هناك نتاج يمكن استخدامه للمصلحة العامة من قبل نشطاء أو صحافيّين أو أشخاص عاديين، حتى بعد انتهاء فترة العرض.
تُذكّر عروضها التفاعلية بمسرح الألماني برتولد بريشت الذي اعتبر المشاهد (المشترك) الحلقة الأهمّ في العمل المسرحي، وهو الذي تُكتَب وتُعرض الأعمال من أجله؛ إذ تبني الخوري أعمالها بشكل رئيسي على التفاعل مع الزائر/ المشترك الذي تعطيه قدراً كبيراً من الاستقلال، معتمدةً على تفاعله الفكري والجسدي والعاطفي.
درست الخوري فنون المسرح في "الجامعة اللبنانية" ببيروت، قبل أن تنتقل عام 2005 إلى لندن لدراسة الماجستير ثم الدكتوراه، وتناول موضوع أطروحتها "البعد السياسي لفن العروض التفاعلي".
عن ذلك تقول: "لم أولَد في عائلة مرتبطة بالفن وعوالمه. وأتساءل أحياناً عن السبب وراء ذهابي إلى الجامعة اللبنانية ودراسة المسرح"، ثمّ تُجيب: "أعتقد أنه كان أمراً عفوياً. أؤمن بأن الجمهور يجب أن يكون جزءاً من العرض، ليس فقط في الفن التفاعلي بل حتى عندما درست المسرح. عرضت مشروع التخرُّج، مثلاً، في قاعة كانت أشبه بكنيسة قديمة ودعوت الجمهور إلى أن يكون جزءاً منه، ولم أكن أعرف في حينه أن هناك عالماً كاملاً يُسمّى الفن التفاعلي، وأن هؤلاء الذين يعملون فيه لا يأتون من المسرح فقط، بل من الفنون البصرية أيضاً".
 تضيف المتحدّثة أن العرض لا يمكن أن يستقيم إن لم يكن الجمهور موجوداً، لافتةً إلى أن أحد الأمور التي تحبّها في هذا هو اختلاف كلّ عرضٍ باختلاف المشارك.
تضيف المتحدّثة أن العرض لا يمكن أن يستقيم إن لم يكن الجمهور موجوداً، لافتةً إلى أن أحد الأمور التي تحبّها في هذا هو اختلاف كلّ عرضٍ باختلاف المشارك.
لم تنقطع الخوري عن بيروت بشكل تام عندما عاشت قرابة عقد من السنين في لندن للدراسة والعمل. كانت تعود بشكل دائم للعمل على مشاريع مختلفة من بينها تأسيسها "مجموعة الدكتافون" مع المعمارية والباحثة اللبنانية عبير سقسوق. ولعل أشهر أعمالها من خلال "مجموعة الدكتافون"، وإن لم يكن أولها، "هذا البحر لي" (الفيديو الأول أعلاه).
يقام العرض على قارب صيد في بحر بيروت وتتنقل الخوري مع المشتركين بين محطات مختلفة في البحر والمناطق التي أغلقت أمام اللبنانيين وتمنعهم من الدخول إلى بحرهم وبشكل حر. فالأغنياء وأصحاب النفوذ التهموا بحر بيروت أو حرية الدخول إليه.
تناقش الخوري هنا، كما في أعمالها المتعلقة بـ"مجموعة الدكتافون"، قضايا الحيز العام والتحولات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها لبنان. وتعيد احتلال الأماكن العامة غير المخصصة للعروض الفنية لعمل مشاريعها مما يعطيها أبعاداً جديدة ويجعل الفن أقرب إلى منبعه، أي المجتمع والحيز السياسي والإنساني الذي يتحدث عنه.
ترتكز أعمالها، أحياناً، على فكرة بسيطة، قد تكون سمِعت عنها في نشرة الأخبار أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لتتحوّل بعدها إلى مشروع حمّال لمعانٍ يستغرق العمل عليه أشهراً أو سنوات عدّة.
وفي عملها "حدائق تتكلّم" تُدخل الخوري المُشترِك في العرض إلى سراديب الحرب في سورية وتبعاتها على حياة الناس؛ إذ يتناول العمل عشر قصص لسوريّين قُتلوا مع بداية الانتفاضة ضدّ النظام، واضطرّ أهلهم إلى دفنهم سرّاً في حدائقهم المنزلية أو في حدائق عامّة لأسباب عديدة، من بينها عدم قدرتهم على الوصول إلى المقابر، أو بسبب استهداف وقصف الجنازات من قبل النظام.
قرأت الفنّانة اللبنانية عن الموضوع لأوّل مرّة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلت عن معنى دخول الموت حيّزَ الحياة اليومية أو غيابه عنها، وعن معنى تحوُّل حديقة خاصة أو عامّة إلى مدفن.
تأخذ الخوري نفساً عميقاً قبل أن تشرح: "كلبنانية، عشت طفولتي في الحرب الأهلية، وكنت دائماً أتخيّل أو أشعر بأن التراب الذي نمشي عليه يحمل في طياته قصص المجازر والمعارك التي دارت خلال الحرب، وكأننا نمشي على الجثث. هذا الشعور ينتابني وأنا في الولايات المتّحدة وفي غيرها من البلدان ذات الماضي الاستعماري. في البداية، فكّرتُ أن أجمع قصصاً من جميع بلدان الانتفاضات العربية، ولكن استقرّ الأمر بي في نهاية المطاف على قصص سورية، خصوصاً أنَّ المشروع انطلق من بيروت، حيث أُقيم أوّلُ عرض".
أمّا عرض "حدائق تحكي"، فيعتمد على قصص ومقابلات أجرتها الفنّانة في بيروت ولندن مع سوريّين اضطرّوا إلى ترك بلادهم، إضافةً إلى آخرين داخل سورية أجرت المقابلات معهم للمشروع الناشطةٌ السورية كنانة عيسى، ثم اختارت منها عشراً تمثّل مختلف أطياف الشعب السوري.
في العرض، يرتدي الزائر ملابس بلاستيكية واقية ثم يدخل إلى مكان مظلِم فيه أربعة أطنان من الرمل. يتحسّس طريقه بمساعدة مصباح صغير يساعده على الوصول إلى واحدة من عشر بقع/ قبور مع شواهد. يتعيّن على الزائر حفر القبر بيديه حتّى يعثر على مصدر الصوت؛ وهي مسجّلةٌ تسرد عليه قصّة الضحيّة بأصوات أهله ومعارفه. يستمع الزائر إلى تلك القصص وهو متمدّد في القبر الذي وُضع عليه شاهد يحمل اسم الضحيّة. وبعد الانتهاء، يعيد دفن التسجيل الصوتي تحت التراب، في انتظار الزائر المقبل.
تشير الخوري، الحاصلة على "جائزة المسرح الكلّي للابتكار" و"جائزة آرتشيس" في بريطانيا، إلى أنها اعتمدت في تنفيذ العمل على فكرة راودتها منذ وقت طويل: "طالما كنتُ أتصوّر أنه إن وضعنا أذننا على الأرض، يمكننا أن نستمع إلى قصص المفقودين".