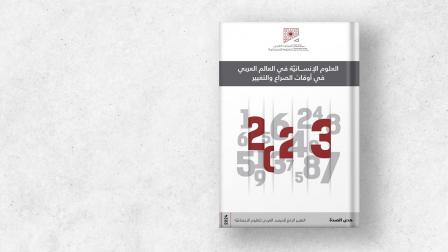يمكننا أن نحب باتريك موديانو أو ألّا نحبه. حول رواياته، ينقسم النقّاد في فرنسا بين "مؤيّد" و"معارض". لكن مهما كانت قيمة هذه الأعمال، يمكننا أن نقول إن موديانو استطاع احتلال موقع مميّز بين أبرز كتّاب الأدب الفرنسي المعاصر، وذلك منذ روايته الأولى "ساحة النجمة" (1968).
روايات عديدة تبعت هذا العمل، وكل واحدة حفرت أكثر فأكثر هواجس رجلٍ وُلد عام 1945، وعاش طفولةً تسلّطت عليها أشباح الاحتلال النازي لوطنه، وكائنات بهويات مزدوجة وحيوات ضبابية، سعى بلا انقطاع إلى إعادة ابتكارها لمواجهة تهديد طالما شعر به وعايشه في عمق كينونته.
في مركز أعماله الروائية، نجد دائماً شخصية رجلٍ يبحث عن ماضٍ مصدَّع، عن معنى، من خلال الكلمات والجُمَل التي يعرف موديانو جيداً كيف يمدّها كشبكة عنكبوتية تلتقط الذكريات والصور الخاطفة والأحاسيس. وبسرعة، تصبح باريس خلال الأربعينيات أو الستينيات من القرن الماضي، الشخصية الثانية لرواياته، التي لن يتوقف عن زيارتها، مفضّلاً الأحياء التي لا هوية محدَّدة لها، أي تلك المناطق الهامشية وغير المركزية، التائهة داخل جغرافيتها المبهمة، حيث تختبئ شخصيات رومانسية وخطيرة، وكمٌّ من الأسرار التي يشعر الكاتب بضرورة اكتشافها.
كل رواية من روايات موديانو الثلاثين تستعيد هذه العناصر وتعيد توزيعها ضمن ترتيبٍ مختلف، مضيفةً عليها تنويعات وتوابل جديدة لإرضاء رغبات الكاتب الذي أقرّ في أحد الحوارات التي اُجريت معه أخيراً، أنه يبقى، بعد انتهائه من كل عمل، غير راضٍ عن نفسه وعن النتيجة. كما لو أن كل رواية من رواياته ترفضه، تلفظه، وتلومه على فشله في مهمة استعادة الماضي، من أجل نسيانه، وبالتالي تجاوزه. ولعل هذا بالتحديد ما يشكّل أحد أبرز محرّكات موديانو الكتابية: أن لا ينجح فقط في التذكّر، بل أن يتمكن أيضاً، في عملية تذكّره، من تسمية هذا الماضي وتفكيكه للتخلّص منه، وإلا لبقي يحلّق كطيفٍ أسود ومميت فوق حياته.
ولفهم هذا الرهان، لا بد من استحضار طفولة الكاتب التي أمضاها في منزلٍ يقع في إحدى ضواحي باريس حيث اختلط بكائنات مشبوهة، واختبر انعدام الأمان لأن أمّه الممثّلة كانت تتركه مراراً في منزل إحدى صديقاتها، للتفرّغ لفنّها وحياتها.
وحول علاقة هذه المرحلة من حياته بكتاباته، يقول: "الأسئلة التي كنتُ أطرحها على نفسي حول والدَيّ وسلوكهما الغريب، حول الأشخاص المريبين الذين كانوا يحيطون بهما، وحول فترة الاحتلال النازي لبلدي التي لم أعشها، لكنها كانت حاضرة بشكلٍ كلّي في حياتي وحياة جيلي؛ جميع هذه الأمور لعبت دوراً كبيراً في تكويني، ولم أسع في رواياتي إلى تفسيرها بقدر ما سعيتُ إلى نقلها إلى مستوى شعري كمادة روائية بامتياز. لا تحمل الأحداث قيمة بذاتها [في الكتابة]، إلا حين نمرّرها بمصفاة الخيال وأحلام اليقظة. الطريقة التي نحلم بها هذه الأحداث ونتخيّلها، وأحياناً نخلطها، تجعلها أكثر إشعاعاً، وتعيد إنتاجها. تُشعرني الكتابة بهذه الطريقة بأنني أكثر اقتراباً من نفسي، من الكتابة من زاوية السيرة الذاتية".
ومرحلة الطفولة هذه، التي تشكّل نواة جميع كتبه، هي التي يقاربها موديانو، بشكلٍ أكثر مباشرةً، في روايته الأخيرة، "كي لا تتيه في الحي"، التي صدرت منذ أيام عن "دار غاليمار" الباريسية. رواية يستخدم الكاتب فيها العناصر والتقنيات الكتابية نفسها التي تحدّد أسلوبه ومناخ رواياته، وتنقلنا إلى عالمٍ سرّي، كئيب، عالمٍ بديل خارق وغامض، تتوسّطه مرآةٌ خفيّة، لكن فاعلة، تعكس أسرارنا الشخصية، وفي الوقت نفسه، انعكاسات عالمٍ ذهني مثير، لا يخلو من الشعرية.