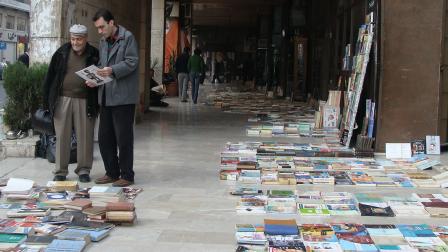آلان رينيه: "ليل وضباب" (فيسبوك)
نقاشُ الواقعيّ والمتخيّل في الفيلم الوثائقي رافق السينما منذ النظريات الجمالية الأولى لغاية اليوم. لكنّ التطوّر التكنولوجي المتسارع أحدَث، في الأعوام الأخيرة، زخمًا غير مسبوق من الصُوَر، وأدّى إلى ظهور أنواع فيلمية ثانوية غير معهودة، بفعل دمقرطة الولوج إلى وسائل التصوير، بالإضافة إلى بروز أدوات جديدة للعرض والاستغلال بفعل تراكمات وسائل التواصل الإجتماعي. هذه العوامل كلّها تدفع إلى إعادة طرح سؤال الواقعي والمتخيّل بشكل ملحّ أكثر من أي وقت مضى.
هنا محاولة لتلمّس سبل تطوّر جدلية التسجيل والمتخيّل في الفيلم الوثائقي، عبر 5 أفلام طبعت تاريخ السينما التوثيقية.
1) "الخروج من مصنع لوميير في ليون": جينات الجدل
البداية مع حكايةٍ لا تخلو من الطرافة، تتعلّق بما حدث أثناء تصوير ما يعتبره معظم المؤرّخين أول فيلم في تاريخ البشرية، أي "الخروج من مصنع لوميير في ليون" (1895) للوي لوميير تصويرًا وإخراجًا. فيه لقطات لمدّة 45 ثانية، تتابع خروج عمال، وغالبيتهم من النساء، من مصنع لوميير في ليون الفرنسية. التقنيات المتوفرة آنذاك لم تكن تسمح بطبع نسخ من الفيلم، من دون تأثّر جودة الشريط الأصلي، فأضطرّ لوميير إلى تصوير 3 نسخ لضمان استغلال الفيلم والاحتفاظ به في ظروف جيدة. ولتصوير النسخة المعروفة اليوم من الفيلم (يمكن مشاهدتها على شبكة "إنترنت")، وهي الثالثة في ترتيب التصوير، طلب لوميير من العمّال القدوم إلى المصنع يوم إجازتهم الأسبوعية، مباشرة بعد مشاركتهم في قدّاس يوم الأحد.
الطرافة كامنةٌ في أن العمال يظهرون على الشاشة وهم يرتدون ملابس أنيقة بدلاً من الزيّ الموحّد للعمل، وفي أن حركاتهم المرحة والنشيطة تعكس مزاجًا رائقًا لا يمتّ بصلة إلى مزاج عمّال أمضوا يومهم وهم يكدّون ويتعبون.
كأنّ سخرية القدر، التي أنتجت هذه المفارقة، تقول إنّ السينما، منذ القبس الأول، وُلدت توثيقية بنَفَسٍ تخيّلي واضح؛ أو إنها ولدت تخيّليّة على أسس تسجيلية، وإنّ التمازج بين التوثيق والمتخيّل وسم جينات الفيلم السينمائي، فلا فائدة تُرجى من إقامة حدود بينهما.
2) "نانوك الشمال": نانوك أو ألاريالاك؟
عام 1922، حقّق روبيرت فلاهيرتي، الملقّب بـ"أب" الفيلم الوثائقي، "نانوك الشمال"، الذي يصوّر الحياة اليومية لعائلة من الإسكيمو في خليج هودسون في أقصى شمال شرق كندا. فيه متابعة للمحاولات الدؤوبة لنانوك لتوفير القوت اليومي لأفراد عائلته في ظلّ طقس بارد للغاية، وجليد ممتد على مدى النظر.
وُجّهت انتقادات عديدة لفلاهيرتي آنذاك، بسبب طلبه من نانوك وأفراد عائلته تمثيل بعض المَشاهد، بدلاً من التصرّف بعفوية، فإذا بنانوك يظهر في مشهد وهو يجرّ فقمةً يُفترض به أن يكون قد اصطادها للتو، بينما يتعلّق الأمر بفقمةٍ تم اقتناؤها نافقة لتصوير المشهد؛ كما أن الزوجة الحقيقية لنانوك ليست تلك التي تظهر على الشاشة. حتّى الاسم الحقيقي للشخصية الرئيسية ليس نانوك بل ألاريالاك.
رغم هذا كلّه، اعتُبر "نانوك الشمال"، ولا يزال يُعتبر لغاية اليوم، قصّة بطولةٍ وعبقرية حقيقية. كما أنه من أوائل الأفلام المحفوظة في "مكتبة الكونغرس الأميركي" باعتباره ذا أهمية قصوى، ثقافيًا وتاريخيًا وجماليًا. ويُعتبر أيضًا من أوائل الأفلام المنتمية إلى نوعٍ هجين، سيُعرف لاحقًا بـ"الوثائقي المتخيّل"، الذي يلتقط الواقع كما هو ويدمج فيه عناصر غير واقعية، لتعزيز "التمثيلية" وإدخال بعض أشكال التعبير الفني.
3) "لاس هورديس أرض بلا خبز": بصمة بونويل
أنتج مَزْجُ شكلٍ تعبيري متفرّد بواقع مُرّ وشديد القسوة أحد أروع الأفلام الوثائقية القصيرة، الذي لا يزال يُثير الدهشة إلى اليوم، بفضل أجوائه المشحونة، وقسوة لقطاته المقرّبة، وتوليفه الجاف: " لاس هورديس أرض بلا خبز" (1932) للوي بونويل.
فيلم مفصلي بالنسبة إلى السؤال المطروح لـ3 أسباب: أولاً، لتميّزه بنَفَسٍ تسجيلي عميق أثناء توثيقه التداعيات الإثنوغرافية والتاريخية والسياسية للجفاف الذي ضرب، في ثلاثينيات القرن الـ20، لاس هورديس، المنطقة الإسبانية المعزولة وسط الجبال، إلى درجة أن سكّانها لم يعرفوا طريقهم إلى الخبز أعوامًا مديدة. ثانيًا، لأن بونويل أحد روّاد تيار السريالية السينمائية، وآخر ما كان يُنتظر منه هو إنجاز فيلم وثائقي يلتقط الواقع كما هو (تسجيل الحقيقة). ثالثًا، لأن هناك حكاية تُروى عن تصوير شاةٍ نفقت بسبب الجوع، بينما هي نفقت إثر سقوطها من أعلى جبل. هذا ما يطرح تساؤلاً حول الأخلاقيات والحدود بين المتخيّل والواقعيّ في السينما الوثائقية.
لكن أهمية "لاس هورديس" تكمن في التجديد الذي حمله أسلوب بونويل ونظرته المسكونة بالسريالية للنوع الوثائقي، لا سيما التناقض الصارخ بين مضمون التعليق المُرافق، الذي يصف بكلمات مبالغ فيها فقر الأهالي ومعاناتهم، والطريقة المقروء بها التعليق، وهي تتّسم ببرودة ولامبالاة. لاحقًا، وصف بونويل فيلمه هذا بـ"باروديا لأفلام الأسفار الوثائقية، التي تبحث عن إدهاش المُشاهدين بالتقاط مَشاهد من أقاصي الصحراء، بينما "الثيمات" حُبلى بفظاعة كانت هناك على مسافة بضع مئاتٍ من الكيلومترات من المدن الإسبانية".
4) "ليل وضباب": طيف الفظاعة
فيلم آخر يمتلك غنى في مقاربته الجمالية، و"ثيمته" مهمّة في التاريخ المعاصر: "ليل وضباب" (1956) لآلان رينيه، حول إبادة الأبرياء في المعتقلات النازية في الحرب العالمية الثانية، والذي تمّت برمجته في مناهج العام الدراسي الثالث في التعليم الإعدادي في فرنسا، لإغناء درس تلك الحرب، نظرًا إلى فضائله البيداغوجية الكبيرة.
ساهم "ليل وضباب" في تغيير التصوّر السائد عن المعتقلات النازية، مُشكّلاً منعطفًا حاسمًا أفضى إلى انعتاق الفيلم الوثائقي من سطوة المرئيّ وانفتاحه على اللامرئي، إذْ تمكّنت الكتابة فيه من جعل ما لا يمكن تخيّله متاحًا للخيال. لا تتسمّ المقاربة بالسريالية هذه المرة، بل بالحدث الذي يسعى الفيلم إليه.
بعد تفكير مضن، كاد أثناءه يتخلّى عن إنجازه، اهتدى آلان رينيه إلى حلٍّ عبقري لالتقاط فظاعة الحدث لا القبض عليه لاستحالة ذلك، يتمثّل بالتأرجح بين صُوَر المعتقلات الوحشية بالألوان الطبيعية بعد 10 أعوام على الجريمة الفظيعة، وصُوَر الأرشيف بالأسود والأبيض؛ وبين أصوات الضحايا، التي تُساهم في الحكي، وشعرية التعليق المُرافق لكاتبه جان كايرول، من دون تناسي الموسيقى التصويرية.
هذا كلّه ضروري لحثّ المُشاهد على نسج تصوّره العقلاني الخاص به إزاء حدث لاعقلاني. أي دفع المُشاهد إلى أن يُصبح شاهدًا بفضل الشعرية السينمائية، وهنا الأساس. فبحكم التباعد الزمني بين فترة الحدث ولحظة إنجاز الوثائقي، لا يمكن لهذا الأخير ادّعاء تسجيل واقعية الحدث، إذْ يصبح السعي إليها منافيًا للصدق والواقعية. لذا، فإنّ ما يمكن فعله كامنٌ في محاولة التقاط طيف الحدث الماثل في الأماكن والشهادات. عناصر الوثائقي التقليدي تصبح عديمة الجدوى، لأن لا واقع هناك أصلاً. وحده المتخيّل المتأصّل في السينما يمكنه فعل ذلك.
في كتابها "أخلاقيات النظرة"، تنقل سيلفي روليه عن الفيلسوف جان ـ لوك نانسي قوله إنّ "الصورة لا تُصلِح فداحة موت الضحايا. هي تفعل أقلّ وأكثر من ذلك في الوقت نفسه: تنسج تصوّر الغياب. الغائبون ليسوا هناك. هم ليسوا في الصورة. لكنهم مُصوَّرون. غيابهم منسوجٌ في حضورنا".
5) "أن تكون وأن تمتلك": قضية مفتوحة
حقّق "أن تكون وأن تمتلك" (2002) لنيكولا فيليبير نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، إذْ شاهده نحو 3 ملايين مُشاهد عند عرضه التجاري في الصالات الفرنسية، وهذا رقم كبير بالنسبة إلى أيّ فيلم، فكيف إذا كان الفيلم وثائقيًا، يُشَاهده في أفضل الأحوال عشرات الآلاف لا اكثر. أدرجته "المؤسّسة البريطانية للفيلم" في قائمتها الخاصّة بـ"50 فيلمًا تجب مشاهدتها قبل بلوغ 14 عامًا".
على امتداد عام كامل، يتابع الفيلم الحياة المدرسية لمدرِّس وتلاميذه، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عامًا، في مدرسة قروية ذات قاعة واحدة في المنطقة الفرنسية أوفيرن. تكمن جاذبيته في قدرته على التقاط مَشَاهد ذات حمولة عاطفية قوية، رغم بساطة أسلوبه، وهذا عائدٌ أساسًا إلى تمكّن المخرج من أدوات التعبير الوثائقي، ومقاربته المُستَلْهَمَة من بيداغوجيا التدريس نفسها.
أمضى نيكولا فيليبير اليوم الأول من التصوير في شرح وظيفة كلّ أداة تقنية على حدة للتلاميذ، وحرص طيلة فترة التصوير (10 أسابيع متفرّقة خلال 18 شهرًا) على تدوين ملاحظات حول تطوّر مستوى كلّ تلميذ، مُسجّلاً النقاط التي يحصل عليها. ولعلّ تشبّعه بأجواء الصفّ وارتياح الأستاذ والتلاميذ إلى أعضاء فريق التصوير أتاحا للفيلم النفاذ إلى روح العلاقة بين المكوّنات كلّها للصف، كأولياء أمور التلاميذ. كما لعبت سلاسة توليف فيليبير (جائزة سيزار) دورًا كبيرًا في خدمة إيقاع الفيلم، الذي كاد يلتصق بإيقاع الحياة الدراسية، مع توالي الأسابيع والفصول والإخفاقات والنجاحات، قبل مشهد الختام الذي لا يُنسى، والذي يودّع فيه الأستاذ التلاميذ واحدًا تلو الآخر، متمنيًا لهم عطلة صيفية سعيدة، ثم يبقى وحيدًا في الصف والدموع تتلألأ في عينيه.
لكن، وكالعادة، هناك حجر يُرمى في بركة هذه الصورة المثالية، في ما يُعرف بقضية "أن تكون وأن تمتلك"، إذْ تقدّم الأستاذ بدعوى أمام المحكمة مطالبًا بـ"حقوق تأليف الدروس التي تظهر في الفيلم"، و"حقّ تأليف الفيلم كلّه"، مُعتبرًا أنه شارك في تأليف الحوار، وأيضًا "حقّه كفنان ممثّل في الفيلم".
هذا كلّه يدخل في مناقشة المتخيّل في الفيلم الوثائقي. أمّا المحكمة، فكانت واضحة من وجهة نظر قانونية، وغير مقنعة تمامًا من المنظور الجمالي: "الدرس الشفهي لا يتواجد ضمن قائمة الأعمال الفكرية المحمية بقوّة القانون، والشخصية في فيلم وثائقي لا يمكن اعتبارها ممثّلاً أو مؤلّفًا، لأن الجزء المرتبط بالخلق في الفيلم الوثائقي يتعلّق حصريًا بالاختيارات التي يقوم بها المخرج وطاقم الإنتاج".
ليت القضية الجمالية محسومة ببساطة منطق المحكمة الفرنسية. فالأمور أعقد من هذا بكثير، وينبغي التّعاطي معها بحذر، وتكييف المقاربة مع كل حالة على حدة. ولعلّ كلمات جان ـ لوي كومولي، أحد أبرز منظّري الفيلم الوثائقي، خير ختام للنقاش الراهن: "سؤال الواقعيّ والمُزوَّر في السينما نقاشٌ مُضنٍ. أنْ تحسم فيه قطعًا يعني أن تُلغي الغموض المتأصّل في التمثّل السينمائي. في النهاية، المُشاهد هو من يرجع له القرار إن كان يريد أن يُصدّق أم لا".