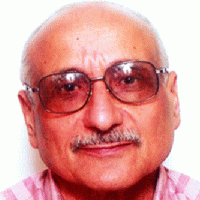13 نوفمبر 2024
إيران حين تلح على اتفاقية الجزائر
صدام حسين وشاه إيران وبومدين عند توقيع اتفاقية الجزائر
كانت ملاحظةً ذكية تلك التي أَثارها الدبلوماسي البريطاني، وير بيري، في اجتماع تقييمي لأوضاع المنطقة العربية، عقد في لندن غداة التوقيع على اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران في مارس/ آذار 1975، وحضره دبلوماسيون وخبراء بريطانيون وفرنسيون "إنها مفارقة أن يعمد رجل العراق القوي (صدام حسين) إلى تقديم كل هذه التنازلات لعدوه اللدود (شاه إيران)، ليوقف دعمه لقادة التمرد الكردي، في وقت يحجم فيه عن تقديم تنازلات أَقل كلفة، وأَكثر منطقية، لمواطنيه الأكراد، لتسوية مشكلةٍ داخليةٍ، طالما أَرقت حكام بغداد".
هذه الملاحظة الذكية ثبتتها وثيقة لوزارة الخارجية البريطانية في 26 مارس/ آذار 1975، لكن الوثيقة لم تشر إلى ردود فعل الحاضرين، ربما لأنهم كانوا مجمعين على أن تلك الخطوة، مهما كانت دوافعها لدى صدام، تفيد في تحجيم دور العراق لاعباً أساسياً في المنطقة، خصوصاً بعد عقده معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي، والتي اعتبرت في نظر الغرب تجاوزاً للخطوط الحمر. لذلك، عمد الغربيون إلى تشجيع الشاه على التصالح مع بغداد، وتقوية خطوط التعاون معها، والسعي إِلى إعادة العراق إلى حظيرة الغرب، وهذا ما أكدته وثيقة أخرى لوزارة الخارجية البريطانية، في العام نفسه.
وكان صدام قد التقط الكرة، وبادر، بحسب ما قاله الملا الراحل مصطفى البرزاني، إِلى إرسال إشارات إِلى واشنطن، عبر عواصم عديدة، بأنه مستعد لتقليص حجم علاقته وروابطه مع موسكو، والتفاهم مع إِيران، في حال تخلي الشاه عن دعم الكرد.
وسنعرف أَنه، في فرصة لاحقة، سيصارح الأميركيين بأنه حين وقع اتفاقية الجزائر كان موضوعاً في زاوية، ومحصوراً بين خيارين، أحلاهما مر. أن يتخلى عن نصف شط العرب، أَو أَن يخسر العراق كله، واختار التخلي عن الشط، مقابل أَن يحافظ على العراق كاملا، بحسب ما قاله هو في أَثناء استقباله السفيرة الأميركية في بغداد، إبريل غلاسبي، قبل أَيام من غزوه الكويت في يوليو تموز 1990، لكنه، في وقت بصم فيه على الاتفاقية بيده، كان يضمر في داخله نية التنصل من الالتزامات التي رتبتها، بعدما يتم احتواء التمرد الكردي، وتقوى شوكة الحكم، ويصبح في وسع العراق أَن يمارس الدور الذي كان يطمح له، معتمداً على بديهيةٍ حاضرةٍ دائماً، تقول إن العراق يمكن أَن يكون مصدر إشعاع وتنوير في المنطقة كلها، باعتباره يمتلك موقعاً جغرافياً فريداً، وله خلفية تاريخية وحضارية عريقة، وفي باطن أرضه ثروات لا حدَّ لها، ويقطع أَرضه نهران كبيران، يمنحانها الخصوبة والغنى. هذا كله، إِضافة إِلى أَن سكانه تشربوا بخبرات الحياة، وعلومها وآدابها وفنونها، ما أَهل بلدهم للعب دور ريادي، في مختلف مراحل التاريخ، إِلا أَن وجهات النظر حول طريقة ممارسة هذا الدور كانت تختلف بين هذا الفصيل وذاك، وحتى بين رجال السلطة في العراق.
وهكذا، أَراد صدام اجتراح مفاجأة. لذلك، جرى ترتيب كل التحضيرات للاتفاقية في كواليس الدبلوماسية السرية التي قادها الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، بدعم غربي غير معلن، ولم يكن أَحدٌ من العراقيين يعلم بها، سوى بعض رجال الحلقة الضيقة المحيطة بصدام، وهذا ما أَكده عضو القيادة، تايه عبد الكريم، والذي رافق صدام إِلى قمة الجزائر، باعتباره وزير النفط، في مقابلةٍ مع القناة البغدادية، في قوله إنه علم بالاتفاقية قبل ساعات من توقيعها!
هذه الملاحظة الذكية ثبتتها وثيقة لوزارة الخارجية البريطانية في 26 مارس/ آذار 1975، لكن الوثيقة لم تشر إلى ردود فعل الحاضرين، ربما لأنهم كانوا مجمعين على أن تلك الخطوة، مهما كانت دوافعها لدى صدام، تفيد في تحجيم دور العراق لاعباً أساسياً في المنطقة، خصوصاً بعد عقده معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي، والتي اعتبرت في نظر الغرب تجاوزاً للخطوط الحمر. لذلك، عمد الغربيون إلى تشجيع الشاه على التصالح مع بغداد، وتقوية خطوط التعاون معها، والسعي إِلى إعادة العراق إلى حظيرة الغرب، وهذا ما أكدته وثيقة أخرى لوزارة الخارجية البريطانية، في العام نفسه.
وكان صدام قد التقط الكرة، وبادر، بحسب ما قاله الملا الراحل مصطفى البرزاني، إِلى إرسال إشارات إِلى واشنطن، عبر عواصم عديدة، بأنه مستعد لتقليص حجم علاقته وروابطه مع موسكو، والتفاهم مع إِيران، في حال تخلي الشاه عن دعم الكرد.
وسنعرف أَنه، في فرصة لاحقة، سيصارح الأميركيين بأنه حين وقع اتفاقية الجزائر كان موضوعاً في زاوية، ومحصوراً بين خيارين، أحلاهما مر. أن يتخلى عن نصف شط العرب، أَو أَن يخسر العراق كله، واختار التخلي عن الشط، مقابل أَن يحافظ على العراق كاملا، بحسب ما قاله هو في أَثناء استقباله السفيرة الأميركية في بغداد، إبريل غلاسبي، قبل أَيام من غزوه الكويت في يوليو تموز 1990، لكنه، في وقت بصم فيه على الاتفاقية بيده، كان يضمر في داخله نية التنصل من الالتزامات التي رتبتها، بعدما يتم احتواء التمرد الكردي، وتقوى شوكة الحكم، ويصبح في وسع العراق أَن يمارس الدور الذي كان يطمح له، معتمداً على بديهيةٍ حاضرةٍ دائماً، تقول إن العراق يمكن أَن يكون مصدر إشعاع وتنوير في المنطقة كلها، باعتباره يمتلك موقعاً جغرافياً فريداً، وله خلفية تاريخية وحضارية عريقة، وفي باطن أرضه ثروات لا حدَّ لها، ويقطع أَرضه نهران كبيران، يمنحانها الخصوبة والغنى. هذا كله، إِضافة إِلى أَن سكانه تشربوا بخبرات الحياة، وعلومها وآدابها وفنونها، ما أَهل بلدهم للعب دور ريادي، في مختلف مراحل التاريخ، إِلا أَن وجهات النظر حول طريقة ممارسة هذا الدور كانت تختلف بين هذا الفصيل وذاك، وحتى بين رجال السلطة في العراق.
وهكذا، أَراد صدام اجتراح مفاجأة. لذلك، جرى ترتيب كل التحضيرات للاتفاقية في كواليس الدبلوماسية السرية التي قادها الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، بدعم غربي غير معلن، ولم يكن أَحدٌ من العراقيين يعلم بها، سوى بعض رجال الحلقة الضيقة المحيطة بصدام، وهذا ما أَكده عضو القيادة، تايه عبد الكريم، والذي رافق صدام إِلى قمة الجزائر، باعتباره وزير النفط، في مقابلةٍ مع القناة البغدادية، في قوله إنه علم بالاتفاقية قبل ساعات من توقيعها!
كانت اتفاقية الجزائر، إذن، صفقةً غامضة، راهن كل من طرفيها، العراقي والإيراني، على الحصول على مكاسب خاصة به منها. وبحسب ما اتضح فيما بعد، كان شاه إيران، وهو لاعب ماهر في السياسات الإقليمية في المنطقة، الرابح الأكبر في هذه الصفقة، فقد حقق أكبر طموحاته في الحصول على نصف شط العرب (خط الثالوك)، والسيطرة على أَرض عراقية، كما حصل على قبول العراق بالتخلي عن معاهدة 1937، والتي وقعها والد الشاه في حينه، واعتبر الشاه ذلك تحقيقاً لأكبر أَحلامه، وهو ما أَفصح عنه بنفسه، في لقائه مع قادة التمرد الكردي الذين استقبلهم الشاه بعد توقيع الاتفاقية. وينقل السياسي العراقي المخضرم، الدكتور محمود عثمان، وكان أحد شهود اللقاء، إن الشاه قال في اللقاء، حرفياً، "حققت لي اتفاقية الجزائر حلماً قديماً، ظل يراودني ثلاثة وأَربعين عاماً، كما حققت لإيران الكثير، وحقق صدام ما لم يحققه نوري السعيد لنا".
ومن مفارقات مثيرةٍ للجدل أَن صدام نفسه اعتبر الاتفاقية ميتة، بعد حين، ومزّقها في جلسةٍ تاريخية للبرلمان العراقي، عقدت إِثر نشوب الحرب مع إيران، ثم عاد وأَعلن تمسكه بها، بعد غزوه الكويت، فيما ظلت طهران بعد قيام (الثورة الإسلامية) على تمسكها بالاتفاقية، وإِصرارها على تنفيذ بنودها كافةً، تنفيذاً كاملاً. وفي أَعقاب احتلال العراق، وصعود القوى السياسية الموالية لها إلى السلطة، حرصت إيران على التأكيد الدائم بضرورة تطبيق العراق الاتفاقية، ببنودها والتزاماتها كافة، بل وسعت للحصول على مكاسب جديدة، لم تتحقق لها من قبل.
وعادت الاتفاقية إِلى الواجهة من جديد، إثر زيارة وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، قبل أَيام، إِلى طهران، ومباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين التي تمخضت عن جملة اتفاقات، حرص العراق على عدم إِعطاء تفاصيل كاملة عنها، والاكتفاء بإِشاراتٍ مقتضبة، لم تزد عن قول الوزير زيباري إِنه حصلت "تفاهمات جديدة، تضمن تسهيل الملاحة البحرية وتحسين الوضع البيئي في شط العرب ... وتفاهمات حول الحقول النفطية الحدودية المشتركة، ... وتفعيل اتفاقية الجزائر". وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أَكثر صراحةً في حديثه عن مكاسب حققتها وتحققها بلاده من خلال تنفيذ الاتفاقية. ولافت أنه جرى استعمال التسمية الإيرانية لشط العرب (أرفند رود)، من دون أَن يواجه ذلك بمعارضة عراقية، وأَيضاً، لم يوضح أَيٌّ من الجانبين، صراحةً، الأسس التي تعتمد عليها عملية ترسيم الحدود بين البلدين، في حين تردّد أن إيران طلبت ضم أراضٍ من محافظة ميسان الغنية بالنفط إليها!
في المآل الأخير، تظل اتفاقية الجزائر سكيناً مغروزة في خاصرة العراق، وتظل إيران الطرف الرابح، فيما خسر العراق، ويخسر، حقوقاً كانت ثابتة له. وإِذا كان صدام حسين متناغماً مع مرحلته، و"شاطرا" في عقد الاتفاقية، فقد آن الأوان للإقرار بأن "شطارته" كلفت العراق وستكلفه الكثير، وغلطة الشاطر بألف.
في المآل الأخير، تظل اتفاقية الجزائر سكيناً مغروزة في خاصرة العراق، وتظل إيران الطرف الرابح، فيما خسر العراق، ويخسر، حقوقاً كانت ثابتة له. وإِذا كان صدام حسين متناغماً مع مرحلته، و"شاطرا" في عقد الاتفاقية، فقد آن الأوان للإقرار بأن "شطارته" كلفت العراق وستكلفه الكثير، وغلطة الشاطر بألف.